آية الرجولة: في تقعيد علم الرجولة بين العهد والنحب والخلود
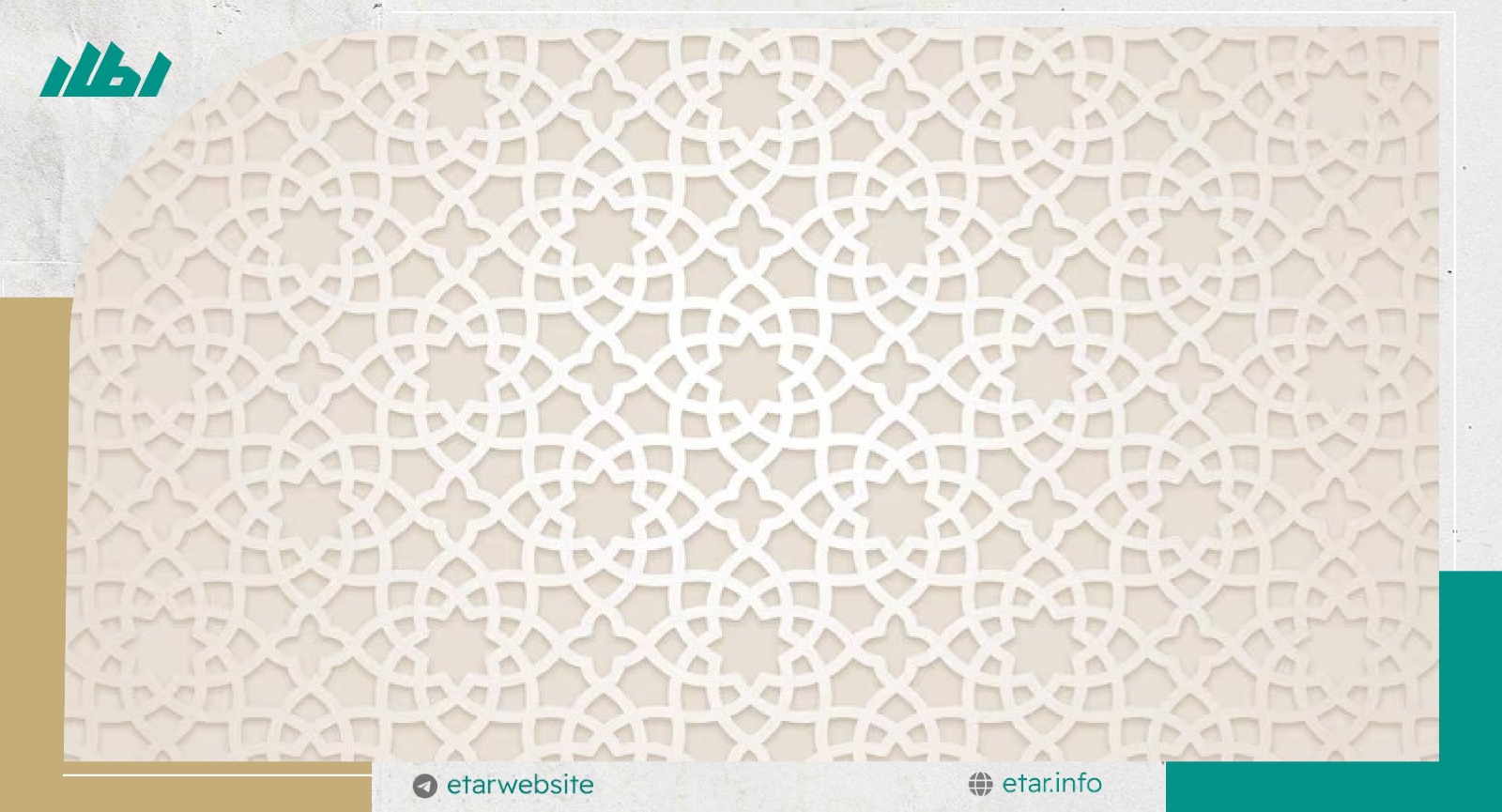
يعد التدبرَ في نص آية الرجولة: ﴿مِّنَ المؤمنين رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ ٱ اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّن قضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا﴾، مدخلًا أساسيًّا لتقعيد علم الرجولة، العلم الذي لحقه الكثير من التقصير حتى غاب عن أذهان معظم المربين؛ فلم نعد قادرين على إعداد أبنائنا إعداد الرجال، ونفينا الرجولة عمّن يستحقها! فما الرجولة؟ وما شروطها؟ وكيف نتصف بها؟ وهل هي مكتسبة أم وراثية؟ يُضاف إلى التساؤلات السابقة تساؤلٌ يثيره حرف الجر "مِن" الذي ورد في الآية الكريمة، والذي يحتمل معنى التبعيض؛ فإن كان يفيد التبعيض، فهل يعني ذلك أن الإيمان في حد ذاته لا يقتضي الرجولة؟
وأخيرًا، ما علة تضارب الأخبار في زمن نزول آية الرجولة وسببه؟ فالمشهور أنها نزلت في غزوة أحد، إلا أن سياق الآية في سورة الأحزاب هو أحداث غزوة الخندق! فهل نزلت هذه الآية يوم أحد ثم وُضِعتْ في سياق آيات غزوة الخندق الواردة في سورة الأحزاب؟ وما دلالات هذا الأمر؟
تعريف الرجولة
وردت لفظة "الرجال" في القرآن الكريم 28 مرة، في حين وردت بصيغة المفرد (رجل) 29 مرة، وجاء المعنى العام لهذه اللفظة في السياق القرآني مقابلًا للأنوثة، وقد ترد أحيانًا في سياقات سلبية، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْإِنسِ﴾ (الجن: 6)، وأحيانًا أخرى في سياقات إيجابية رفيعة، مثل قوله تعالى: ﴿رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (النور: 37). وقد عرفت العربية منذ الجاهلية كلمة "رجل" بمعنى الإنسان المتصف بالشدة والثبات والصبر، وهو معنًى ظلّ حاضرًا في الوجدان العربي حتى اليوم، إذ يُستعمل حتى لوصف مواقف النساء البطولية بعبارة مثل: "موقف رجولي". وهكذا تبلورت دلالة الرجولة باعتبارها رمزًا للثبات والصبر في سياق التاريخ البطولي والملحمي للإسلام، وهو ما يتجلّى بوضوح في آية الرجولة وما تشكّل حولها من تراث تفسيري.
تقدم آية الرجولة تعريفًا لمفهوم الرجولة يمكن أن يصاغ كما يأتي: الرجل كلُّ من صدق عهده على أمر عظيم حتى قضى نحبه؛ وبناءً عليه، يكون شرطا الرجولة هما العهد والصدق، وقضاء النحب إشارة إلى عظمة الأمر المُعاهَد عليه أو الجهة التي عاهدها هذا الرجل، فالنحب في اللغة هو النذر والموت؛ فقضى نحبه "أي: بذل جهده في الوفاء بالعهد من قول العرب: ’نَحَبَ فلان في سَيْره يومه وليله أجمع‘، إذا مدّ فلم ينزل"، وقال البقاعي في تفسيره: "وأصل النحب الاجتهاد في العمل، ومن هنا استُعمِل في النذر لأنه الحامل على ذلك".
أما العلاقة بين النحب والموت، فجمهور المفسرين على أن قضاء النحب يقتضي الموت، وممن خالف في ذلك ابنُ عطية إذ رأى أن النحب ليس من شروطه الموت، مستدلًا بالأحاديث الواردة في وصف الصحابي طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - بأنه من الذين قضوا نحبهم، إذ ورد في الأثر أنَّ طلحةَ ثبتَ مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ أحد حتَّى أُصيبتْ يدُه، فقال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "أوجبَ طلحةُ الجنَّة"، وفي رواية: "أوجبَ طلحةُ"، وقال عليهِ الصَّلاة والسَّلام في رواية جابر رضي الله عنه: "مَن سرَّه أنْ ينظرَ إلى شهيدٍ يمشِي على الأرضِ فلينظُر إلى طلحةَ بنِ عُبـيدِ اللَّهِ"، وفي روايةِ عائشةَ رضي الله عنها: "مَنْ سرَّه أنْ ينظرَ إلى شهيدٍ يمشي على الأرضِ وقد قضَى نحبَه فلينظُر إلى طلحةَ"، فهذه الروايات تصف طلحة بأنه قد قضى نحبه وهو لم يزل حيًّا، ويُعترَض على هذا الاستدلال بالقول إن هذه الروايات كانت من باب الإخبار بالمستقبَل، ويدل على ذلك أن هذه الروايات وصفته رضي الله عنه بالشهيد الذي يمشي على الأرض؛ فمنتهى الرجولة الموت على حال النحب نحو الصدق بالعهد، إلا أنه يوصف بالرجولة كلُّ من كان متلبّسًا بالنحب نحو الصدق بالعهد وإن كان لا يزال حيًا ينتظر التحدي القادم أو التحدي الأخير! وخلاصة القول: إن كل من عاهد ونحب لكي يصدق بعهده فهو رجل، ثم يتفاوت الرجال بمراتب الرجولة على قدر عظم عهدهم وجسامة نحبهم.
الرجولة والوراثة
للرجولة أصل وراثي جيني يجعل بعض بني البشر يتصفون بقدرات عالية على تحمل النحب والمشقات والتحديات الجسام تحملًا إراديًّا وطوعيًّا، فهذا الأمر يتفاوت فيه بنو الإنسان، فيبلغ بعضهم مبلغًا لا يطيقه بل لا يتخيله الكثيرون. والذكورة أقرب إلى الرجولة من الأنوثة، وهذا لا ينفي عن الأنوثة إمكانية الرجولة، إلا أن الذكورة أكثر مظنة للرجولة، كما أن الأصل الجيني الوراثي للرجولة يجعل تحلي بعض الكفرة بها أمرًا مُسلَّمًا به، فنفي الرجولة عن جملة الكفرة واليهود من السذاجات الشعبية التي يتغنى بها بعض العامة لتعزية أنفسهم لما فاتهم أو فوّتوه على أنفسهم! فلقد أخرج الترمذي في سننه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: "اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين"، فالجينات المشتركة بين عمر بن الخطاب وخاله أبو جهل! جعلت كلًّا منهما مُعَدًّا جينيًّا لدور الرجولة وما يطلبه من تحمل للنحب والمشقات والتحديات الجسام.
وقد كانت الوراثة العامل المشترك لبطولة كلٍّ من البراء بن مالك بن النضر، وعمه أنس بن النضر، وعمته الرُّبَيِّع بنت النضر، وابنها حارثة بن سراقة، كما سنوضح لاحقًا. وخلاصة القول: إن بعض بني البشر يهبهم الله صفات جسدية ونفسية تجعلهم أكثر قابلية لتبني العهود والنذور العظيمة ثم المضي في نحب تحمل المشقات من أجل الصدق بما عاهدوا. وللرجولة مراتبُ ودرجاتٌ، فكلما عظم العهد أو النذر عظم النحب وعظمت مرتبة الرجولة.
الرجال لا يموتون: الرجولة بين الخلود الرمزي والخلود الحرفي
الخلود الرمزي والخلود الحرفي مصطلحان نفسيان حديثان، فأما الخلود الرمزي فيُقصَد به الخلود بالذِّكر والسمعة والصيت والشهرة، وأما الخلود الحرفي فهو الخلود في الحياة الآخرة، وهناك دلائل كثيرة على أن مما يصبّر الرجال على تحمل النحب والصدق في العهد سعيهم نحو الخلود بنوعيه الرمزي والحرفي، فالصفات الجسدية والنفسية التي وهبهم إياها اللهُ عز وجل تجعلهم يستصغرون كل غاية دون الخلود، ويتحملون في سبيل الخلود مشاقَّ هائلة، فيصبح الخلود حافزهم لمطاردة الموت! وفي هذا السياق يُفهَم قول أبي بكر لخالد بن الوليد رضي الله عنهما: "اطلبوا الموت توهب لكم الحياة"، فلقد اشتهرت رواياتٌ كثيرة عن رجال لاقوا الموت حفاظًا على سمعتهم، أو اجتنبوا الطريق السهل واختاروا الطريق الشاق حتى لا تُخدَش سمعتهم بعد موتهم.
ورجال الإسلام صارعوا - ولا يزالون يصارعون - الموت الذي يحول بينهم وبين الخلود الحرفي المباشر؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾ (البقرة: 154)، وعن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من أُحد، مرّ على مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو مقتول، فوقف عليه ودعا له، ثم قرأ: ﴿مّنَ المؤمنين رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَـٰهَدُواْ ٱاللَّهَ عَلَيْهِ﴾ الآية، ثم قال: ’أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله فأتوهم وزوروهم، والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردّوا عليه‘".
وكذلك، فإن رجال الكفر لا يموت ذكرهم في الحياة الدنيا، ويحصل لهم خلود السمعة أو الشهرة، إذ روى المفسرون عن رجل من يهود بني قريظة أبى أن يخون رسول الله عندما نقضت بنو قريظة عهدها في غزوة الخندق، فخرج في ليلة حصار النبي لبني قريظة، فمر بحَرَس رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وكان عليه محمد بن مسلمة في تلك الليلة، فلما رآه قال: "من هذا؟" قال: "أنا عمرو بن سُعدَى" - وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ’لا أغدر بمحمد أبدًا‘ - فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: "اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام"، ثم خلى سبيله، فخرج على وجهه حتى أتى باب مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة تلك الليلة، ثم ذهب فلم يدرِ أين توجه من الأرض إلى يومه هذا، فذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم – شأنه، فقال: "ذاك رجل نجاه الله بوفائه".
الانكسار والحصار... مِحَكّ الرجولة
إن المشهور في سبب نزول آية الرجولة هو أفعال البطولة التي أظهرها بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - في يوم أحد، إلا أن سياق الآية في سورة الأحزاب متسق مع أحداث غزوة الخندق، ولعل في هذا الأمر إشارة ذات دلالة مهمة، وهي أن الانكسار والحصار هما ظرفا تجلي الرجولة، إذ قال ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير: "فإن كانت هذه الآية نزلت مع بقية آي السورة بعد غزوة الخندق، فهي تذكير بما حصل من المؤمنين من قبل، وإن كانت نزلت يوم أُحُد فموضعها في هذه السورة إنما هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم [...] وأيَّا مَّا كان وقتُ نزول الآية فإن المراد منها: رجال من المؤمنين ثبتوا في وجه العدو يوم أُحُد وهم: عثمان بن عفان، وأنس بن النضر، وطلحة بن عبيد الله، وحمزة، وسعيد بن زيد، ومصعب بن عمير. فأما أنس بن النضر وحمزة ومصعب بن عمير فقد استُشهدوا يومَ أُحُد، وأما طلحة فقد قُطِعت يده يومئذ وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما بقيتهم فقد قاتلوا ونجوا. وسياق الآية وموقعها يقتضيان أنها نزلت بعد وقعة الخندق. وذكر القرطبي رواية البيهقي عن أبي هريرة: ’أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من أُحُد مرّ على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه فوقف ودعا له ثمّ تلا ﴿مِّنَ المؤمنين رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ ٱاللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ﴾ الآية".
ومن عجائب آية الرجولة أنها لما جُمِع القرآن لم يُعثَر عليها مكتوبة إلا مع رجل واحد، فأي الرجال هو؟! قال البخاري: "حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: لما نسخنا المصحف، فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها، لم أجدها مع أحد إلا مع خُزَيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين ﴿مِّنَ المؤمنين رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَـٰهَدُواْ ٱاللَّهَ عَلَيْهِ﴾"، تفرد بهذا الحديث البخاري دون مسلم، وأخرجه أحمد في مسنده، والترمذي والنسائي في التفسير من سننهما من حديث الزهري. وقال الترمذي: "حسن صحيح".
ولقد شهد خزيمة غزوتَي بدر وأحد وما بعدهما من المشاهد كلها، وكانت راية بني خطمه بيده يوم فتح مكة، وشهد مع علي بن أبي طالب معركتَي الجمل وصفين، فلما قُتِل عمار بن ياسر بصفين، قال خزيمة: "سمعت رسول الله يقول: ’تقتل عمارًا الفئة الباغية‘"، ثم سلّ سيفه وقاتل حتى قضى نحبه.
شرط الرجال السعي للقتال
حاول الماتريدي في تفسيره تأويلات أهل السنة أن يحل الإشكال الناجم عن مفهوم التبعيض الوارد في آية الرجولة، فقال: "قوله تعالى: ﴿مِّنَ المؤمنين﴾ يخرج على وجهين: أحدهما: ﴿مِّنَ المؤمنين﴾ - الذين هم عندكم مؤمنون - ﴿رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ﴾، ورجال لم يصدقوا وهم المنافقون؛ لأن ظاهر هذا الكلام يدل على أن من المؤمنين الذين هم في الظاهر عندهم مؤمنون لم يصدقوا، فأما من كان في الحقيقة مؤمنًا فقد صدق عهده. والثاني: ذِكرُ ﴿مِّنَ المؤمنين﴾؛ خصّ بعض المؤمنين بصدق ما عاهدوا وهم الذين خرجوا لذلك: لم يكن بهم عذر فوفوا ذلك العهد؛ وتخلف بعض من المؤمنين؛ للعذر؛ فلم يتهيأ لهم وفاء ذلك العهد لهم وصدقه ... والله أعلم".
أما ابن عاشور فقد حاول فكَّ هذا الإشكال بطريقة تشبه الوجه الثاني الذي اقترحه الماتريدي، فيقول رحمه الله: "أعقبَ الثناءَ على جميع المؤمنين الخُلَّص على ثباتهم ويقينهم واستعدادهم للقاء العدوّ الكثير يومئذ وعزمهم على بذل أنفسهم ولم يُقدَّر لهم لقاؤه كما يأتي في قوله: ﴿وكفى الله المؤمنين القتال﴾ بالثناء على فريق منهم كانوا وَفَّوْا بما عاهدوا الله عليه وفاءً بالعمل والنية، ليحصل بالثناء عليهم بذلك ثناء على إخوانهم الذين لم يتمكنوا من لقاء العدوّ يومئذ ليعلم أن صدق أولئك يؤذن بصدق هؤلاء لأن المؤمنين يدٌ واحدة".
إلا أنه يُشكِل على هذا التفسير أن الأعذار الصادقة كانت قليلة جدًا في غزوة الخندق، وأن معظم المتعذرين كانوا من المنافقين، وهذا ما جعل الماتريدي يقول بالوجه الأول الذي أشار إليه، ولعل حل هذا الإشكال هو فك التلازم بين الإيمان والرجولة! فليس كل مؤمن رجلًا، ولا كل رجل مؤمنًا، فمن مقتضيات الإيمان الصبر والتصبر على مكاره الجهاد، ولكن ليست من مقتضياته معاهدةُ الله عز وجل على السعي الدائم للقتال حتى لقائه عز وجل، فهذه من مقتضيات الرجولة المؤمنة فقط، وهو في الغالب عمل تطوعي - كما سنرى لاحقًا – غير إلزامي، إلا أن المنافقين تجرؤوا على الله وعاهدوه سبحانه على القتال في العلن من دون أن تنعقد على هذا الأمر سرائر أنفسهم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا﴾، فكان مقصدهم من العهد هو ادعاء الرجولة والفخر، ففضحتهم الظروف القاسية وأظهرت حقيقة معدنهم واعتقادهم.
وخلاصة القول: إن للرجولة مراتب ودرجات، وهي استعداد وراثي جسماني ونفسي يورث الإنسانَ رغبةً شديدة في الخلود تدفعه للنذر العظيم أو العهد الجلل، فينحب نحوه حتى يلقى الخلود، فإن كان مؤمنًا لقي الخلود الحرفي مباشرة، وقد يرتفع ذكره في الدنيا فينال الخلود الرمزي أيضًا، وإن كان لا يؤمن بالله لقي الخلود الرمزي حتى تقوم الساعة فيخلد في العذاب المهين.
الرجولة جَنان لا ضخامة في الأبدان!
لا ترتبط الرجولة بضخامة البنية الجسدية، وهذه المسألة عرفتها العرب منذ عصر الجاهلية، فقد كان ضمرة بن ضمرة من فرسان العرب وشعرائهم في الجاهلية، وكان ضمرة نحيلًا ضئيل الجسد، إلا أن غاراته قد أعيت دولة المناذرة، فأرسلوا الكتائب في طلبه، فأذاق كتائب المناذرة الهزيمة تلو الهزيمة، ما اضطر المنذر - ملك المناذرة - إلى أن يهب ضمرة ألف بعير من هجائن النعمان المشهورة، وطلب إلى ضمرة أن يأتي إلى مجلسه، فلما دخل ضمرة على المنذر، قال المنذر: "تسمع بالمعيدي خير من أن تراه"، يقصد بذلك نحالة ضمرة وضآلة جسده، فقال له ضمرة: "أبيت اللعن، إن القوم ليسوا بجُزُرٍ أي غنم تُجْزَر، وإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا نطق نطق ببيان، وإذا قاتل قاتل بجنان، والرجال لا تكال بالقُفْزان"، فأعجب المنذر بمنطقه.
آل الرجال: الرجولة المؤمنة
تكاد لا تُذكَر آية الرجولة إلا ويذكر أنس بن النضر، فمن أنس بن النضر؟ وما رجولته؟ روى أصحاب المغازي والتفاسير عن الصحابي أنس بن مالك خادم رسول الله - وهو ابن أخي أنس بن النضر، وسُمِّيَ باسمه – أنه قال: "غاب أنس بن النضر عن قتال يوم بدر، فقال: ’غبت عن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم الـمشركين، لئن أشهدنـي الله قتالًا، ليرينّ الله ما أصنع‘، فلـما كان يوم أُحُد، انكشف المسلمون، فقال: ’اللهم إنـي أبرأ إلـيك مما جاء به هؤلاء الـمشركون، وأعتذر إلـيك مما صنع هؤلاء‘، يعني الـمسلمين، فمشى بسيفه، فلقـيه سعد بن معاذ، فقال: ’أي سعد إني لأجد ريح الـجنة دون أُحُد. فقال سعد: ’يا رسول الله فما استطعت أن أصنع ما صنع‘".
والمتأمل لهذه الرواية يتعجب بأن الذي لم يستطع أن يصنع ما صنع أنس بن النضر هو سعد بن معاذ ومرتبته في الرجولة معلومة!، فيكفيه شهادة رسول - الله صلى الله عليه وسلم - له حين سمع أمه تبكيه يوم وفاته، فقال عليه الصلاة والسلام: "كل باكية تكذب إلا باكية سعد بن معاذ". مضى ابن النضر نحو ريح الجنة الذي يجده، وفي طريقه صنع ما لا يستطيعه فحل الأوس وصنديدها، وحينما انتهت معركة يوم أحد وقام الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ليتفقدوا شهداء أحد ويتعرفوهم، وجدوا أنس بن النضر وبه بضعة وثمانون جرحًا بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وقد مَثَّل به المشركون، فلم يعرفه أحد إلا أخته الربيع بنت النضر بعلامة في أصابعه.
هل تبكي الربيع بنت النضر؟
والربيع أخت أنس رضي الله عنهما كانت من نساء الأنصار اللاتي أسلمن قديمًا، وكانت تخرج في الغزوات تداوي الجرحى، وتسقي العطشى، وفي غزوة بدر استشهد ابنها حارثة بن سراقة بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءته وقالت: "يا رسول الله، أخبرني عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء، فقال صلى الله عليه وسلم: ’يَا أُمَّ حَارِثَةَ، إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى‘" فقرت عينها، وسعدت بهذه البشرى.
فالربيع أم الشهيد وأخته، وهي التي اعتادت الخروج في الغزوات ومداواة الجرحى، وهي ذات صفات جسمانية ونفسية خاصة، ويشير إلى ذلك ما رواه أبو داوود في سننه عن أنس بن مالك أنه قال: "لطمت الربيع أخت أنس بن النضر امرأة فكسرت ثَنِيَّتَها[1]! فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب الله القصاص فقال أنس بن النضر: ’والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم‘، قال: ’يا أنس كتاب الله القصاص‘، فرَضُوا بأَرْشٍ أخذوه، فعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: ’إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه‘". نعم، أبرّ الله قسمه، فقبل الخصوم الدية، ولم تُكسَر ثنية أخته الربيع، وهذا الحديث يذكرنا بصحابي آخر أخبر عنه رسول الله أنه إن أقسم على الله لأبره، إذ قال عليه الصلاة والسلام: "كم من ضعيف متضعف ذي طِمْرين[2]، لو أقسم على الله لأبر قسمه منهم البراء بن مالك"، فمن البراء؟ وما علاقته بأنس بن النضر والربيع؟ إنه البراء بن مالك بن النضر، وأنس بن النضر عمّه، والربيع بنت النضر عمته.
الرجال لا تُبدِّل ولا تتبدل
قاتل البراء في كبريات حروب المسلمين، فأبلى فيها بلاءً عظيمًا جعل من اسمه كنيةً يتكنّى بها رجال الإسلام وصناديدُه إلى يوم الدين. وكانت شجاعته تثير خوف عمر بن الخطاب! حتى كتب إلى أمراء الجيوش ينهاهم عن تولية البراء القيادة خشيةً على جنوده من شدّة اندفاعه وبسالته! وكان يمضي من معركة إلى أخرى لا يسأل ربَّه النصر لنفسه قط، حتى إذا اضطربت صفوف المسلمين في موقعة "تُسْتُر"، وكادوا يُهزمون أمام الفُرْس، ألحّ عليه إخوانه، فرفع يديه قائلًا: "أقسمتُ عليك يا ربّ، لَما منحتَنا أكتافَهم، وألحقتني بنبيّك". فاستُجيب له، وقضى نحبه في تلك الوقعة العظيمة. وكانت ثقته بربه راسخةً حتى في مرضه؛ إذ دخل عليه بعضُ إخوانه يعودونه، فلما رأى وجوهَهم قال: "لعلكم تظنون أني أموت على فراشي؟ لا والله، لن يحرمني ربي الشهادة".
هؤلاء هم آل الرجال وهبهم الله استعدادًا جسميًّا ونفسيًّا؛ فسعوا للخلود، وعاهدوا الله وقضوا على النحب حتى صدقوا وصرعوا الموت! وكان دعاؤهم دومًا: "اللهم اكسر بنا شوكتهم، اللهم نكِّس بنا رايتهم، اللهم أذِّل بنا قادتهم، اللهم حطم بنا هيبتهم، اللهم أزل بنا دولتهم، اللهم انفذ بنا قدرك فيهم، بالزوال والتدمير والتتبير يا رب العالمين".
فطوبى لهم...
طوبى لهم...
[1] إحدى أسنانها الأربعة في مُقدِّم الفم.
[2] الطِمْر: الثوب البالي.
