أن نتعلم لنغادر: هل من سبيل "للخروج"؟
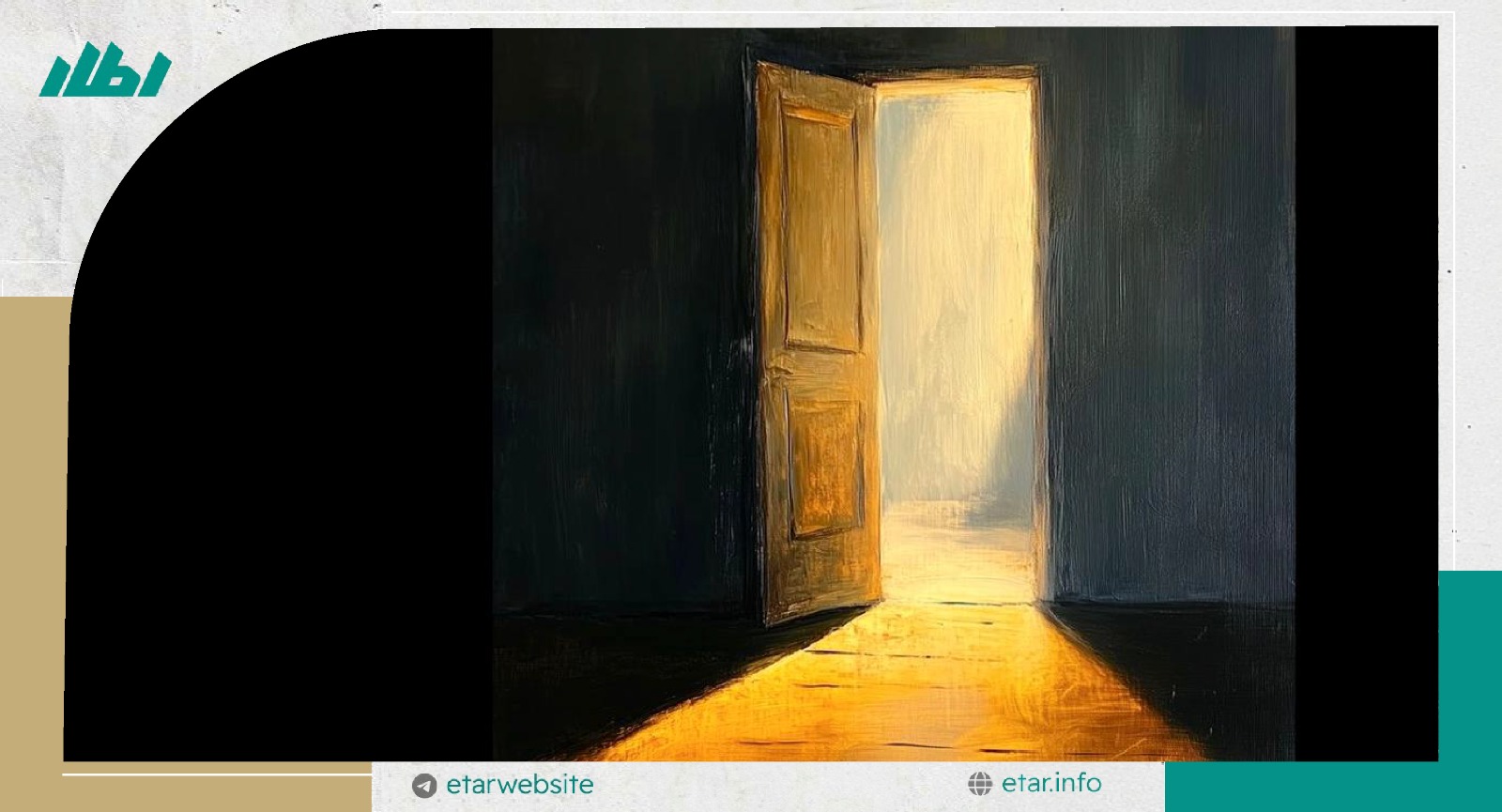
تُحيلنا كلمتا التعلّم، أو التعليم، بالمعنى الأول للمفهوم الذي يتبادر إلى أذهاننا، إلى ضربٍ من الثبات. ذاك الثبات الذي يُعين على الانضباط والالتزام في آن؛ وهو ذاته الذي نحسبهُ اجتماعيًا في شخصِ الفرد المتعلم صفة ملازمة لا مفارقةً له. فهل حقًا يكون الانضباط والثبات، كليهما، الغاية من عملية التعليم، ومنتهى ممارسة التعلّم؟
لنتصوّر معًا سفينة الفضاء التي يجسّدها جان فرانسوا ليوتار، محيلًا إليها في تقديمه كِتابَ المعرفة ومتلازمة ما بعد الحداثة،[1] حيث يصفُ لنا مشهدًا نكون فيه جميعًا قابعين داخل سفينة فضاءٍ مغلقة وصدئة، ليصبح الحلمُ متمثلًا بأن يصيرَ المرءُ رائد فضاء قادرًا على الإقلاع بسفينته الخاصة وقيادتها نحو كوكبٍ بعيد أنى شاء ذلك. وأنّ هذا الرحيل لا يتم إلا عبر سفينة الفضاء للوصول إلى مكانٍ بعيد لا يكون التعليم فيه إلزاميًا بطريقة مماثلة للمؤسسات التي نشأنا داخلها، إذ لن نحتاج قراءة أبيات الشعر وحفظها، والقصص القصيرة وترديدها دونما الوقوع في "الأخطاء"، أي الأخطاء التي تحددها المنظومة التعليمية.
تمثّل هذه الحكاية الرمزية إحالةً إلى مأزق أعمق في علاقتنا مع التعليم والمعرفة ومصادرها، والتي نستقيها بالدرجة الأولى من مؤسساتنا الاجتماعية والدينية والأكاديمية، بدءًا بالأسرة والمدرسة وانتهاءً بالجامعة ومؤسسات العمل. لتعتضد الأزمة عميقًا في سياقنا الاستعماري بالقدرة على التحرر المعرفي الذي يمهد الطريق للانعتاق الفعلي من القيود الخارجية والداخلية المفروضة علينا، والتي تضع شروط المعرفة وتعيد إنتاجها. فماذا يكون "الخروج" إذًا؟
إنّ ممارسة الخروج في ذاتها تنطوي على معانٍ عدة، فهي انشقاقٌ معرفي عن الانضباط والثبات الأكاديمي/ المؤسسي الضيق، وهي أيضًا الشعور بعدم الراحة من الانتماء لمنظومة بعينها أو جهة ما، والأهم أنها قول الحقيقة في وجه "السُلطة" ووضع مسافة دائمة معها. وفي هذا المقام، يصير الخروج إقلاعًا بسفينة الفضاء خاصتنا عن نمط المعرفة المغلق الذي نشأنا داخله، ومساءلةً له من الداخل بإثارة الشك فيه من صميمه، هو التفكير فيما لا يمكن التفكير به ضمن منطق المؤسسة ذاتها. بيدَ أن المسألة الأهم في عملية الخروج هذه، والتي يطرحها ليوتار في نصه الرمزي دونما إجابة واضحة تتجسّد في طبيعة هذا الخروج، أهو فعلًا "إلى الخارج"، أم عميقًا "في الداخل" حيث الأكثر قربًا وجوهرية منا؟
الخروج بوصفه منفىً
أوضحت التعريفات السابقة أن الخروج ليس شكلًا واحدًا ثابتًا للطريق التي ينبغي أن نسلكها في ممارسة التعلّم وتحصيل المعرفة؛ إنما هو أنماط تشترك جُلّها بوقوعها داخل الإدراك والعقل قبل أن تنتقل إلى مستوى الممارسة الفعلية. وإحدى تجلّيات الخروج يمكن فهمها باعتبارها رحيلًا نحو المنفى، مشابهًا للإقلاع بسفينة الفضاء لدى ليوتار. وقد يظهرُ لنا المنفى في الوهلة الأولى بأنه المكان أو الجغرافيا أو الحيز الذي يُطرد إليه الأفراد مبتعدين عن الوطن، بذات الطريقة التي يعايش بها الفلسطينيون حياتهم في المنفى إثر السيطرة الاستعمارية التي أعقبها الاستيطان.
إلّا أن للمنفى في سياقنا هذا بعدًا مجازيًا لا حقيقيًا، فهو يأخذ معنىً مختلفًا قليلًا؛ أي أننا في سعينا للمعرفة الحقيقية لا بد وأن نخرج من المعارف المريحة التي نشأنا عليها وقُدمت لنا بأبهى صورها اليقينية داخل الأسرة والمدرسة ومؤسسات العمل نحو المنفى الذي يبعدنا عن الأخذ بها مسلّمات. لنفكر معًا بكم المواقف التي نواجهها والنقاشات (وربما الجدالات) التي نتعرض لها في الفضاء الاجتماعي، لنلحظ أن ثمة أفرادًا (مقربين أو بعيدين عنا) يسهلُ عليهم الحُكم على المسائل الشائكة واختصار التفكير بها عبر جُمَل صارمة واحدة تلغي أي محاولة للتفكير بل وتجرّمها في أحيانَ كثيرة. إن الإشكال في هذه الممارسات ليسَ فقط محاولتها إلغاء الطرف الآخر، إنما أيضًا بكونها إرساءً لنمط من المعرفة المؤسسية يُجبر الأفراد على الامتثال الدائم لها ويمنعهم من كل نظر مغاير لمنظورها.
يُقدم إدوارد سعيد، في هذا المقام، المنفى باعتباره مكان إقامة الفرد الساعي إلى المعرفة، خاصًّا بذلك المثقف ودوره. وإذ خَبِر سعيد في حياته المنفى حقيقةً ومجازًا، فقد عاش بعيدًا عن موطنه ومسقط رأسه (القدس) إلى جانب اغترابه ونقده الدائمين للمؤسسات والأكاديميا التي نشأ وعمل فيها. وإن أمكن اعتبار المنفى واحدًا من طُرق الخروج من الهيمنة المعرفية التي نحاول دَركها، فما هو موقع المثقف في المنفى تحديدًا؟ يجيب سعيد مبيّنًا أن المنفى يقع في منطقة وسطى، فلا هو توائمٌ كامل مع المكان الجديد ولا تحرر تامّ من القديم.[2] أي أننا حين نحاول تحقيق هذا الوضع والوصول إليه، لا بد أن نظلّ على صلة ما بالتعليم التقليدي (الذي تلقّيناه في المدرسة مثلًا) مع محاولة الخروج منه بالنقد والمساءلة في آن. ويتم هذا دون الخروج الكامل عنه أو المطالبة الراديكالية بهدمه. ولعلّ ما طرحه سعيد حول مؤسسة الاستشراق الأوروبية يجعلنا نعيد النظر في تعريفه هذا واعتباره دعوةً لهدمها، بيدَ أن ذلك لم يتضّح جليًا في نصوصه التي حاولت فهم منطلقاتها الكامنة والظاهرة وليس الوصول إلى تسوية وحل لوجودها أو عدمه.
ومن فهم المنفى لدى سعيد، يمكننا الإحاطة بمعنىً أوّلي يضعنا على عتبة فهم آلية الخروج المعرفي والوصول إليها، والتي تبدأ بمفارقة تنطوي على مغادرة "موطن الراحة" الذي اعتدنا عليه مع الحفاظ على خيط يربطنا به. بيدَ أن الأهم في هذا الحال ألّا نعتاد الراحة داخله، إذ أن هذه الراحة تولّد التسليم والأمان لتتحوّل إلى قيود تحصُرنا داخل المؤسسة: خاضعين لسقف التفكير والممارسة الذي تسمح به داخلها ومن خلالها فقط.
الخروج بالتخريب: أن تبقى بلا إذن
أرسَت كُلٌ من سفينة الفضاء والمنفى عند ليوتار وسعيد، على التوالي، سبيلين يُحيلان للخروج من المؤسسات بكافة أشكالها، بيدَ أن للجامعة بوصفها محطة هامة في التعلّم وإنتاج المعرفة خصوصية مؤسسية في كيفيات الانعتاق والتحرر. وفي الوقت الذي ينبغي على الجامعة أن تشكل فيه فضاءً رحبًا للمعرفة ومكانًا حرًا للتفكير والممارسة، أصبحت الجامعة اليوم باعتبارها مؤسسة أكاديمية جزءًا من المشهد الرأسمالي، تُكلّس المعرفة وتكرّس تحقيلها لتحدّ وتحدد الممارسات داخلها.
إن الخروج من مؤسسة الجامعة لا يكون ضرورة بالمغادرة، بمعناها الحقيقي والمجازي، أو باتخاذ المنفى مكانَ إقامة بديلًا عنها، إنما قد يتمثّل الخروج في هذا الحال بالبقاء داخل المؤسسة. ليكون السؤال المعتاد، ما طبيعة هذا البقاء؟ وهل يقود إلى التماهي مع قوانين المؤسسة وأعرافها؟
يطرحُ كلٌ من فريد موتن وستيفانو هارني، محاولةً للإجابة على معنى البقاء داخل المؤسسة ورفض التماهي معها في آن من خلال مفهومهما الجدلي لما سمّياه "المشاع التحتي" The Undercommons. إذ هو بمعناه الأوّلي شكلٌ من المعرفة الجماعية الهاربة التي تنمو في الزوايا والهوامش (بين الطلاب، في الحوارات، بين المهمّشين، مثالًا) لا في الصفوف الرسمية أو المناهج.[3] إن ما يعنينا في هذا المفهوم هو شكل الخروج الذي يحيلان إليه داخل الجامعة، إذ أن النهج لديهما يتمثّل بالبقاء داخلها، ليس لمحاولة الإصلاح من الداخل أو تحسين أنظمتها مثلًا، بل للسعي لتخريبها الهادئ والتدريجي من الداخل. هذا التخريب الصامت يروم خلق أشكال بديلة للتعلّم والمعرفة والممارسة من داخل جدران المؤسسة ذاتها، فلا تكون محكومة بالثبات والقياس والفحص والمراقبة. لنقف هنا عند فِعل أشبه بالهروب والتسلل داخل المنظومة بلا إذن وترحيب بالدخول، مع إباحة الاستفادة القصوى من موارد الجامعة/ المؤسسة (الساحات، الصفوف، الممرات، مثالًا) لتحقيق المعرفة البديلة والتحرك خلافًا للتيار.
ثمة فارق بين دراسة فلسطين كما تصوّرها المقررات والمناهج الرسمية، وبين قراءتها بالحياة في فضاء المدينة، أو إدراكِها مُعاشة في القُرى، وفهمها من خلال اللغة والتاريخ الشفوي .. أو ربما في الشِعر وملاحم المقاومة اليومية. لتثير هذه البدائل "غير الرسمية" والحقيقية في آن، نمطًا من الخروج (البقاء) الذي يروم التخريب لا الإصلاح، ذاك التشويش الذي يريد خلق البديل ومساءَلة السائد والمهيمن.
يجسّد نمط الخروج هذا من التعلّم الرسمي وقيوده، والذي لا يرتبط بالمغادرة إنما بالبقاء الواعي داخل المؤسسة، حالًا أشبه بالمكوث داخل سفينة الفضاء لدى ليوتار مع افتعال ثقوب صغيرة داخلها تسمح بدخول الهواء وتخلق متنفسًا بديلًا. إلّا أن هذه الثقوب قد لا تضمن إمكان الإقلاع بعيدًا عند ليوتار في قصته الرمزية، وربما تعيقه بذات الطريقة التي تعيق فيها ديمومة وسلامة السفينة. لكن الأهم في استعراضنا هذه المسالِك من الخروج هو تحديد الوجهة، فهل هي حقًا نحو الخارج أم عودةٌ للداخل؟
الخروج إلى "الخارج" أم "الداخل"؟
تشتركُ معاني الخروج في عملية التعلّم، كما حاولنا الوصول إليها عبر ليوتار وسعيد، ومن ثمّ موتن وهارفي، كونها محاولاتٍ للتفكير والممارسة التي تقاوم الهيمنة والتحكم اللذين تفرضهما السُلطة والمؤسسات على السواء. إلّا أن السؤال الأهم على مستوى المعرفة وطبيعتها هو في اتّجاه الخروج، أي وِجهته، إن افترضنا وجودَ معرفة تقليدية (سائدة) وأخرى متفاعلة مع الواقع تحاول التغيير، أو معرفة مؤسسية تُديرها السُلطة وأخرى تحررية تسعى للفكاك من سياسات المؤسسة.
لنتخيل معًا مثالين مختلفين لشخصين خَبِرا الخروج واتّخذا وجهةً له، الأول هو أبو حامد الغزالي (1111-1058) أصوليًا ومتكلّمًا ومتصوفًا إسلاميًا، والثاني ممثلًا ببابلو بيكاسو (1881-1973) الفنان التشكيلي الإسباني. إذ أفنى الغزالي حياته في التعلّم والتعليم والتأليف في علم الكلام وأصول الفقه، إلى جانب اشتغاله الفلسفي المعروف في تهافت الفلاسفة. ليصل بنهاية المطاف إلى التشكيك في يقينية هذه العلوم كما وصفها، ومساءلة الحس والعقل والنقل معًا، ويستقرّ به الحال خارجًا جسديًا (مكانيًا بترحاله) ومعرفيًا نحو المعرفة الصوفية والتجربة الروحية التي تُلامس الحقيقة. وهنا لا بد من ملاحظة المسار المعرفي الذي خاضه الغزالي والذي انخرط عبره بالمعرفة المؤسسية (الفقهية والكلامية) أولًا، والتي أسست توجهه المذهبي رغم تحرر كثيرٍ من كتاباته وآرائه من تصلّب المذهب، ومن ثم خروجهِ نحو التصوّف. إذ أنّ خروجه هذا كان مساءَلة من الداخل وعودة إلى الصميم، أي أنه خروج باتجاه الداخل، باتجاه الجوهر.
أمّا بيكاسو الذي نشأ في أكاديميا الفن الكلاسيكي التقليدي، ليتعلّم أصول الفن الطبيعي والتصويري ويحترفها، فقد وصل لدرجة أصبح يدرك فيها عجز هذه الأساليب الأكاديمية المؤسسية عن الإحاطة بتشظي الحياة اليومية وتصوير أزماتها. وعند هذه اللحظة يقرر بيكاسو الخروج، وأيضًا يكون خروجه جسديًا نحو فرنسا، ومعرفيًا وجماليًا بابتكار نمط جديد من الفن التشكيلي وهو الفن التكعيبي الذي يرى العالم بصريًا من زوايا متعددة ويفكك تناقضاته وتعقيداته.
إنّ الشاهد في هذين المثالين هو طبيعة الخروج المعرفي واتجاهه، فكلاهما تعلّم داخل المؤسسة حتى تمكّن منها، واختار الخروج فيما بعد دون الهدم أو اقتلاع الجذور القديمة. إنما كان النهجُ إرساءَ معرفة بديلة من زوايا نظرٍ جديدة، أمّا الاتجاه فكان نحو الداخل ومن خلاله للوصول إلى "الخارج". وقد نلحظ لدى الغزالي وبيكاسو على السواء، رحيلًا نحو المنفى بمفهوم سعيد، وإقلاعًا بسفينة ليوتار، وممارسة تخريبية أوّلية أبدت ملامحها أثناء تواجدهم داخل حدود المؤسسة. وهذا بالتحديد ما يمكن استخلاصه حول حدود الخروج الممكنة واتجاهاته.
خاتمة
وفي الختام، ليس التفكير بالخروج شعارًا ولا موقفًا لحظيًا إنما هو سلوكٌ معرفي طويل النفس والعهد، يلزمه قدرٌ من المعاركة والصبر. أن نخرج في رحلة التعلّم لا يعني أن نهاجر جسديًا فقط، بل أن نتحوّل فكرًا ومعرفةً وممارسة. وفي الوقت الذي كان ليوتار يحلم فيه من داخل سفينته، وسعيد يكتب من هوامش المؤسسة، وهارني وموتن يدرّسان في جامعة لا يعترفان بها، والغزالي يتسلل من برهان الفقه والمنطق إلى ذوق الصوفية، وبيكاسو يغادر الفن الكلاسيكي لأنه أتقنه حدّ إدراك عجزه. كلّهم خرجوا، بيد أنهم لم يرحلوا تمامًا، فقد حافظوا على الخيط الخفي مع المؤسسة وظلّوا (في مرحلة محددة) يسكنونها لكن بشروطهم لا بشروطها. وهذا هو الخروج كما نحتاجه اليوم: أن لا نغادر العالم، بل أن نعيد تشكيله من الداخل، من الجوهر، ببطء، وبدون إذن.
[1] Michael Peters, Education and the Postmodern Condition, (foreword by Jean-François Lyotard) (Critical Studies in Education and Culture Series, Bergin and Garvey Westport: London, 1997), p4.
[2] إدوارد سعيد، المثقف والسلطة (القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، 2006)، ص 95.
[3] Stefano Harney and Fred Moten, the Undercommons: Fugitive Planning and Black Study (Wivenhoe: Minor Compositions, 2013), p 26-40.
