المقاومة والثورة والتحرير: رهانات السابع من أكتوبر
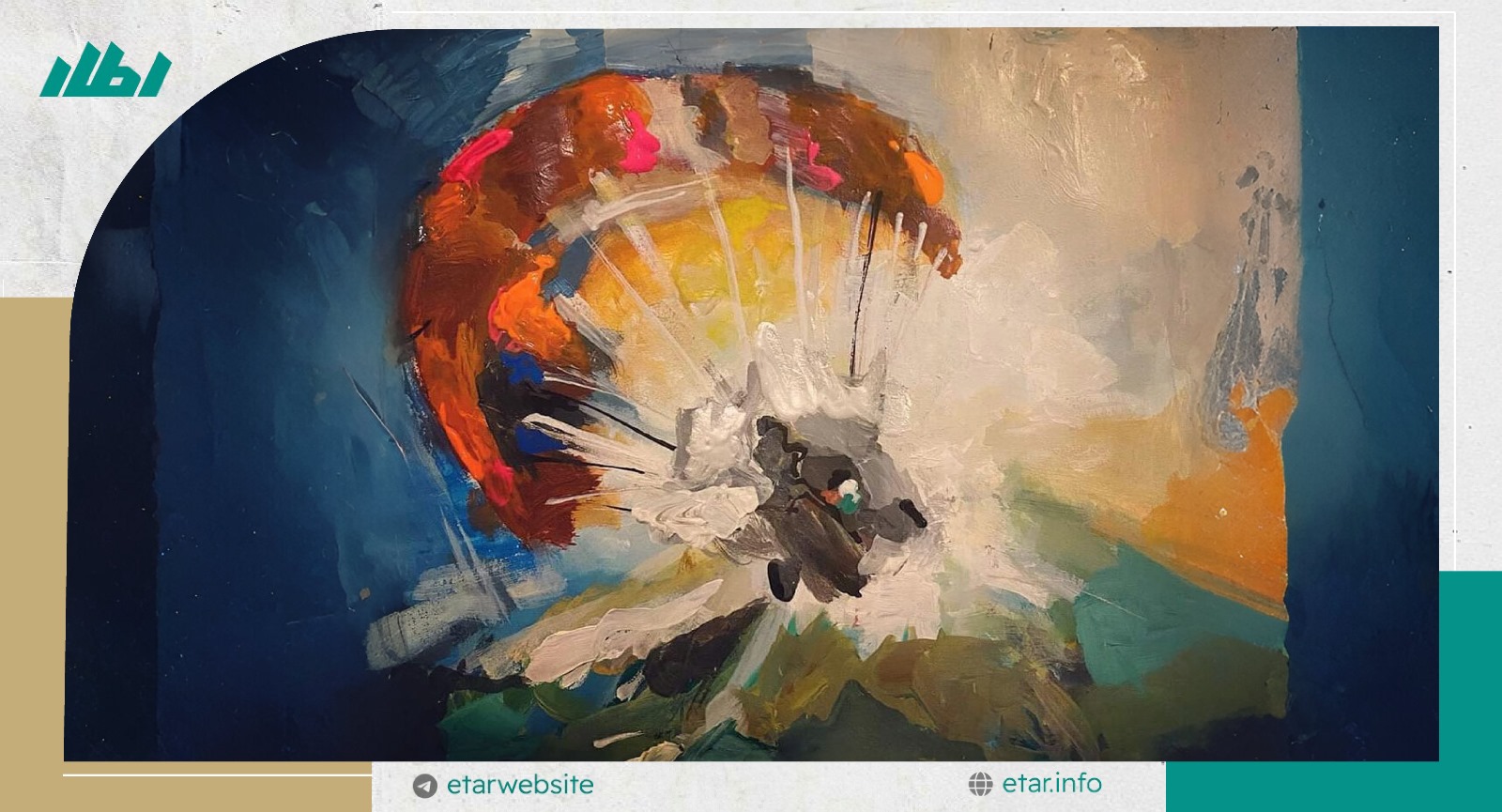
ظهر مفهوم المقاومة لأول مرة بعد هزيمة الإمارات البروتستانتية الألمانية أمام جيش الإمبراطور الكاثوليكي تشارلز الخامس في منتصف القرن السادس عشر. وقتها، اجتمع تسعة قساوسة بروتستانت في ماجدبورج وأصدروا بيانا عقائديًّا دعوا فيه إلى مقاومة الإمبراطور، مقتبسين رسالة القديس بولس إلى أهل رومية التي يدعو فيها إلى عدم مقاومة السلطان باعتباره قدرًا إلهيًّا، ومعلقين بأن هذا الانصياع مشروط بقيام السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فإن صار قائمًا بالمنكر وناهيًّا عن المعروف، توجبت مقاومته. وعلى الرغم من أن البروتستانت قد ظلوا يستعملون المفهوم نفسه في كتاباتهم خلال الحروب الدينية التي استمرت إلى منتصف القرن السابع عشر، إلا أن المفهوم قد غاب على مدى قرون حتى بُعِثَ في فرنسا أثناء الكفاح المسلح ضد الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية.
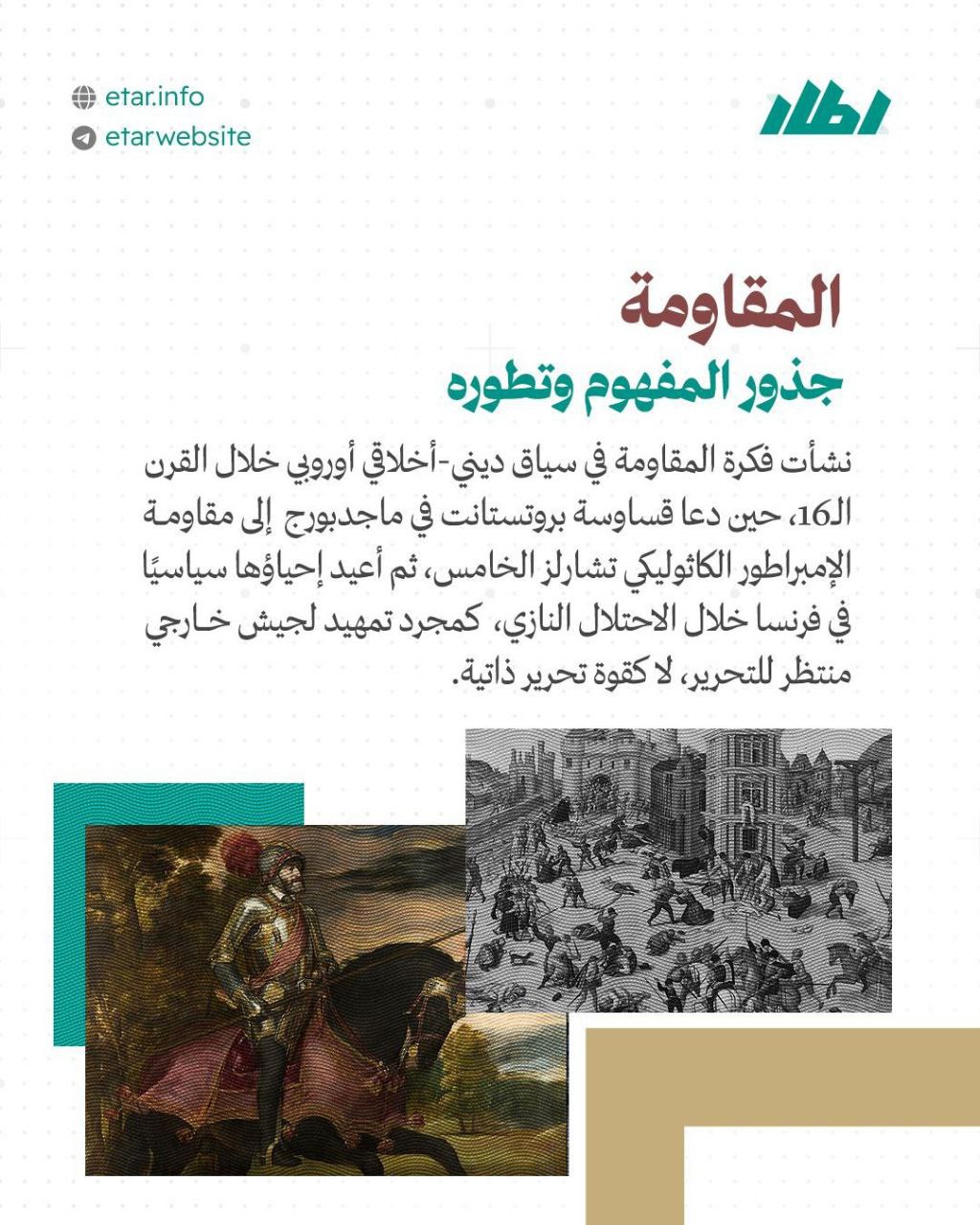
لم يكن ممكنًا للمناضلين الفرنسيين أن يطلقوا على كفاحهم ثورة أو حرب تحرير، فالثورة تعني السعي إلى انتفاضة شعبية واسعة لطرد الاحتلال، وأما حرب التحرير فتعني أن هؤلاء المناضلين يتوقعون أن تمكّنهم قوتهم العسكرية في لحظة ما من تحرير فرنسا، ولم يكن الحال ذلك ولا تلك. استعمل الفرنسيون مفهوم المقاومة وهم يرون أنفسهم مجرد موقع متقدم لجيوش تحرير خارجية ستأتي لنجدتهم وتحرير فرنسا، وما عليهم سوى تمهيد الأجواء لذلك التحرير المنتظر.
عندما قامت الثورة الفلسطينية في 1965، غلب استعمال مقولة الثورة ومقولة التحرير على مقولة المقاومة، فالفدائيون الفلسطينيون في ذلك الوقت تصوروا إمكان تكرار تجربة التحرير الفيتنامية أو الجزائرية في فلسطين، أيْ أن يكون بإمكان جيش تحرير وطني محلي إنجاز مهمة التحرير بنفسه، صحيح أن ذلك سيكون بإسناد خارجي بالتأكيد، لكن قوة التحرير ستبقى محلية، وقد تتخذ شكل ثورة شعبية تستحثها طليعة مقاتلة على غرار نظريات تشي جيفارا وريجيه دوبريه، لكنها لن تكون مقاومة في انتظار جيوش خارجية على كل حال.
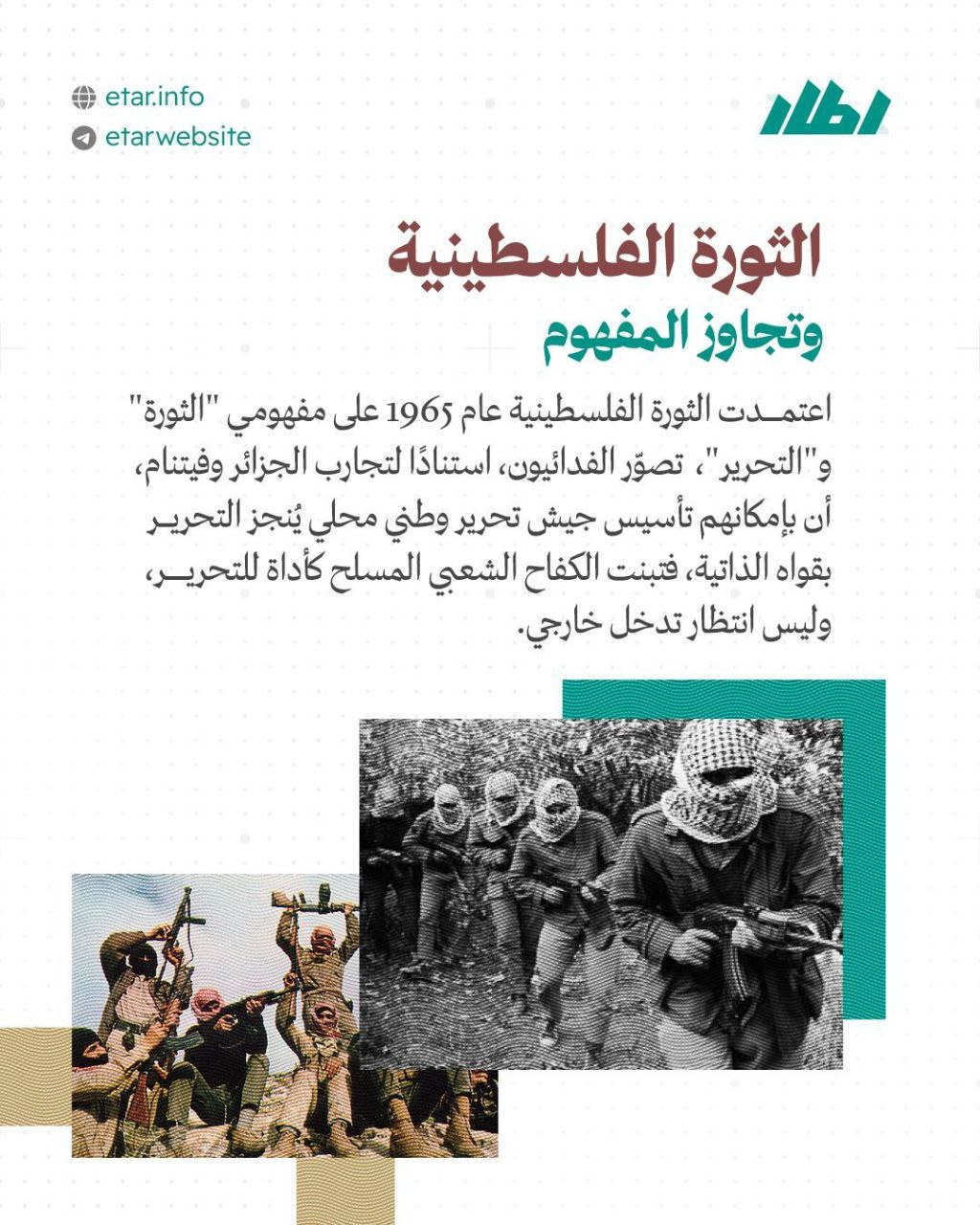
على مدى سنوات الثورة الفلسطينية، طرحت في أوساط الإخوان المسلمين في الأردن حجة الدولة قبل التحرير التي افترضت أن تحرير فلسطين غير ممكن في غياب الدولة الإسلامية القادرة على إنجاز تلك المهمة، وهي الحجة التي أسهمت في الجدل الدائر في صفوفهم حول تأجيل الكفاح المسلح لسنوات. لذلك، عندما قرر الإخوان المسلمون في الأردن وغزة إطلاق عملهم العسكري، أطلقوا على مبادرتهم اسم حركة المقاومة الإسلامية – حماس، وكأن اللاوعي الجمعي للإخوان المسلمين ظل محتفظًا بفكرة أن التحرير لا يمكن أن يتم دون أن تنجزه جيوش دولة قوية تواجه "إسرائيل"، وأن دور المجاهدين الفلسطينيين لن يكون تحرير فلسطين أو استحثاث الثورة الفلسطينية على الاحتلال بما يقود إلى التحرير، أو حتى إلى استنهاض الشعوب العربية على غرار الرؤية اليسارية التي شاعت بين بعض منظري الثورة الفلسطينية، وإنما التمهيد لجيش التحرير الذي تجهزه الدولة القائدة للتحرير.
لقد عبرت مقولة المقاومة إذن عن فكرتين في اللاوعي الجمعي للمقاومين، الأولى هي أن اللحظة هي لحظة انكسار يتخلى فيها الحلفاء أو الأخوة العرب عن دورهم التاريخي تجاه فلسطين بعد سلام مصر المنفرد، وطرح مبادرة السلام العربية التي عنت في الواقع إنهاء النظر إلى التحرير باعتباره مهمة ما على الدول العربية أن تنجزها كما كان الحال بالنسبة للأنظمة العسكرية التي حكمت في الخمسينيات والستينيات. الفكرة الثانية، هي أن المقاومة لا تُحَمِّل نفسها مشروعًا يفوق طاقتها، أي التحرير، وإنما تنظر إلى نفسها كخط مواجهة يحافظ على جذوة الجهاد، حتى تحضر الجيوش العربية لإنجاز التحرير.
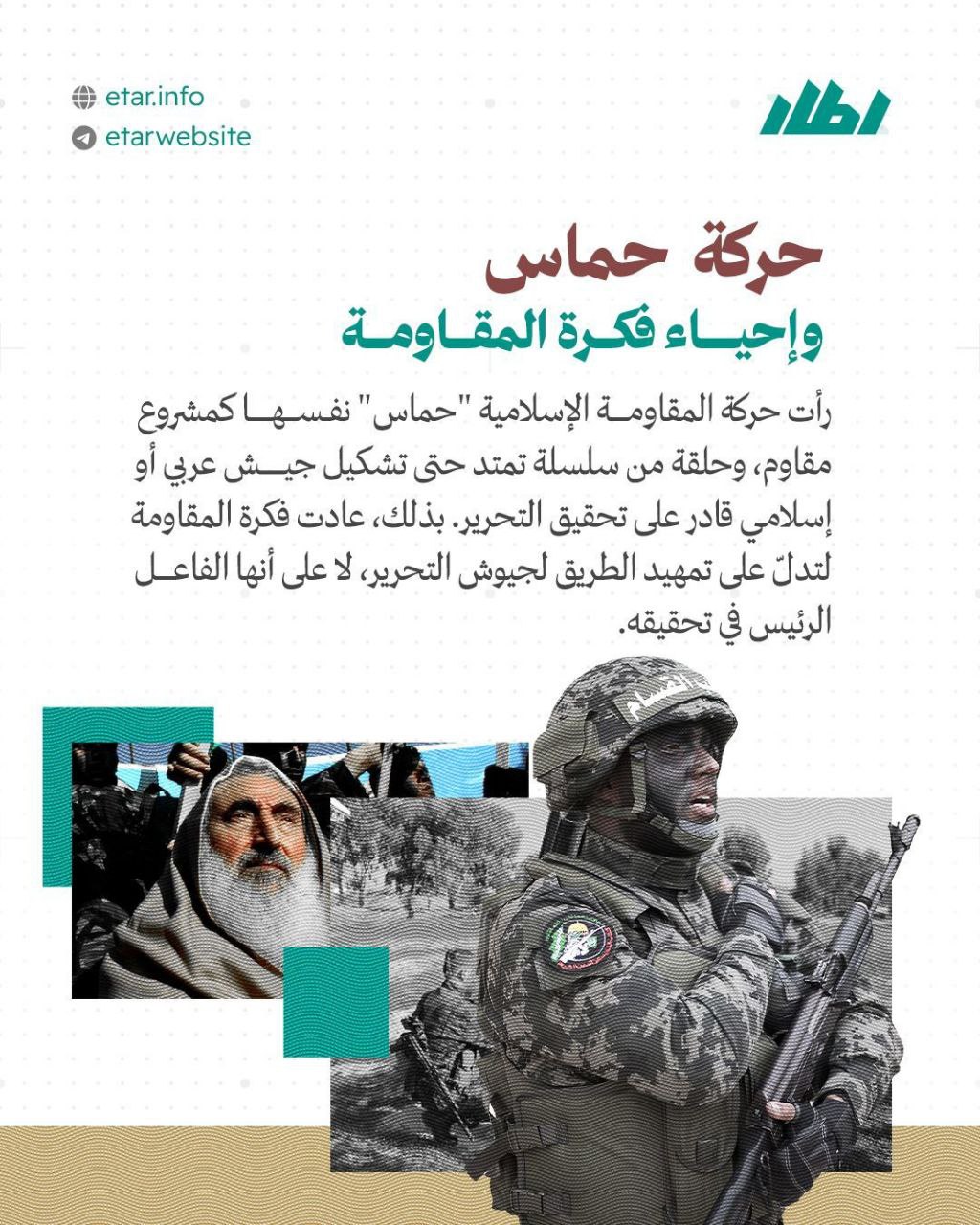
كانت المقاومة لذلك منذ يومها الأول مشروعًا عربيًّا بمعنى ما تمامًا كما الثورة الفلسطينية، وإن تفاوتت الرؤى، فالثورة الفلسطينية تصورت التحرير جزء من عملية تحررية عربية شاملة في مواجهة الإمبريالية، بينما تصورت المقاومة أن التحرير هو مرحلة تلي قيام الدولة العربية الإسلامية/الوطنية التي ترى أن من بين مهامها إنجاز مهمة التحرير.
جاءت الثورات العربية في 2011 لتحيي الأمل المقاوم في أن النجدة العربية في الطريق مهما تأخرت. وعندما اغتالت إسرائيل أحمد الجعبري، قائد أركان كتائب القسام، استجابت حماس سريعًا إلى المطلب المصري بالتهدئة، انطلاقًا من أن على المقاومة إفساح المجال لمصر الجديدة لإعداد جيش التحرير الذي تنتظره المقاومة. وعندما أخذ هذا الوهم يتبدد بعد 2013، كان من الواضح أن المقاومة تدخل مرحلة من الأزمة المشروعية خلال السنوات التالية، وربما كانت معركة 2014 هي محاولة مبكرة لاستدراك تلك الأزمة، عبر استخدام المقاومة قوتها العسكرية في رفع الحصار عن قطاع غزة، لكن السنوات التالية كانت سنوات من البحث عن رؤية جديدة لمشروع المقاومة بعد أن صار واضحًا أن جودو التحرير المصري أو العربي سيتأخر طويلاً، هذا إن أتى أصلاً.
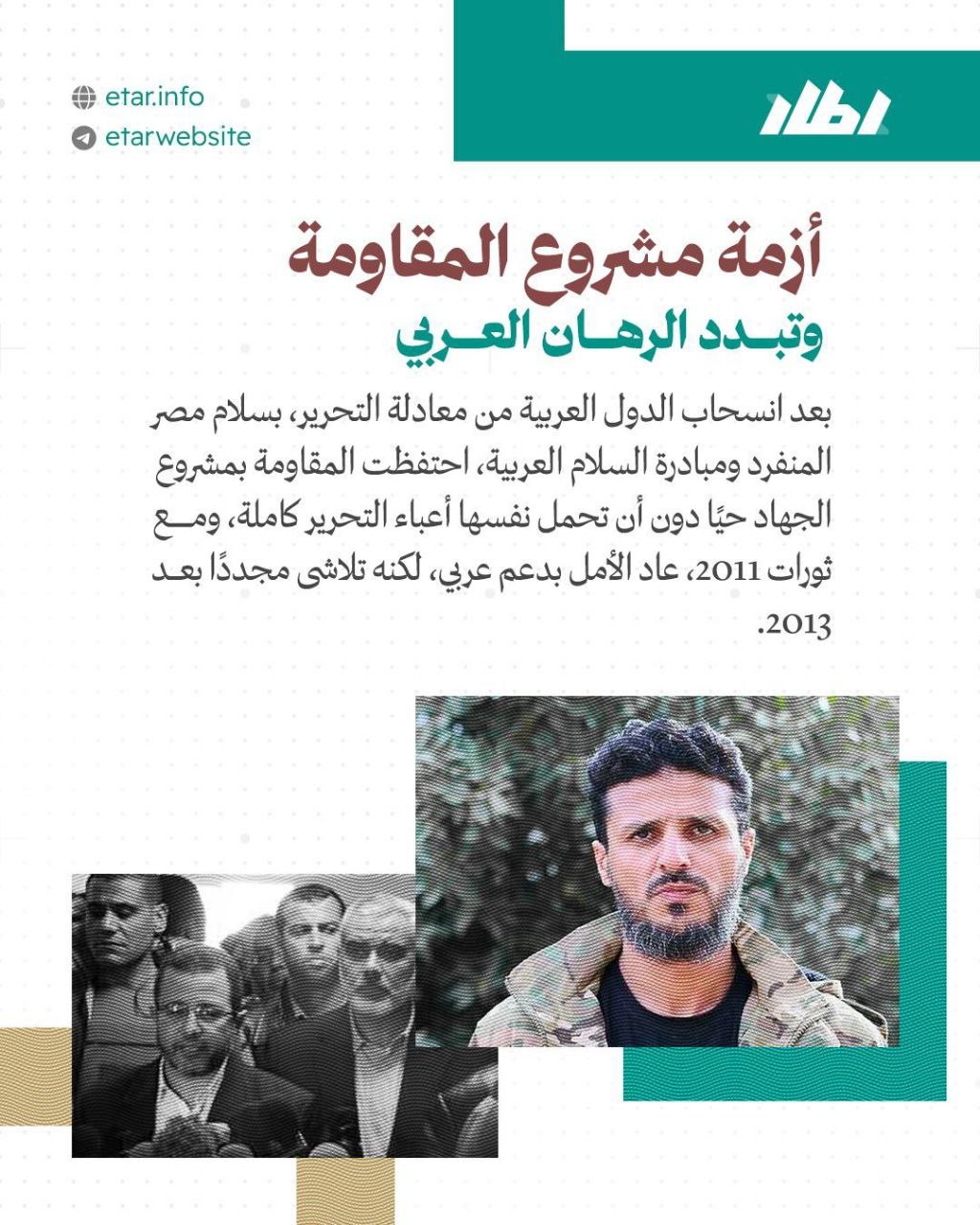
بمعنى ما، وبوعي التجريد الذي يعتمده الطرح الذي أقدمه هنا، أي تجريد السرد من عشرات العوامل السياقية المباشرة التي لا شك أنها هي التي حددت خيارات الفاعلين عبر تلك المسيرة، جاء السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ردًّا على تلك الأزمة وليشكل تحولا في مشروع المقاومة. أسهمت اتفاقيات أبراهام ومشروع التطبيع السعودي الإسرائيلي المطروح وانهيار النظامين العراقي والسوري وإمعان مصر في مسار العزلة، في تفكيك الخيال التاريخي الذي بُنِيَ عليه مشروع المقاومة، أي المقاومة كموقع متقدم يمهد لجيوش التحرير التي تعدها الدولة العربية. وكان على المقاومة في غزة إذن أن تصمم مبادرتها الجديدة وفقًا لتلك المعطيات.
لقد جرى تصميم السابع من أكتوبر على أمل أن يفتح المسارات الثلاثة: الثورة والتحرير والمقاومة. لقد راهن صانعو السابع من أكتوبر على أن يقود الإنجاز العسكري الكبير لعمليتهم التاريخية إلى استنهاض الشعوب العربية، وإذا خَلَّصتَ خطاب محمد الضيف الذي أطّر المعركة في بدايتها من ديباجته الإسلامية، فيمكنك أن تركّب عليه ديباجات يسارية تعود إلى الستينيات، عندما كان اليسار الفلسطيني في الأردن يحلم باستحثاث ثورة عربية تمتد إلى فلسطين وتحررها. ويبدو أن هذا الرهان قد خاب بالتأكيد مع ضعف الاستجابة الشعبية العربية لذلك الاستنهاض، إلا أن السابع من أكتوبر سيظل ينظر إليه باعتباره محفّزًا محتملاً لانتفاضة عربية جديدة قد تتطور على مدى العقد القادم.
على كل حال، كان المسار الثاني المحتمل هو أن تتحول المقاومة الفلسطينية إلى جيش تحرير، وعلى الرغم من أن المعطيات الموضوعية كانت تستبعد ذلك، إلا أن إمكانية انخراط حزب الله في المعركة بكامل إمكاناته وبمشروع تحرير أصبع الجليل الذي كان السيد حسن نصر الله قد لوّح به سابقًا، وإمكانية أن يتحول محور المقاومة من فكرة إلى تحالف فعلي بفعل السابع من أكتوبر نفسه، لا شك أنها داعبت خيال من قاموا بالسابع من أكتوبر (هل نقول إنها داعبت خيال نصر الله معهم؟ لم تتوفر بعد المعلومات الكافية للإجابة عن هذا السؤال)، وقادتهم إلى تصور أن يكون السابع من أكتوبر معركة أولى على طريق التحرير تليه معارك في الجليل والجولان وإيلات. كان هذا المسار هو الأكثر تخييبًا بلا شك، إذ تأكد أن الحزب لم يكن بصدد تلك المغامرة الكبرى، ولم تمهله "إسرائيل" مزيدًا من الوقت للتفكير فيها بعد أن باغتته خلال شهرين بحملة تكسير عظم لم يتصورها أشد متشائميه.

المسار الثالث الذي ربما يبدو اليوم أكثر واقعية، هو استعادة مشروع المقاومة نفسه. منذ الستينيات، عملت الانعزالية العربية على تحويل مشروع المقاومة من محفز لتفجير التناقض بين العرب و"إسرائيل"، إلى حائل أو مثبط بتغليفه كخيار فردي فلسطيني في مواجهة "إسرائيل"، يمكن دعمه ويمكن التحالف مع "إسرائيل" للقضاء عليه، لكنه يبقى مشكلة إسرائيلية داخلية، تستخدمها الانعزالية العربية بحسب مصالحها وتقلباتها المحورية. كان من بين رهانات السابع من أكتوبر الكامنة أن يقود "إسرائيل" إلى حرب مستمرة في الشرق الأوسط يتطاير شررها على عباءات مشايخ الخليج وبزات المصريين القابعين في قمقم كامب ديفيد منذ نصف قرن بالتمام والكمال.
اعتمد هذا الرهان على تناقض كامن في "إسرائيل" نفسها، فتعقلها يعني أن يصير السابع من أكتوبر قابلاً للتكرار بما يعني نهاية مشروع "إسرائيل" بكل معانيه: نهاية "إسرائيل" التي تهاجم ولا تدافع، وتردع ولا تهدد، تحمي اليهود وليس أن تعرضهم للخطر، أما اندفاعها وتعجرفها فيعني إنهاء العلاقة غير الشرعية بين العرب و"إسرائيل" التي بدأوها منذ نصف قرن على الأقل. لم يعد ذلك ممكنًا اليوم، فالسعودية العظمى ومصر الأمن والأمان لا يتبديان اليوم إلا كضلالات كبرى لمرضى الميجالومانيا في المملكة، ومحترفي الكلبية (cynicism) السياسية في الجمهورية، إذ يجلس زعيما الولايات المتحدة و"إسرائيل" ليقسّما أرضهما على الهواء مباشرة (على عبد الرحمن الراشد وطارق حميد وأمثالهما أن يحكيا لنا عن أي دولة عظمى في التاريخ تحدث رئيس دولة بحجم "إسرائيل" عن إمكانية تقسيم أراضيها). جاء السابع من أكتوبر ليقول للعرب كفى سفاحًا، لم يعد من الممكن القفز فوق جثة فلسطين للنوم في الحضن الإسرائيلي.
ليس من الضروري أن ينجح هذا الرهان أيضًا، ولو كان مضمونًا لما كان رهانًا، غير أن الحياة بأزماتها لا يمكن مواجهتها إلا بالرهانات (الإيمان نفسه يمكن أن يكون في جوهره رهانًا بحسب الفيلسوف الفرنسي باسكال). ربما تخفق رهانات السابع من أكتوبر، ربما تنجح، لكن الأكيد أنها رهانات وُلِدت من رحم أزمة وظرف لم يخترهما صانعو السابع من أكتوبر ولم يصنعاهما، وإذا كان من مسئولية تاريخية فيجب أن تتوزع بالعدل على من جعلوا السابع من أكتوبر رهانًا وحيدًا أمام الفلسطيني.
