المقاوم المفقود... حزنٌ مكتوم والبحث "لائحة اتهام"

في الحرب، الكل يبكي، وما أكثر أسباب البكاء، وأصعب الدموع ما ينهمر على أحبابنا من البشر، يبكي الفاقدون شهداءهم ويدعون لهم بالرحمة، ويبكي ذوو الجريح مصابهم ويدعون له بالشفاء، ويبكي أهل الأسير غائبهم ويدعون له بالفرج.
ولكن ماذا يبكي أهل المفقود؟ وماذا يقولون عندما يرفعوا أكف الدعاء؟ يا لصعوبة ابتلائهم، يأكلهم الشوق والحزن من جهة، ويقتات عليهم الأمل من جهة أخرى، هل يستسلموا لفكرة الفقد فلا ينتظروا عودة ابنهم، أم يتركوا أنفسهم للتفاؤل فيرهقهم الانتظار والتفكير في ما يحدث مع الغائب في مكانه المجهول. وحين يكون المفقود مقاومًا، فهذا ألمٌ فوق ألم، لخصوصية الأمر وما يرتبط به من مسائل أمنية تقيّد الأهل في كل كلمة وفي كل خطوة.
الكثير من عائلات المقاومين المفقودين تضطر للتكتم على فقده خوفًا من انتقام الاحتلال الذي يستهدف عائلات المقاومين، يقتلهم ويدمر بيوتهم ويعذّب من يقع منهم بقبضته أسيرًا، ليس هذا فقط، فماذا لو كان المفقود حيّا في سجون الاحتلال؟ حينها سيكون بالبوح بما يخصه أدلة جاهزة على "تهمة" يحاكمه عليها الاحتلال، يستخدم الأهل "كذبات" مثل السفر، أو الاستشهاد في قصف منزل مجاور، للتغطية على أمر الفقد، يفعلون ذلك رغم ثقتهم أن الحقيقة تنتشر للغاية في مجتمعنا الصغير والمتداخل.
بذلك، يفقد الأهل حقهم في التعبير عن حزنهم، وتلقي المواساة، أو حتى البكاء على الملأ، يحسبون كل كلمة تخرج من أفواههم أمام الناس، لا تعلّق الأم صورة ابنها على حائط غرفة الضيوف، ولا ينشر الابن صورة أبيه على "حائط فيس بوك"، ولا ترتدي الزوجة قلادة تحمل صورة شريك عمرها، ولا تبكي الابنة ظهرها المكسور أمام أحد.
الأمر أكبر من المشاعر، فالبحث عن الابن بطريقة رسمية وعبر مؤسسات ذات صلة شبه مستحيل، يمتنع الأهل حتى لا يقدموا معلومات عنه لأي جهة، يوصدوا كل الأبواب، ويتبع ذلك عدم القدرة على إتمام إجراءات مهمة مثل استخراج شهادات وفاة لمن تأكد الأهل من استشهادهم ولكن لم يجدوا جثثهم.
عدة مصادر أكّدت لنا أن البحث عن المقاومين المفقودين يتم بجهود فردية من عوائلهم، ويسهل عليهم المهمة أن كثيرًا منهم ينتمون لأسرٍ منخرطة في المقاومة، ما يجعلهم قادرين على التواصل مع المحيطين بابنهم المفقود.
إحدى العائلات، وصل بها الحال للاستعانة بالكلاب للبحث عن ابنها بعدما حصلت على معلومات تفيد باستشهاده ودفنه في مكان محدد، ومن حسن الحظ أنه كان مدفونًا قرب أنقاض بيت قريب له، فتمكن الأهل من انتشال الجثة.
ما يؤكد أهمية تكتم الأهل، أن الاحتلال يبحث عن المعلومات المتعلقة بأبنائهم، فقد كثرت الإعلانات المشبوهة التي يبدو واضحًا أنها تابعة له، تظهر للغزيين بطرق مختلفة عبر الإنترنت، مثل فيس بوك، ومساحات الإعلانات داخل الألعاب على الهواتف المحمولة، وتدعي أنها لجهات تساعد في البحث عن المفقودين، وبالدخول للروابط المنشورة، يطلب الموقع تسجيل بيانات عن المفقود.
إلا الاعتقال...
 رغم كل ألم الفقد، قلّما تجد أهل مقاوم مفقود يتمنون العثور على ابنهم في السجن، لبشاعة ما يتعرض له الأسرى، فمنذ اندلاع الحرب الحالية وما رافقها من زيادة كبيرة في انتهاكات الاحتلال في السجون، يُفضل أغلب الأهالي استشهاد أبنائهم على اعتقالهم، وهذا بخلاف ما كان سابقًا.
رغم كل ألم الفقد، قلّما تجد أهل مقاوم مفقود يتمنون العثور على ابنهم في السجن، لبشاعة ما يتعرض له الأسرى، فمنذ اندلاع الحرب الحالية وما رافقها من زيادة كبيرة في انتهاكات الاحتلال في السجون، يُفضل أغلب الأهالي استشهاد أبنائهم على اعتقالهم، وهذا بخلاف ما كان سابقًا.
يدّعي الاحتلال أنه اعتقل العشرات من عناصر وحدة "النُخبة" في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ممن شاركوا في الهجوم الأول من طوفان الأقصى في مناطق غلاف غزة.
لم يكشف الاحتلال عن مكان هؤلاء الأسرى، ولا عددهم، ولا ظروف احتجازهم، لكن وزير الأمن القومي السابق في حكومة العدو "إيتمار بن غفير" كان قد قال عبر "تليغرام" إنه أوعز إلى مفوضة السجون "كيتي بيري" بإعادة فتح سجن تحت الأرض لم يُستخدم منذ سنوات لمعتقلي القسام، "فهم لا يستحقون ومضة ضوء، بينما مُحتجزونا يجلسون في أنفاق الجحيم"، على حد وصفه.
وحتى خارج إطار التصريحات الرسمية، فالمعلومات عن المقاومين الأسرى معدومة تقريبًا، إلا من تسريبات قليلة نشرها إعلام الاحتلال، من ذلك تقرير بثّته القناة 13 عن أسرى قالت إنهم من عناصر "النُخبة"، اعتقلوا أثناء مشاركتهم في هجوم السابع من أكتوبر 2023.
التقرير الذي يُظهر كلابًا بوليسية ترافق السجانين أثناء تفقدهم الأسرى، يوضح أنهم يتكدسون في زنازين صغيرة، ويجلسون أرضًا ويُجبرون على حني رؤوسهم، ويحصلون على كميات قليلة جدًا من الطعام، ويرتجفون من شدة البرد، ويتعمد السجانون إزعاجهم بتشغيل أغاني باللغة العبرية بصوتٍ عال، يوميًا، منها أغنية "شعب إسرائيل حي".
الاعتقال بهذا الشكل يُعد إخفاءً قسريًا، يخالف القانون الدولي، الذي لم يتوقف الاحتلال عن انتهاكه دون مساءلة من الجهات ذات العلاقة.
منذ 1948، وحتى يومنا هذا، فُقدت آثار الكثير من الفلسطينيين في سياق الصراع مع الاحتلال، سواء في النكبة أو النكسة أو في الشتات كما في لبنان، أو في السجون، ولكن في السنوات الأخيرة اختفى تقريبا وصف "مفقود"، إلى أن عاد للظهور بقوة منذ السابع من أكتوبر، ذلك اليوم خرج كثيرون ولم يعودوا، سواء من المجاهدين المشاركين في العبور نحو الأراضي المحتلة أو من لحق بهم من المواطنين.
وتلا ذلك آلاف حالات الفقد داخل حدود القطاع بعدة أشكال، منها الاعتقال مع الإخفاء القسري، والاستشهاد في أماكن خطرة لا يمكن الوصول لها، وتفتت الأجساد لأشلاء يستحيل تحديد هويات أصحابها بسبب أنواع الأسلحة المُستخدمة، وكذلك بقاء الشهداء تحت الأنقاض لعدم وجود معدات ثقيلة تساعد في رفع الركام وانتشال الجثث، وغير ذلك.
زاد عدد المفقودين في الحرب عن 11200 مفقودًا، جلّهم لا علاقة له بالمقاومة، وهؤلاء يتحدث عنهم ذووهم بلا قيود، يخبرون معارفهم بما تعرضوا له، ويسلكون كل السبل المُتاحة للبحث عنهم، أما المفقودين من المقاومين فالخوف من الحديث عنهم يحيط ملفّهم من كل جانب، لا من أهلهم فقط، بل حتى بعض المؤسسات المعنية، وجهاتٌ حكومية، لذا فإننا نتحدث عنهم في هذا التقرير...
بين الشك واليقين
 لم يكن من نصيب "أ" المشاركة في الهجوم الأول من الطوفان، فأكله الحزن، وزاد حزنه قرار بتأجيل مشاركته في الميدان إلى حين الوقت المناسب، ظلّ يلّح على قائده، يرجوه السماح له بالانضمام للمجاهدين، حتى جاء اليوم المُنتظر...
لم يكن من نصيب "أ" المشاركة في الهجوم الأول من الطوفان، فأكله الحزن، وزاد حزنه قرار بتأجيل مشاركته في الميدان إلى حين الوقت المناسب، ظلّ يلّح على قائده، يرجوه السماح له بالانضمام للمجاهدين، حتى جاء اليوم المُنتظر...
جهّزت أمه حقيبته، وضعت فيها الملابس وعلاجه الخاص، عدّلت ياقة قميصه، وعطّرته، ولما استعد للخروج، طرأ طارئٌ أجّل ذهابه، وفي اليوم التالي فضّل مغادرة البيت في صمت، شعرت به خالته، سألته فصارحها، وكانت الوحيدة المحظوظة بعناق أخير.
بعد أيام، اشتد خوف الأم، وللتخفيف عنها تواصل شقيقها مع مسؤول ابنها، أخبره أن الجميع بخير، وأكّد له: "إن طلبته أمه، سيكون عندها الآن"، لكن أمًّا وهبت قطعة منها في سبيل الله، زرعت فكرة الجهاد في عقل ابنها وقلبه، ربّته 25 عامًا وهي ترى نهاية الطريق، ماذا عساها تقول؟ أجابت بثبات: "أنا مش أنانية، ابني مش أغلى من اللي راحوا".
كان هذا الاطمئنان الأول والأخير، انقطع الاتصال، لا أخبار جديدة، ولا مصدر موثوق للمعلومات، أنهك القلق أهله، خاصة أنه مريض سكري، في حقيبته إنسولين يكفي لأسبوع وواحد فقط. وكان قرر منذ اندلاع الحرب أن يصوم يوميًا لتخفيف جرعات الإنسولين، فصام معه بعض أفراد، حتى بعد خروجه إلى الميدان، وبعد انقطاع أخباره، يفطرون بدموع العيون، وألسنتهم تلهج بالدعاء ليكون بخير.
هذا يخبرهم أنه شهيد، وذاك يقول أسير، وآخر يؤكد أنه مصاب في مستشفى في محافظة أخرى، مع الوقت، ظهر أشخاص يتحدثون برواية واحدة: "واجهت المجموعة أول قوة للاحتلال دخلت المنطقة، فجّر الشباب عدة دبابات، ودخلوا عين النفق، فاستهدفتهم طائرة بصاروخ النجاة منه مستحيلة".
كانت هذه الرواية الأرجح، لكن قلوب المحبين تبحث عن مواضع شكٍ تُبقي الأمل حيّا؛ ماذا لو لم يقتله الصاروخ؟ ربما أخطأته الشظايا فأسرع بالمغادرة، أليس ممكنا أن يكون مصابًا إصابة طفيفة فينقذه أحدهم، الاعتقال احتمال وارد، هو واردٌ فعلا لكنه ليس مرغوبًا لصعوبته.
تذبذب الأهل بين الشك واليقين، شكٌ مبني على فكرة عدم وجود جثة تثبت الاستشهاد، ويقينٌ عماده الرواية السابقة.
عدم وجود جثة، يتبعه انعدام فرصة الوداع، وهذا من أكثر ما يؤلم ذوي المفقودين المُرجح استشهادهم، الحرب خفضت سقف الأمنيات ليصبح أسماها وداعهم لا عودتهم، فالأم التي كانت تقول "مشفتش جثة عشان أصدق"، صارت تبكي بعدما شاركت في وداع شهيد من أقاربها، وتقول: "عملت اللي كان نفسي أعمله لابني، ودعته وصليت عليه ودعيت عنده وروحت معه المقبرة".
بعد أكثر من سنة فعل فيها الحزن ما فعل بأحباب المفقود، خرج قريبه من السجن، وأعطاهم الخبر اليقين: "قابلت فلانًا في الأَسر، فقال إنه دفنه بنفسه"، يثق الأهل بقريبهم، وبالأسير الذي قابله، لكن ثمة مشكلة أخرى ظهرت، المنطقة التي قال الرجل إنه دفنه فيها خطيرة جدًا، حتى في فترة الهدنة المؤقتة، والوصول إليها يتطلب تنسيقا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هنا تتوقف جهود البحث، التنسيق المطلوب ما هو إلا صخرة تتحطم عليها كل المساعي، فأهل المقاوم لا يعطوا أي معلومات لأي جهة.
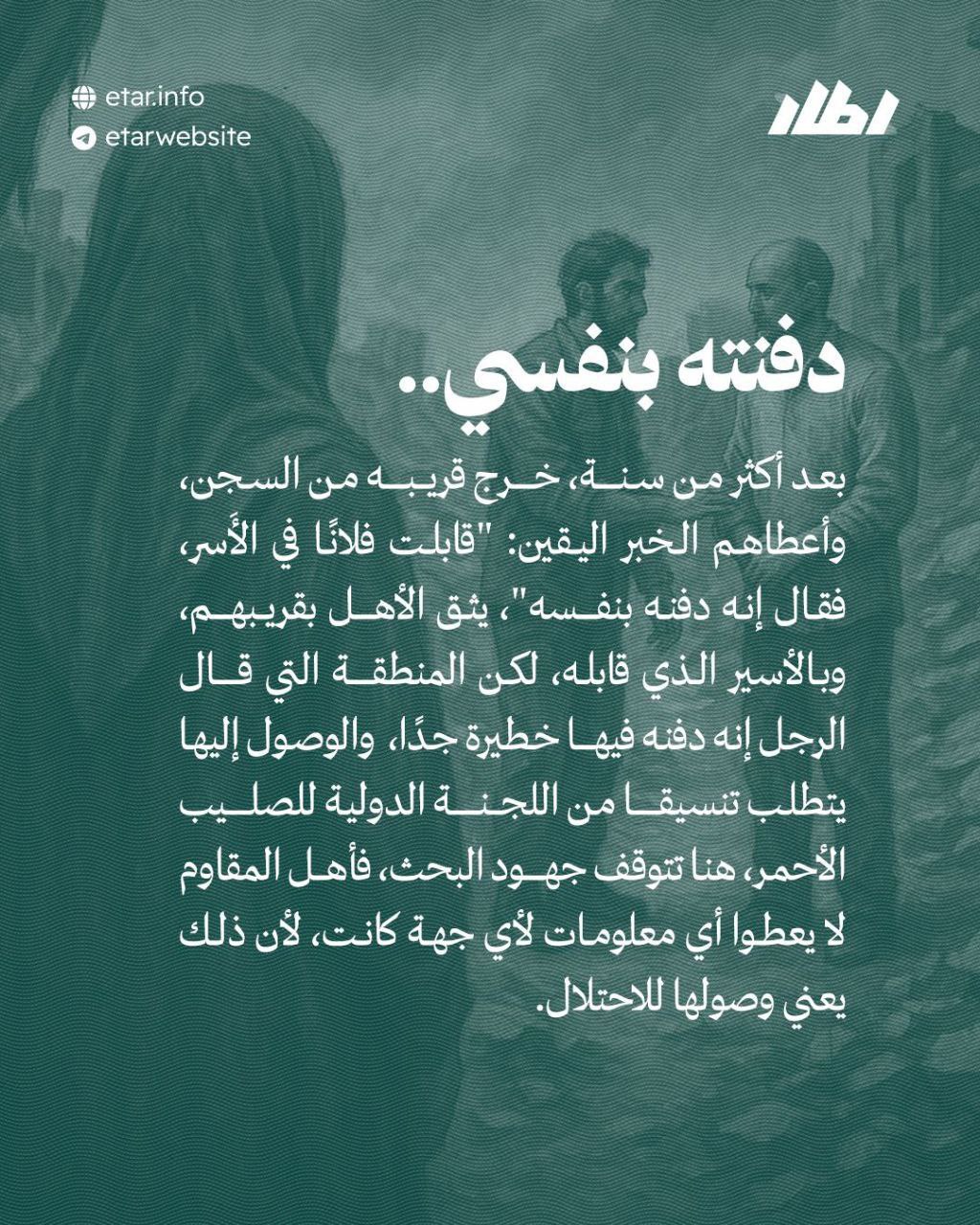 مكان القبر محدد ولكن... حالة مشابهة، لشابٍ انقطعت أخباره إلا من خبرٍ عن مكان دفنه في مكان لا يمكن الوصول له إلا من خلال الصليب الأحمر.
مكان القبر محدد ولكن... حالة مشابهة، لشابٍ انقطعت أخباره إلا من خبرٍ عن مكان دفنه في مكان لا يمكن الوصول له إلا من خلال الصليب الأحمر.
بعد نحو عشرة أشهر من انقطاع أخبار (ع) التقى أحد أفراد أسرته بواحد من عناصر مجموعته، فأخبره أنه استشهد عندما كانوا في عقدة قتالية بمنطقة بالغة الخطر، ودفنه زملاؤه في ذات المكان.ومع ذلك، استمرت العائلة في رفض تصديق استشهاد ابنها، ما يزال الأمل يراودهم بأن تكون المعلومة غير صحيحة.
خلال الهدنة، دار الحديث عن قبور وجثث في المكان المُحدد، سمعت عمة "ع" الخبر، فتحفّظت عليه، اعتقادًا منها أنها إن تحدثت عن الأمر فالنتيجة الوحيدة هي فتح الجرح مجددًا، وإشعال الأمل الذي لم يمُت عند والديه، فهي تدرك استحالة التواصل مع الصليب الأحمر وتزويده بمعلومات عن المفقود، أي أن الأسرة لن تتخذ أي خطوة في البحث عنه.
قالت في نفسها إن ابن أخيها لو كان بينهم، فستعرف الأسرة بالأمر حتمًا، معتمدة على أنه في حال العثور على جثته سيصل الخبر إلى إخوانها المنتمين لكتائب القسام، لكن سرعان ما عاد الاحتلال للحرب من جديد، وعاد الوصول للمنطقة ممنوعًا، فتأكدت من صحة قرارها بالصمت.
الكل يعرف... ولن نعترف
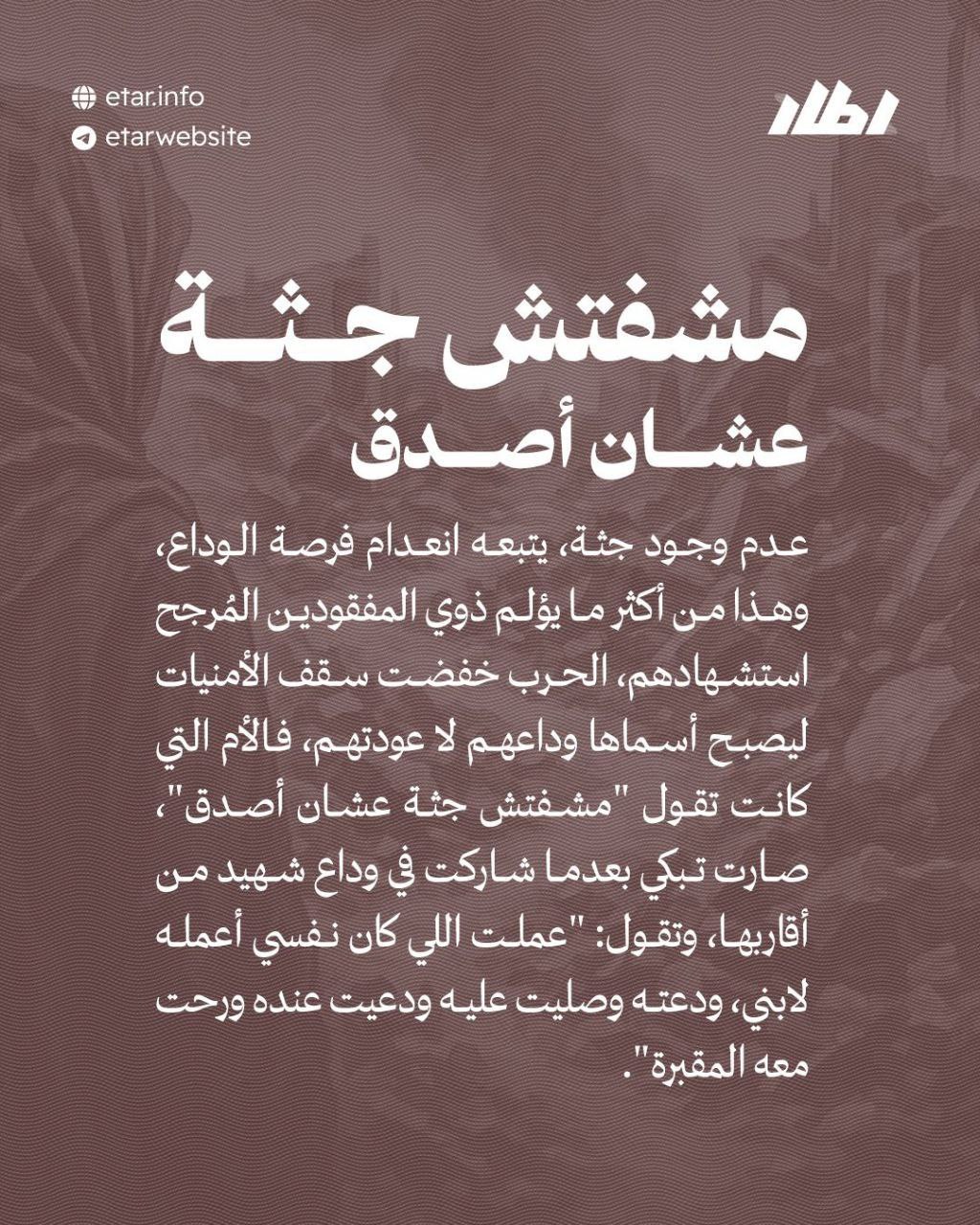 "آسف، آسف، بس عندي استنفار"، هذا آخر ما قاله "ر" لزوجته عندما تسبب بإيقاظ طفلتهما صبيحة يوم العبور، كان سهلًا ليّنًا مهذبًا فاعتذر لأنه أزعج زوجته التي ستضطر لتنويم ابنتها مجددًا.
"آسف، آسف، بس عندي استنفار"، هذا آخر ما قاله "ر" لزوجته عندما تسبب بإيقاظ طفلتهما صبيحة يوم العبور، كان سهلًا ليّنًا مهذبًا فاعتذر لأنه أزعج زوجته التي ستضطر لتنويم ابنتها مجددًا.
أخذ سيارة والده، وأوصله في مشوار خاص به، ثم اختفى، وعند البحث، وجد الأهل السيارة متوقفة قرب حدود القطاع مع المناطق المحتلة، لم يستغربوا، فهو مقاتل في صفوف كتائب القسام منذ سنوات. لكن السؤال الصعب كان: أين هو الآن؟ ثلاثة أيام بلا جواب، كانت هي الأيام الأقسى في حياة أفراد الأسرة، لم يذق أي منهم طعم النوم خلالها.
أشقاء "ر" لم يتركوا سبيلًا للبحث عنه إلا وخاضوه، ساعدهم في ذلك كونهم مقاتلين في القسام، ورغم صعوبة التواصل تمكنوا من الحصول على رواية يمكن تصديقها. أول أخٍ حصل على خبر، لجأ لشقيقته، طالبا منها: "احضنيني"، ولما رأى الخوف في ملامحها، قال: "احضنيني، وتعالي نحكي الخبر لبابا وماما، استشهد".
"ربط مكان الإصابة ليوقف النزيف، وطلب من رفاقه تزويده بالسلاح، ليقاتل حتى آخر نفس"، كان هذا المشهد الأخير لـ"ر" كما رواه أكثر من مجاهد ممن كُتب لهم الرجوع لغزة، لكن لا أحد يعلم ما حدث بعد ذلك. توقع أهله أن يكون استشهد بعدها، وامتنعوا عن البوح بالخبر لأي شخص، حتى استشهد شقيقه بعد فترة، ولما جاء أعمامه وأخواله للمواساة، أخبروهم، وأوصوهم بالتكتم أيضًا.
ظروف الحرب، وانقطاع التواصل والزيارات بين الناس، ساعد على التمسك بفكرة الكتمان لفترة طويلة استمرت لسنة تقريبًا، ولما انتشر الخبر، اكتفى أهله بالقول إنه مفقود، ولا معلومات عن مكان فقده، فربما كان قريبًا من قصف مكن ما، ووصلته الشظايا، أو تفتت جسده، ولم تُحدد هويته. يدرك أهل المفقود أن "غزة صغيرة"، وأن كثيرًا من أقاربهم يعرفون الحقيقة، لكنهم متمسكون بالإنكار من باب "نعمل اللي عليا"، وذلك حفاظا على الأسرة وما بقي من بيوت أفرادها.
"إن عاد، فعودته هدية من الله لنا، وإن لم يعد فالهدية الإلهية له باصطفائه كما أراد دوما"، هكذا اتخذت العائلة قرارا بـ"قطع الأمل"، لأن الأمل في هذه الحالة "قاتل"، خاصة مع استبعاد فكرة الاعتقال، فالمُتوقع نظرًا لطبيعة شخصيته ألّا يسمح لأحد باعتقاله وأن يستمر بالهجوم حتى يستشهد.
ومع ذلك، عندما ظهر اسم مشابه لاسمه في كشوفات أسماء الأسرى، باغت الأمل قلب أخته التي قرأت الكشف، شعرت بسعادة كبيرة رغم ثقتها أن شقيقها شهيد، حاولت التأكد من الشخص المذكور عن طريق جهة معنية بشؤون الأسرى، طرحت العديد من الأسئلة عن الأسير، كالاستفسار عن عمره وحالته الاجتماعية، ولمّا استغرب الطرف المقابل وحاول أن يفهم سبب اهتمامها، أنهت الحوار، ولم تعد تسأل. لم يسجّل أهل "ر" اسمه في أي جهة للبحث عن المفقودين، ولم يتموا أي إجراءات متعلقة به، لأن أول ما تسأل عنه أي جهة عند البحث: "مكان الفقد"، وهو قد فُقد في الداخل المحتل.
العودة لأحكام المفقودين
نفس الرفض، تعيشه أسرة "م"، لكن مع كثير من الأمل، فالشاب دخل الحدود بالفعل، لكنه أنهى مهمته الجهادية وعاد إلى قطاع غزة، وفيه استهدفته طائرات الاحتلال فاستشهد، ولخطورة المكان والزمان، لم يتمكن أحد من انتشال جثته.
رغم تأكد الأسرة من هذه الرواية التي نقلها أشخاص ثقات، إلا أن بعض أفرادها يرفضون تصديق استشهاد ابنهم، يقول بعضهم ربما أُصيب في القصف وحصل على العلاج المناسب، فلماذا لم يعد طالما هو داخل حدود القطاع؟ يرد المُشككون في أمر استشهاده: "قد يكون عاد للقتال، فاعتقله جنود الاحتلال". والدته تنتظر أن يعود إليها يومًا، حتى لو كان أسيرًا، فلا مشكلة، المهم أن يعود.
عودة الشاب إلى القطاع، تجعل تسجيله ضمن المفقودين أقل خطورة، ومع ذلك يرفض أهله الأمر رفضا قاطعا، خوفا من التبعات الأمنية.
أشهر قليلة مرّت على زواج "م" قبل الحرب، زوجته العروس وضعت طفلتهما الأولى بعد استشهاده، لكنها لم تتمكن من تسجيلها ضمن أبناء الشهداء للحصول على كفالات أو مساعدات خاصة بهم.
ناهيك عن كونها شابة في مقتبل العمر فقدت زوجها ولا دليل على استشهاده، ما يجعل تفكيرها بالزواج مجددًا أمرًا بعيدًا ومرهونًا بالأحكام الشرعية للمفقودين، فللمفقودين أحكام شرعية خاصة بهم، لم يتخيل الفلسطينيون أن يعودوا للبحث عنها مجددًا.
بانتظار فنجان القهوة
الكل ينعى "س"، إلا والدته، ما تزال أسيرة الأمل، تقف في اللحظات التي تأخرت فيها عن شرب قهوتها الصباحية بانتظار عودة ابنها من صلاة الفجر بعد شروق الشمس، ليشرباها سويًا كما اعتادا.
في مساء السابع من أكتوبر، ذاع خبر استشهاده بين شباب الكتائب في منطقته، ثم بين أبناء المسجد الذي يرتاده، وقبل أن ينتشر أكثر، أكد أهله أنه بخير وطلبوا عدم ذكر اسمه بين الشهداء.
استشهد من استشهد من شباب المجموعة، وعاد من عاد، إلا "س" لم يثبت شيء بشأن مصيره، لكن كل المؤشرات ترجح استشهاده، وهذا ما اقتنع به أهله، بينما أمه مصرّة على الإنكار والانتظار.
الإنكار فكرةٌ جيدة من الناحية الأمنية، كما ترى أسرته التي ما تزال متمسكة بإخبار الناس بأنه مسافر لاستكمال دراسته العليا، رغم أن الكل يعرف باستشهاده. مع كل الحذر، كاد الشوق والقلق أن يُوقعا الأم في الفخ، قررت أن تسجّل اسم ابنها في واحد مواقع البحث عن المفقودين، رغم وضوح تبعيتها للاحتلال، لولا أن قريبة لها سمعت بنيّتها فأخبرت ابنتها لتحذرها.
ما تزال تحتفظ بكل شيء يخصه، لا للذكرى، وإنما ليجده كما تركه إن عاد، غرفته على حالها، شقته تنتظره ليتزوج فيها، أمواله في الحفظ والصون، كان متفوقًا لدرجة العمل في وظيفة مميزة أثناء دراسته الجامعية، ادخر تكاليف الزواج واشترى بيتا، وتخرّج، وحان وقت البحث عن شريكة العمر.
في رمضان، تُخرج الأم الصدقات عن "أرواح كل الشهداء" فقد يكون ابنها بينهم، وفي العيد تدفع عنه زكاة الفطر كما لو كان حيّا، وفي كل وقتٍ تدعو له بكل شيء إلا "الله يرحمه"، لا يسمح قلبها للسانها بترديد هذا الدعاء.
طالما هي لم تعترف لنفسها باستشهاد ابنها، فحالها حال غيرها ممن تظهر عليهم الحيرة عندما يرفعون أكفّهم، لا يعرفوا الدعاء المناسب، تجدهم يقولون: "ربنا يجيب خبره على خير"، "الله يرحمه عايش أو مستشهد"، "ربنا يرحمه فوق الأرض أو تحتها"، "الله يلطف فيه على أي أرض أو في أي سماء"، "الله يهدّي بالنا عليه"...
مفقودٌ رغم دفنه
تجربة فقد قصيرة عاشها أهل الشهيد "و"، ورغم التأكد من مصيره، ما تزال تبعات فترة انقطاع الأخبار تلقي بظلالها عليهم.
في نهاية 2024 انقطع تواصل الأسرة مع ابنها المنخرط في صفوف القسام في شمال القطاع، ومع بدء سريان الهدنة في يناير المنصرم، وانسحاب قوات الاحتلال، وصل الخبر الصعب، لقد استشهد.
كان الشهيد يحتفظ في جيبه بورقة سجل فيها رقم هاتف أحد معارفه، أخذ الورقة رجلٌ عثر على جثته ودفنها، وبعد الهدنة تواصل مع الرقم، وأخبر صاحبه بموقع الدفن.
ذهبت أسرة الشهيد إلى المكان، وجدت جثته بالفعل، فنقلتها إلى المقبرة، ولما حاول والده استخراج شهادة وفاة، لم يتمكن من ذلك لكونه دفن ابنه بشكل شخصي دون المرور على المستشفى أو أي جهة رسمية.
نتيجة عدم وجود شهادة وفاة، ما يزال الشهيد مفقودًا من الناحية القانونية، ويترتب على ذلك مشاكل في جوانب عدة، مثل تقسيم الإرث، وتسجيل أبنائه في جمعيات الأيتام.
قتلوا الأمل قبل أن يقتلهم... بدل البحث عن عروس، يبحث الأهل الآن عن العريس المفقود، الذي كان آخر عهدهم به سلامٌ سريع صبيحة يوم الطوفان.
"م" الشاب الوسيم، بكر والديه وكبير إخوته، وافق على الزواج أخيرًا بعد طول رفض لألا يترك أرملة وأيتاما خلفه، فالجهاد طريقه والشهادة غايته، بدأت أمه وأخواته بالبحث عن عروس، وبدأ والده بتجهيز بيت رغم ضيق ذات اليد.
بعدما ضجّت الأخبار بما يفعله شباب المقاومة في الداخل المحتل، ودّع الأسرة بذريعة السلام على أخواته المتزوجات قبل عودتهن إلى بيوتهن، وقد كنّ مجتمعات في بيت والدهن من الليلة السابقة، ثم خرج من البيت على عجل.
الأسرة التي ينتمي أغلب أفرادها إلى المقاومة لم تتوقع توجهه إلى الداخل المحتل، ظنوا أن العبور توقف وأنه في مهمة جهادية داخل القطاع، حتى وصل الخبر في وقت متأخر عندما عاد عمّه الذي يعمل معه في نفس المجموعة في كتائب القسام.
انسحب العمّ بعدما أنهى مهمته، طمأن شقيقه على ابنه، وحدّثه عن بطولاته، وأخبره برفضه القاطع لفكرة الرجوع للقطاع، إنه مصمم على الاستمرار في القتال حتى الاستشهاد. وصلت الأهل عدة رسائل مطمئنة في الأيام الأولى من الحرب، مع الكثير من الأخبار عن بطولات استثنائية خاضها الشاب العشريني، ثم توقفت المعلومات تمامًا حتى يومنا هذا.
والده مطلوب للاحتلال، لذا انفصل عن أهله وانقطع عن التواصل المباشر معها طوال الحرب، كان يراسلهم عبر وسطاء على فترات متباعدة، وذات رسالة، أكّد لهم أن "م." شهيد. لم يخبر أهله أحدًا، ولم يستقبلوا المقربين للعزاء، وأغلقوا هواتفهم عدة أسابيع، وبعد فترة حين بدأ الناس بالتعايش مع الحرب والتواصل والتزاور، تبيّن أن الخبر منتشر بين الأقارب.
في الهدنة، اجتمعت الأسرة، وسأل الأبناء الأب عمّا بلغه بشأن أخيهم، فأخبرهم أن لا معلومات جديدة، ولكن لا احتمالات لنجاته، وهنا عاد الشك ليساور أمه وإخوته، ولكنهم هذه المرة قرروا أن يقتلوا الأمل قبل أن يقتلهم.
رب الأسرة مطلوب للاحتلال، ما يعني أن الخطر قائم على الجميع، ولا خوف على الممتلكات بعد قصف المنزل، ومع ذلك لا يبحث أهل "م" عنه في السجون ولا يتواصلوا مع أي جهة معنية بالبحث عن المفقودين، يمتنعون من باب الاحتياط، كي لا يورطوه لو كان أسيرًا.
لا أعداد دقيقة
مؤسس المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين قسرًا، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان د. رامي عبده يعرّف المفقود بأنه "من حيث المبدأ هو الشخص الذي تجهل أسرته مكان وجوده نتيجة نزاع مسلح دولي أو غير دولي أو خطف أو كارثة أو أي سبب آخر. وبالنسبة لقطاع غزة، هو الشخص الذي انقطع اتصال ذويه به بسبب العدوان الحربي الإسرائيلي".
وعن المفقودين من المقاومين تحديدًا، يقول: "هم مثل غيرهم، لكن بلا شك هناك خصوصية في التعامل مع قضيتهم".
وفي حوار مع "إطار"، يضيف عن سبب هذه الخصوصية: "يتعامل الأهالي، وهذا حقهم، بحذر بشأن أبنائهم، وفي ما يتعلق بالمقاومين، ربما توجد تفاصيل عن حالتهم عند الفصائل والتشكيلات العسكرية التي يتبعون لها، وهم من يتحكمون في مستويات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهم".
ويتابع: "قدرة الأهالي على التحرك في البحث عن المفقودين المقاومين محدودة، لأن طبيعة عمل المقاومة تقتضي السرية، وليس دوما يكون عند الأهل معلومات عن نشاطات ابنهم".
ويواصل: "كما أن ما برز من انتقام إسرائيلي وحشي من المشاركين في هجوم السابع من أكتوبر، أو من أفراد المقاومة، يجعل الأهالي يترددون حتى في مجرد السؤال عن أبنائهم؛ خشية الاستهداف الإسرائيلي". ورغم هذه الخصوصية وكل ما يتبعها من خوف، يؤكد عبده: "مع ذلك تابعنا العديد من البلاغات من عائلات تتساءل عن أبنائها لمعرفة مصيرهم".
ويشير إلى عدم وجود أرقام دقيقة تحصر أعداد المفقودين بشكل عام، مبينًا: "في هجوم 7 أكتوبر، الحديث يدور عن عشرات الأفراد، كما يُعتقد وجود آخرين بحالات، ربما محدودة، فُقدوا في مناطق الاشتباكات خلال التوغلات الإسرائيلية".
ويوضح: "ليس لدينا أرقام أو إحصاءات، لكن المؤكد أن نسبة كبيرة من هؤلاء فصائلهم وتشكيلاتهم العسكرية ربما لديها معلومات عنهم، ويمكنها أن تحدد من قُتل أو تعرض للاعتقال، ومن لم يُعرف مصيره".
وعن حيثيات الاختفاء، يشير إلى أنه: "مع تطورات ما حدث يوم 7 أكتوبر 2023 عاد العديد من المشاركين في الهجوم من التشكيلات العسكرية، وقُتل أو فُقد آخرون واعتقلت قوات الاحتلال أعدادًا منهم ولا تزال تخفي مصيرهم. كما أن بعض هؤلاء من المدنيين الذين وصلوا إلى منطقة غلاف غزة مع انهيار منظومة الاحتلال الأمنية إثر هجوم الفصائل الفلسطينية. كما فُقد آخرون خلال الاجتياحات الواسعة للقوات الإسرائيلية للأحياء الفلسطينية في القطاع، سواء تحت الأرض أو فوق الأرض، ولحساسية الوضع والأماكن يكون من الصعب التحرك لمعرفة مصيرهم".
جريمة حرب
وعن الاعتقال دون إخبار الأهل، يذكّر عبده في المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006)، والتي تعرّف الجريمة بأنها: "القبض على شخص أو احتجازه أو اختطافه من قبل مسؤولين في الدولة أو أفراد يتصرفون بإذنها أو دعمها، مع رفض الاعتراف بمصيره أو مكان احتجازه، مما يحرمه من حماية القانون".
ويؤكد: "منذ السابع من أكتوبر، ولاحقًا عند بداية الهجوم العسكري البري الإسرائيلي في القطاع، تمارس القوات الإسرائيلية جريمة الإخفاء القسري لآلاف المعتقلين من القطاع، ويُعد ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، بما يشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
ويقول: "بما أن قطاع غزة يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي، فإن القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، تحظر الاختفاء القسري باعتباره جريمة حرب، فوفقًا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، فإن الاختفاء القسري يندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة التي تشمل القتل العمد والتعذيب والاحتجاز غير القانوني. كما هو جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
ويضيف أن هذا يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ما يستوجب تحركًا دوليًا قانونيًا وسياسيًا لمحاسبة الاحتلال ووقف هذه الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وفي ما يتعلق بمحاولات ذوي المقاومين المفقودين للوصول لمعلومات عنهم، يبين عبده أن الأهالي يسلكون عدة اتجاهات، منها سؤال الجهات الي يتبع لها أبناؤهم في الفصائل، وأحيانًا يتجهون إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك للمنظمات الحقوقية.
ويوضح: "لا شك هناك خطورة لأن إسرائيل تنتقم من ذوي أفراد المقاومة ضمن سياسة عقاب جماعي يجرّمها القانون الدولي، والمخاطر متعددة، فقد يكون الشخص غير معتقل وقوات الاحتلال لا تعرف عنه شيئًا، وبالتالي الحديث عنه يقدم معلومات للاحتلال، وربما يكون معتقلا بحالة مدنية والسؤال عنه كمقاوم يدفع الاحتلال إلى التحقيق معه من جديد. كما أن الحديث عن بعض التفاصيل عنه وهي من متطلبات البحث عن المفقودين قد تفصح عن معلومات تسبب أذى للشخص وعائلته".
ما يلاحظه عبده خلال عمله في قضايا المفقودين، غالبًا يلتزم الأهالي الصمت، ولكن جزءًا منهم يسعى للبحث، ناسين أو متجاهلين الخطر المُحتمل بسبب صعوبة الفقد عليهم من الناحية الإنسانية.
وعن إعلانات البحث عن المفقودين، يقول: "العديد من المؤسسات الحقوقية أطلقت روابط للبحث عن المفقودين، وهي مسألة طبيعية ومتفهمة، ويبقى على الشخص المُبلغ المسؤولية والانتباه إلى ما يدونه. أولوية المؤسسات الحقوقية هو الوصول لمعلومات عن المدنيين وإطلاق حملات مناصرة وحراك قانوني بشأنهم".
ويضيف: "ينبغي على الأهل التحقق من الجهات الي يتعاملون معها والروابط التي يُدخلون المعلومات عبرها، والانتباه لكل حرف يكتبونه"، متابعًا: "في حالة المقاومين، المسار المهم لمعرفة معلومات بشأنهم هو مراجعة الفصائل التي تتبع لهم، ربما لاحقا بعد وقف الأعمال الحربية بشكل تام يصبح ممكنا التحرك في مسارات أخرى".
إجراءات قانونية وإنسانية دقيقة
 مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي د. إسماعيل الثوابتة يتحدّث لـ"إطار" عن المفقودين بشكل عام، يقول إن قضية المفقودين تمثل واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية التي خلفتها حرب الإبادة الجماعية، وهي من الملفات الأكثر تعقيداً والتي تحتاج إلى تحقيق دولي موسع، كونها ترتبط بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي د. إسماعيل الثوابتة يتحدّث لـ"إطار" عن المفقودين بشكل عام، يقول إن قضية المفقودين تمثل واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية التي خلفتها حرب الإبادة الجماعية، وهي من الملفات الأكثر تعقيداً والتي تحتاج إلى تحقيق دولي موسع، كونها ترتبط بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
ويضيف: "تجاوز عدد المفقودين أحد عشر ألفًا، بينهم عائلات بأكملها دُفنت تحت الركام، في ظل عدم قدرة الطواقم المختصة على انتشالهم بسبب استمرار العدوان ونقص المعدات وعرقلة الاحتلال لعمليات الإنقاذ والبحث"، متابعًا.
ويبين أن التعامل مع المفقودين يتم وفق إجراءات قانونية وإنسانية دقيقة تشمل التبليغ الرسمي عن المفقود من عائلته عبر جهات مختصة، وإجراء عمليات بحث وتحقيق ميداني بالتعاون مع فرق الإنقاذ والمؤسسات الحقوقية، وتوثيق الحالات عبر السجلات الرسمية، بما يشمل شهادات الشهود، والأدلة المادية، وتقارير الجهات الطبية والإنسانية، وذلك من خلال لجنة قانونية رسمية.
وعند تأكيد استشهاد المفقود بناءً على الأدلة القاطعة، تُصدر شهادة وفاة بعد مرور فترة زمنية محددة واستيفاء التحقيقات اللازمة، بالتنسيق الكامل بين وزارتي الداخلية والصحة وجهات مختصة أخرى، وتعتمد الجهات المختصة على شهادات موثقة من أفراد العائلة، أو شهود عيان، أو فرق الإنقاذ، أو الصور الجوية للدمار في مناطق الاستهداف. بحسب الثوابتة.
ويوضح: "اتخذت الحكومة قرارًا بوقف اعتماد المفقودين باعتبارهم شهداء إلى حين الاستقرار الأمني والتأكد من مصيرهم وفقًا للمدة القانونية التي يحددها القانون الفلسطيني".
وعن كيفية التعامل مع ممتلكات المفقود، يؤكد أنها تبقى محفوظة وفق الإجراءات القانونية حتى يُحديد مصيره، وفي حال إثبات الوفاة بشكل رسمي، تُنقل الملكية إلى الورثة الشرعيين وفق الإجراءات القانونية المطبقة لدى الأجهزة الحكومية".
