حصار الفقدان واستهدافه.. عن الحزن والحداد في سياق الإبادة الإسرائيلية
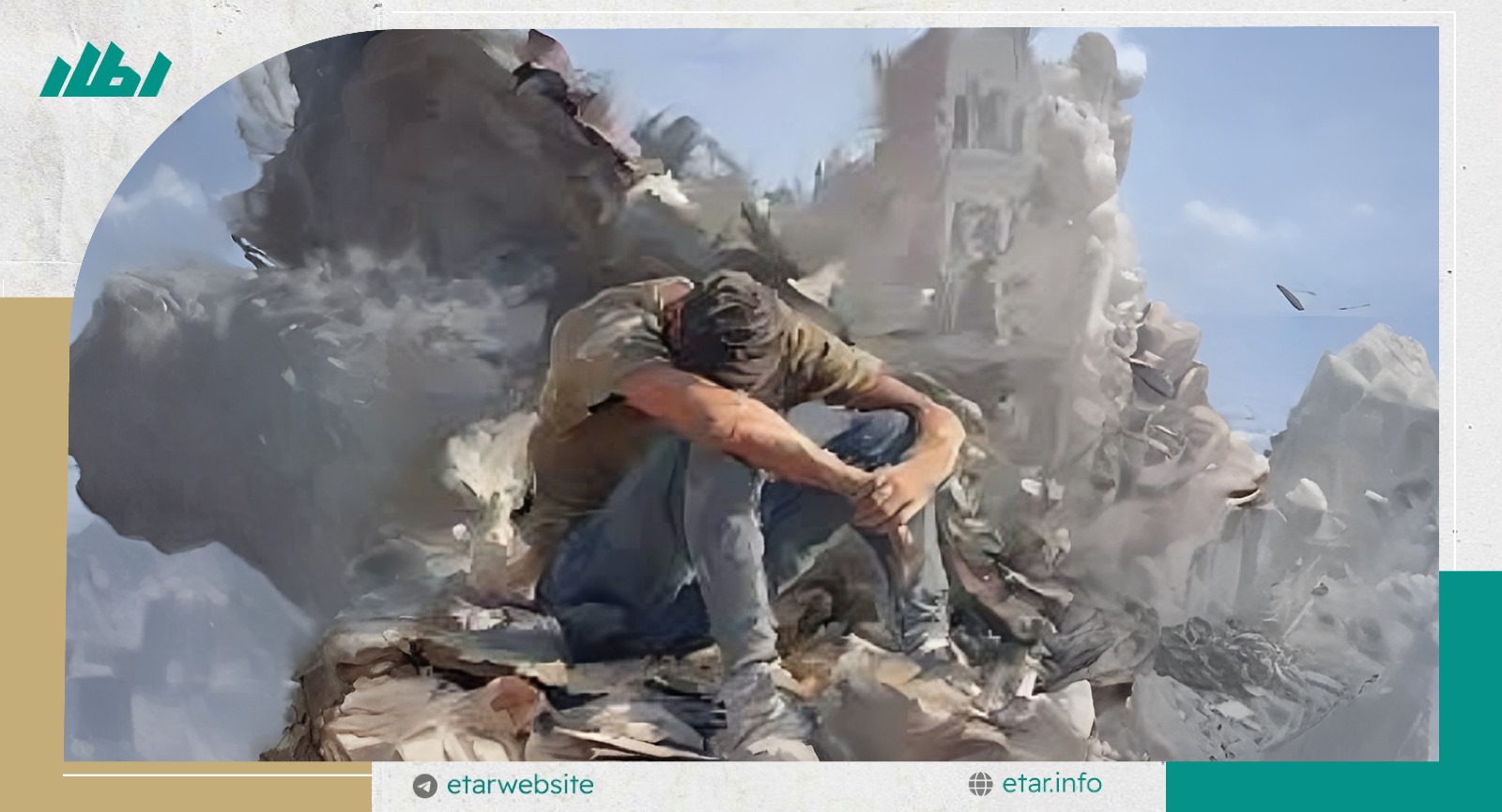
"يا حُزنَنا المؤجّل"
تفاعل أهل قطاع غزّة مع إعلان التوصل إلى "اتفاق وقف إطلاق النار"، بوصف المرحلة المقبلة بمرحلة التعبير عن "الحزن المؤجل" الذي قطعته "إسرائيل" من زمنهم وحرمتهم إياه في ظلّ سياساتها في حرب الإبادة تجاه مشاعر الحزن والحداد على شهدائهم، والتي تتمثل في ممارسات علّقت الطقوس الجنائزية من تشييع ودفن وحداد جماعيّ؛ مثل الحصار والقصف الكثيف وأثره على الحركة والتنقل، واستهداف القبور ونبشها وسرقة الجثامين من المقابر، والتركيم فوق الجثامين وإعاقة انتشالها، وإنشاء المقابر الجماعية والعشوائية، والتمثيل بالجثامين وإفقادها هويتها وإعاقة التعرف عليها.
كلّ ذلك يحيل إلى وجود سياسات إسرائيلية هادفة إلى تفكيك ما يُعرف بـ"بنية الفقدان" الفلسطيني؛ العاطفية والجماعية باعتبارها جبهة غير مرئية في منظومة الإبادة، عبر عرقلة ممارسة الحداد الجماعي والتعبير العاطفي الطبيعي عن الحزن والفقدان، وأنّ الهجمات لم تقتصر على البنية التحتية المادية فحسب، بل تتجاوز ذلك لتستهدف البنية النفسية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني، بمعنى أنّ العنف الإسرائيلي لم يُمارَس على المستوى الفيزيائي فقط، بل يتعداه إلى قمع عاطفي واستهداف الرموز الثقافية والاجتماعية من خلال تعطيل العزاء الفلسطيني وطقوس الحداد التقليدية، ما يعكس سعيًا إلى تدمير الثقافة الفلسطينية بشكل رمزيّ ويُشكل جبهة غير مرئية للاستعمار.
هذا السياق، يطرح تساؤلًا مفتوحًا عن الأهداف الكامنة وراء هذه السياسات التي يعيد الاحتلال بها صياغة مفهومي الفقدان والحداد، وعن آثارها بعيدة المدى على الهوية الجمعية والنسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني، انطلاقًا من خصوصية التعاطي الاجتماعي الفلسطيني مع حالة الموت في سياق استعماري اعتمادًا على مفاهيم مثل الاستشهاد والصمود والثبات، واتخاذ حالته المشكلّة سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًّا ونفسيًا، أداةً من أدوات تعزيز الهويّة الوطنية وبناء ذاكرة جمعية ورمزيات وممارسات ثقافية جامعة.
إدارة الحزن بوصفها ـأداة هيمنة استعمارية
لا يقتصر العنف الصهيوني الذي يشكل جزءًا من نفس الظاهرة الصهيونية مهما تعددت أشكاله وتجلياته[1]، على أدوات الهيمنة المادية. إذ تجمع سياسات الاحتلال ممارسات العنف المباشر وغير المباشر في إطار عنفها البنيوي بوصفها دولة عنصرية صهيونية، يشكّل العدوان والإرهاب والعنف الأساسَ التكويني والنسيج التاريخي والسبب الوجوديّ لها[2]، وهذه العناصر هي الطابع الذي تخلق منه "إسرائيل" أدواتها لفرض هيمنتها وسيادتها كمستعمِر.
في سياق حرب الإبادة التي شنتها على قطاع غزّة انطلاقًا من حيونة الشعب الغزّي ونزع الأنسنة عن كامل القطاع، تبنّت "إسرائيل" سياسات أخرى تجاوزت القصف والتدمير المادي إلى فرضها سلطة على بنى المشاعر والطقوس الاجتماعية بما يحوّل الحداد أداة من أدوات الصراع النفسي والسياسي، عبر تبنيها إستراتيجيات تسعى إلى خلق بيئة تمنع الفلسطينيين من ممارسة حتى الحق في الحداد، في سلوك يتجاوز القتل الفيزيائي ليصل إلى القتل الرمزي، إذ يُحرَم الضحايا من الاعتراف بهم إنسانيًا من خلال منع الممارسات التي تُعيد لهم –ثقافيًا-كرامتهم بعد الموت، ليُظهِر هذا النهج (الحرمان من الحداد في ممارسة لـ"القتل الرمزي إلى جانب المادي) محاولة فرض حالة من اللاإنسانية الدائمة التي تسلب الفلسطينيين حتى أبسط حقوقهم مثل التعبير عن الحزن؛ ما يمثل نزعًا للإنسانية من خلال منعهم من التصالح مع الفقدان. ومنه يُجرَّد الفلسطينيون من حقهم في التعاطي مع معنى الموت.
كما لا يمنع الاحتلال الفلسطينيين من التعبير عن حزنهم فحسب، بل يدير هذا الحزن ليكون أداة قمع؛ عبر منع الجنازات، وتدمير المقابر، وإعاقة القدرة الجماعية على ممارسة طقوس الحداد التقليدية وتنظيم التجمعات الجنائزية عبر القصف والاستهداف وغيرها من الممارسات التي تخلق إدارة قسرية تنتج بيئة من الصدمة المستمرة، إذ يُستخدم الفقدان وسيلة لإضعاف المجتمع نفسيًا واجتماعيًا؛ إذ لا يعتبر الحداد، وخاصةً في السياق الفلسطيني الذي تطغى فيه صورة الموت الاستشهادي، مجرد تعبير فردي عن الحزن، بل هو عملية جماعية تُجسّد استمرارية الهوية الجمعية والروابط الاجتماعية والوطنية. لذلك تسعى سياسات الاحتلال الإسرائيلي إلى تعطيل هذه الديناميكية من خلال استهداف الطقوس الجنائزية، بهدف إضعاف الروح المعنوية الجمعية وإفقاد المجتمع الفلسطيني أحد أدواته الأساسية التي اعتاد توظيفها في مواجهة الهيمنة والقمع الاحتلالي، ومحاولةً لفرض حالة من الصدمة الدائمة أو المستمرة، من خلال حرمان الفلسطينيين من فرصة تجاوز فقدانهم وإعادة تنظيم حياتهم الاجتماعية والنفسية.
الحداد باعتباره عملية جماعية
يمثل الحداد في الثقافة الفلسطينية أكثر من مجرد استجابة نفسية للفقدان؛ فممارسات الحداد ليست مجرد عملية فردية بل هي نشاط جماعي وجزء من النسيج الثقافي والاجتماعي الفلسطيني، تتيح للمجتمع تجاوز الصدمة عبر التواصل العاطفي والتضامن الاجتماعي والدعم النفسي بوصفها وظائف اجتماعية للحداد؛ إذ تشكّل طقوس العزاء والجنازات مساحة أساسية لبناء التعاطف وتقديم الدعم الاجتماعي، ولإعادة تأكيد الهوية الجماعية وتعزيز الروابط الاجتماعية، خاصةً في سياق يتكثف فيه القتل الاستعماريّ والصدمات المتكررة. ومن ثمّ، فإنّ أيّ استهداف لهذه الطقوس عبر الحرمان من الحداد ومنع التجمعات الجنائزية ومساحات التعبير والتضامن ليس فقط هجومًا على الأفراد، بل هو تعطيل لتلك الوظائف ومحاولة لتقويض كامل النظام الاجتماع، وبهدف تفكيك النسيج المجتمعي بما يؤدي إلى زيادة العزلة الفردية وتآكل الشبكات الاجتماعية التي تُعتبر أحد مصادر المقاومة؛ تبعًا للتأثير النفسي والاجتماعي لانهيار القدرة على ممارسة الطقوس الجنائزية التقليدية.
ومن ناحية أخرى، يُنظر إلى الحداد فلسطينيًا باعتباره أداة مقاومة ثقافية، فعبر تخليد ذكرى الشهداء وممارسة الطقوس الجنائزية وطقوس العزاء، يعيد الفلسطينيون صياغة الحداد ليصبح رمزًا للصمود وحفظ السردية وتعزيز الهوية الوطنية، بوصف تلك الممارسات جزءًا من عملية رمزية تُحول الأفراد من كونهم مجرد "ضحايا" إلى "شهداء" يحملون معانٍ سياسية وقصة بطولية أو قيمة تضحوية.
لذلك، فإن استهداف هذه الممارسات يمثل محاولة لإسكات الرواية الفلسطينية وقمع الرموز التي تُغذي الهوية الوطنية؛ إذ لا يرى الاحتلال الإسرائيلي الجسد الفلسطيني الميت إنسانًا، بل يراه رمزًا سياسيًا؛ لأنّ "جسد الفلسطينّ/ة كان دومًا محلًّا لصوغ علاقات السيادة والانتفاض عليها، لا موقعًا لعلاقات السيادة-العبوديّة كما أُدعي أكثر من مرّة."[3] ومن ثمّ فإنّ استهداف طقوس الحداد يعكس حربًا على المعاني التي يحملها هذا الجسد، ومنع الجنازات هو محاولة لتجريد الجسد من أي دلالات سياسية، كأن يكون "شهيدًا" أو رمزًا للمقاومة.
هنا يُحوّل الاحتلال الجسد الفلسطيني إلى مجرد رقم إحصائي، ليُضعف رمزية الموت "الاستشهادي" في الصراع معه، ومنه تكون سلطته على "سياق الموت الزماني والمكاني وطقوس الموت وشكله هو محاولة لتغييب طقوس حالة الشهادة لدى الجماعة الفلسطينية وانتهاك لكرامة الشهيد وخصوصيته الكامنة في العُرف المجتمعي الذي يرى في حالة الشهادة معنىً للنضال وسبب للمقاومة والرغبة في الانتصار".[4] ومنه يمكن فهم كيف تعمل سياسات الاحتلال على إعادة تشكيل ممارسات الحداد الثقافية لإضعاف الهوية الجماعية، على اعتبار أن منع الحداد وحرمان الفلسطينيين من ممارسة طقوسهم الثقافية والعاطفية ليس مجرد فعل عابر، بل هو استراتيجية منهجية تهدف إلى ضرب أساس من أساسات الهوية الثقافية والجماعية للمجتمع الفلسطيني.
ومن جهة أخرى، يهدف الاحتلال عبر استهداف طقوس الحداد إلى السيطرة على الذاكرة الجماعية الفلسطينية أيضًا، أو "تقييد إنتاج الذاكرة الجمعية". إذ إن طقوس الحداد الفلسطيني تعيد إنتاج الذاكرة الجمعية أو تسهم في إنتاجها من خلال تخليد ذكرى الشهداء وربطها بالرواية الوطنية، فتُستَخدم هذه الذاكرة أداة مقاومة تُعيد تأكيد الحضور الفلسطيني وتوثيق الجرائم الإسرائيلية، كما تُعيد ممارسات الحداد إنتاج سردية الفقدان مصدرًا للصمود وجزءًا من الحاجة إلى النضال واستمراريته. وعليه فإنّ منع هذه الطقوس يهدف إلى تعطيل إعادة إنتاج الذاكرة الجمعية ونقلها للأجيال الجديدة، وعرقلة إنتاج رموز جديدة ترتبط بالهوية الفلسطينية الجماعية، وخلق جيل غير مرتبط بروايات الصمود السابقة؛ ما يعزز الشعور بالفقدان والانقطاع عن الماضي وسرديته، إضافةً إلى السيطرة على الرواية من خلال تغييب شهادات الضحايا.
خصخصة الحزن وهندسته
تأسيسًا على تعطيل الحداد عملية جماعية من حيث طقوسه التقليدية ومعناه ووظيفته الجمعية في الثقافة الفلسطينية، يمكن القول إن الاحتلال يهدف بشكل منهجيّ إلى "خصخصة الحزن" الفلسطيني بصورة قسريّة عبر منعه من أن يكون حدثًا عامًا ومشتركًا، ليصبح الحزن مسألة فردية منزوع عنه طابعه الجمعي ( أي تحويله من تجربة جماعية تُنتج التضامن إلى معاناة فردية معزولة)؛ لتعزيز الشعور بالعجز الفردي وإضعاف الروح المجتمعية التي تُبنى حول التضامن في مواجهة الفقدان. ذلك لأن الحزن الفردي والخاص أقل تهديدًا للاستعمار لأنه لا يُنتج روابط اجتماعية أو فعلًا جماعيًا أو حالة تشافي أسرع للمجتمع، كما أنّ هذه السياسة تعمّق بشكلٍ جمعيّ من الإحساس بفقدان الأنسنة والكرامة الجمعيّة والهوية الثقافية لدى كافة المجتمع، على اعتبار أنّها لا تستهدف فقط الأحياء الذين يُمنعون من الحداد، بل تمتد لتشمل الأموات الذين يُحرمون من تكريمهم التقليدي، فغياب طقوس الحداد يعزز حالة "اللاإنسانية" المفروضة على الفلسطينيين، وهو ما يحمل رسالة استعماريّة مضمونها هيمنة "إسرائيل" على الفلسطينيين أحياءً وأموات.
وبذلك، يمارس الاحتلال الإسرائيلي في استهدافه للمشاعر الجماعية في المجتمع الغزّي كالحزن، "هندسة عاطفية"، في محاولة منه للسيطرة على انفعالات المجتمع الفلسطيني وتحويل الغضب الناتج عن الحزن إلى حالة من العجز بدلًا من المقاومة، وإضعاف أي محاولة جمعية لإنتاج مشاعر (التضامن والصمود) في مقابل تقوية مشاعر(الإحباط والاستسلام)، بما يجعل من الحزن فقط عبئًا نفسيًا داخليًا دون منفذ اجتماعي للتفريغ أو التحويل إلى فعل مقاوم على تعدد وتنوع معاني وممارسات المقاومة في هذه الحالة، ففي السيطرة الإسرائيلية على مشاعر الفقدان وممارسات الحداد استنزاف حتى للقدرة على المقاومة النفسية بوصفها جزءًا من مرحلة التعافي. أيْ إنّ توظيف الاحتلال لسياسة القمع النفسي هو جزء من الحرب الشاملة لتعزيز أمد حالة الانهيار النفسي وإطالتها وإضعاف الروح الجماعية، وللحدِّ من قدرة المجتمع على إعادة بناء نفسه بعد الحرب؛ لخلق مجتمع يعيش في حالة دائمة من الصدمة المتجددة، عبر ترسيخ فكرة تطبيع الموت ليكون جزءًا يوميًّا من الحياة، يرتبط بالخوف والضعف وانعدام القدرة على ممارسة الحزن والحداد.
[1] عبد الوهاب المسيري، الصهيونية والعنف ... من بداية الاستطيان إلى انتفاضة الأقصى، (القاهرة: دار الشروق، 2001) ، ط1،ص5.
[2] عبد الغني عماد، ثقافة العنف في سوسيولوجيا السياسة الصهيونية، (بيروت: دار الطليعة، 2001)، ط1، ص116
[3] سهاد ظاهر-ناشف، "إمّا مُقاومًا وإمّا مقتولًا: الانتفاضة الفلسطينية الأولى كنقطة تحوّل في إعادة صياغة وكالة جسد وروح الفلسطيني/ة"، إضافات، العدد 46 (2019)، ص80
[4] إيمان بديوي، احتجاز جثامين الشهداء .. سلطة الاستعمار على الموت الفلسطيني، فسحة ثقافية، 12/1/2023، في: https://shorturl.at/SMN34
