حماس بعد 37 عامًا: دماءٌ حارة من التأسيس إلى ما بعد الطوفان
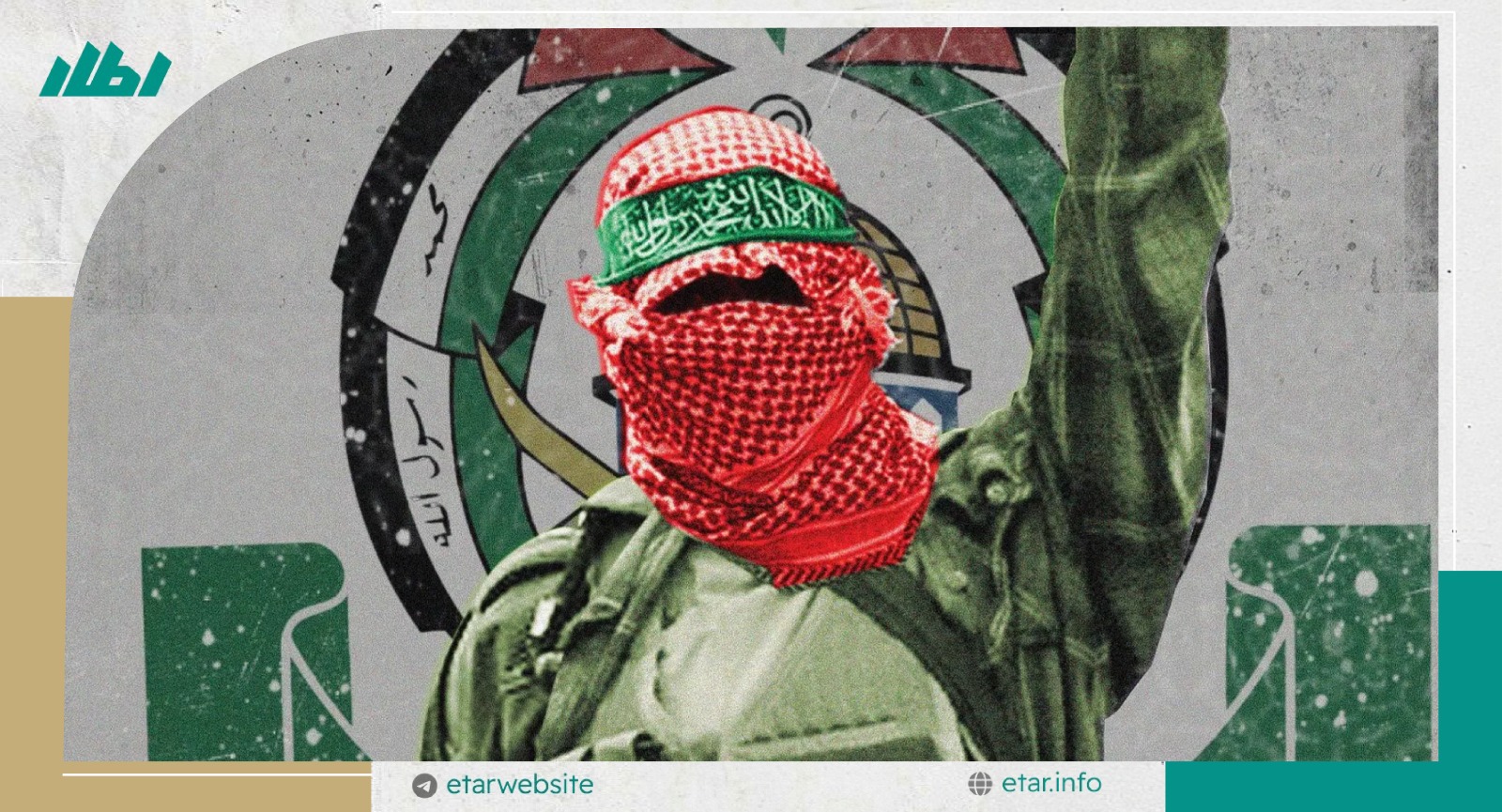
لعلّه لم يُخيّل لأحد من الساعين في المسار الطويل صوب حماس في غزّة والضفة الغربية وخارج الأرض المحتلة، وعلى رأسهم السبعة الذين اجتمعوا بمعية الشيخ أحمد ياسين، نهاية عام 1987، مطلقين على أيديهم الشرارة الأولى في التحوّل من النشاط الدعوي إلى المقاومة، أنّ الحركة الصغيرة الوليدة، التي كانت تبحث عن الرصاصة؛ ستأخذ لاحقًا "إسرائيل" على حين غرة، وتطلق طوفانًا تتردد أصداؤه جيوسياسيًا على امتداد المنطقة كلها، والعالم جميعه.
لكن هذا ما حدث، وبنحو متسارع أحيانًا، وهادئ في أحيان أخرى نمت الحركة وتشعبت وخاضت غمار تجارب السياسة والدبلوماسية والحرب والهدنة، وتخطت دوامات الانقسام الفلسطيني والحصار الإسرائيلي والعربي والدولي. تعاظمت أحيانًا وانكفأت على نفسها أحيانًا أخرى، لكنها ولكثيرٍ من الأسباب لم تختلف في محدداتها ورؤيتها عما وضعه مؤسسوها قادة العمل الإسلامي في فلسطين، وفي القلب منهم السبعة، الشيخ أحمد ياسين ورفاقه.
تتلمس السطور التالية أبرز محطات حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، منذ التأسيس حتى ما بعد الطوفان، مستنطقة ملامح كل مرحلة وما أفرزته من تغييرات وما تركته من آثار أنتجت الطوفان، ومحاولة استشراف حماس المستقبل ما بعد عامٍ من الطوفان.
الشرارة فاللهيب..
لم يكن البيان الأول الذي صدر يوم 14 من ديسمبر من عام 1987 نقطة البداية في ميلاد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحتى اجتماع السبع الكبار لم يكن كذلك، بل إن كُلا ًمنهما اكتسب أهميته لاحقًا بفعل تراكمية الإنجاز وعمقه، وقدرته على إحداث فارق ميداني واجتماعي في المجتمع الفلسطيني.
بل تعود البداية إلى أول ظهور مؤسساتي اجتماعي إسلامي في فلسطين عام 1945 على يد الإخوان المسلمين القادمين من مصر، حين اضطلعت شُعب الإخوان المسلمين التي تجاوزت العشرين شُعبة في كلٍ من القدس ويافا وحيفا وقلقيلية واللد وطولكرم والمجدل وسلواد والخليل وغزة وبئر السبع والناصرة وعكا، بمهمة البعث الإسلامي والإصلاح الاجتماعي والديني، وظلت بمنأى عن المشاركة السياسية أو العسكرية، لا سيما مع حملات قمع الجماعة في مصر.
وما بين نهاية السبعينات وبداية الثمانينات كان الميدان الفلسطيني يتهيأ لظهور إسلامي أكثر بروزًا بالتزامن مع ترسخ الاتحادات الطلابية والنقابية الإسلامية في مختلف المراكز والجامعات، بعدما كان للإخوان المسلمين مشاركتهم الجهادية في "معسكرات الشيوخ" بالأردن في إطار حركة فتح من العام 1968 وحتى 1970، وبينما حقق الجناح الطلابي الإسلامي في الضفة الغربية حضورًا لافتًا في انتخابات 1980 بجامعة النجاح الوطنية، وفوزًا مفاجئًا في العامين 1981 و1982، كان التيار الإسلامي في قطاع غزة يُعبر عن نفسه في ثلاثة من أبرز المؤسسات الأكاديمية والاجتماعية وهي المجمع الإسلامي والجمعية الإسلامية والجامعة الإسلامية.
أما على الأرض فقد تزايد الانخراط الإسلامي في الفعاليات الشعبية والجماهيرية، وبدا أن التيار الإسلامي يستعد لمواجهة مباشرة مع جلاده تتجاوز حدودها العمل الاجتماعي والدعوي والتربوي، وتحاول في تجربتها التماس فِعْل تنظيمات المقاومة الفلسطينية في الدول العربية المجاورة لا سيما الأردن ولبنان.
حتى أطلق الشيخ القعيد أحمد ياسين شرارة أول خلية عسكرية نهاية عام 1982، مكونةً من أربعة شُبان هو خامسهم، فبدأت الخلية بجمع الأموال لتأمين السلاح من خلال علاقاتها مع فروع الإخوان المسلمين الفلسطينيين في كلٍ من الأردن والكويت، وانطلقت خطوات التدرب على العمل العسكري، قبل أن تُكشف الخلية ويتم اعتقال الشيخ ورفقائه علي تمراز ومحمد شهاب وإبراهيم المقادمة وصلاح شحادة، وتراوحت أحكامهم ما بين 13 عامًا وعامين.
لكن اعتقال الخلية الأولى لم يوقف مسننات العمل العسكري بل أسهمت في تفرعه إلى المزيد من الخلايا والمجموعات متعددة المهام، فتم تأسيس جهاز "أمن الدعوة" -مجد- لملاحقة العملاء وتأمين العمل العسكري، كما أخرج عدنان الغول مجموعته العسكرية التي حملت اسم "المقاومة الإسلامية" إلى النور، لتُقدم على عددٍ من المهام المشتركة ذات الصبغة القتالية، مع مجموعات الجهاد الإسلامي، من بينها استهداف روني طال قائد الشرطة العسكرية في غزة، وضابط المخابرات فيكتور أرجوان، وتصفية عددٍ من العملاء، واستهداف شاحنةٍ عسكرية.
أما الفاصلة الأكثر رسوخًا في بدايات العمل العسكري للحركة فتعود إلى العام 1986، إثر خروج الشيخ أحمد ياسين من الأسر بعد صفقة تبادل بين الجبهة الشعبية- القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل ودولة الاحتلال، فأطلق بشكلٍ سريع شرارة العمل العسكري المنظم، وكلف صلاح شحادة بتشكيل عدة خلايا عسكرية، منفصلة جغرافيًا ولوجستيًا، لكنها واحدةٌ في هدفها وسعيها.
نتج عن ذلك لاحقًا الخلية 101 التي كانت نواة فعلية واختصارًا لنهج العمل المقاوم منذ تأسيس الحركة حتى اليوم، فأقدمت على مهاجمة المستوطنات وإطلاق النار عليها، ثم انخرطت مع فعاليات انتفاضة الحجارة بإطلاق عملٍ نوعي جمع كلًا من صلاح شحادة ومحمد الشراتحة ومحمود المبحوح ومحمد نصار وعبد ربه أبو خوصة، يقوم على خطف الجنود بهدف التبادل، فاعتمدت الخلية تكتيكات التنكر والخداع، والإعداد اللوجستي المسبق في اختيار المركبة ومكان الدفن وآلية التمويه، ومن ثم أسندت فعلها برسم الخرائط، ما جعلها أيقونةً يتردد فعلها في خلايا المقاومة لعقود.
أما إرث الخلية وأثرها فقد ظهر في عمليتي اختطاف الجنديين آفي سسبورتاس وإيلان سعدون في العام 1989، بفارقٍ زمني لم يتعدى الثلاثة أشهر بينهما، وهو ما اعتُبر الظهور الحقيقي للفعل العسكري الإسلامي في السجلات الأمنية الإسرائيلية، وقد أسفر تتبع الاحتلال للسيارة وملاحقة أفراد الخلية عن موجة اعتقالات كبيرة طالت المئات ممن لهم علاقة بالتيار الإسلامي، كان من بينهم المؤسس الشيخ أحمد ياسين، الذي حُكم عليه بعدها بالسجن مدى الحياة.
يقول الضابط الذي تولى مسؤولية التحقيق مع يحيى السنوار إثر اعتقاله عام 1988، أنه اعتُقل على خلفية عمله في التعبئة الوطنية ولم يتعرض لأكثر من تحقيق سطحي، حتى "تفجرت مسألة خطف الجنديين إيلان سعدون وآفي سبورتاس، عندها أدركنا أن هناك تنظيمًا واسعًا مسؤولاً عن خطف الجنود".
بالتوازي، ومع تطور العمل العسكري باطّراد، ومن تكثف أشكال الفعل العسكري ما بين خلايا الخطف، وخلايا العمليات الفدائية وإطلاق النار على الحواجز والمستوطنات والجنود، وانغماس كلٍ من الضفة وغزة في سلسلة متطاولة من تبادل الخبرات والأسلحة بين الخلايا والأفراد، وظهور روابط طُلابية ولجان للعمل الفلسطيني في الخارج، كانت الحركة أيضًا تتوسع وتتطور جماهيريًا واجتماعيًا وأكاديميًا.
فالمجمع الإسلامي الذي انطلق منه فكر الشيخ أحمد ياسين أصبح جامعًا وشاملًا ومنتشرًا في المساجد والنوادي والحواضن التربوية، وتنوعت مظاهر الإعداد وفئاته العمرية يما يضمن ضخًا متواصلًا للعمل المقاوم، واستمرارًا للنهج والمسيرة، بل وأصبحت مستندة إلى ميثاقٍ أطلقته الحركة أواخر عام 1988، حددت فيها رؤيتها وواجباتها وعقيدتها وعلاقاتها، وجمعت من خلاله قواعد العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج نحو هدفٍ واحد.
ومع تزايد مشاريع التسوية السلمية في المنطقة، وإعادة النظر المتواصلة من منظمة التحرير الفلسطينية في ميثاقها وعلاقاتها ورؤيتها لفلسطين التاريخية، أصبحت حماس إلحاحًا وجوديًا للشعب الفلسطيني الثائر على أرضه، في مواجهة موجات إعادة ترتيب المنطقة بما يضمن المصلحة الإسرائيلية.
وبينما كانت الخلايا العسكرية للحركة نهاية 1991 تُجمع على اعتماد اسم "كتائب الشهيد عز الدين القسام" مظلةً لها، فيما انطلق الحديد والبارود يحققان فورتهما الأولى بعبوات يحيى عياش وبندقية عماد عقل، وأضحت خلايا المقاومة والعمل المسلح متوزعةً على طول الضفة الغربية وعمق القطاع، وبالتزامن مع تعاظم الوعي الإسلامي المقاوم في نفوس الشعب الفلسطيني حتى أضحى إجماعًا، في مقابل ضريبة احتلال تُدفع للمرة الأولى رعبًا وخوفًا وخسائر بشرية ومادية في صفوف الصهاينة والمستوطنين، تلقت الحركة الضربة الأبرز في تاريخ تأسيسها، ولكنها كانت من المحطات الأهم في إعادة صعود الحركة وتصدرها الحركة الوطنية الفلسطينية.
فمع كانون الأول/ ديسمبر 1992، وإثر عملية اختطاف وقتل الجندي الإسرائيلي "نسيم توليدانو" بات من الواضح لحكومة رابين أن الاعتقال والملاحقة والقتل لم يعد يجدي في احتواء نشاط حماس العسكري والسياسي أو إخضاعها، وفيما بدا من المستحيل له أن يُلقي بغزة "في البحر"، فقد بدا ممكنًا أن يجمع قادة حماس ويُلقي بهم بعيدًا عنه.
وكان ذلك عند أول الحدود اللبنانية في محاولةٍ لإخراجهم من فلسطين مرةً وإلى الأبد، لكن عامًا كاملًا جمع أكثر من 415 ناشطًا في حماس والجهاد الإسلامي في مكانٍ واحد، أتاح لهم فرصةً -كانت حينها لا تتكرر إلا في السجون- لصياغة الأسس والثوابت والمستقبل، وتبادل الخبرات، والانطلاق في الميادين الدولية والأممية والعربية، وتلمس الفجوات بين الضفة والقطاع، بين المفكر والمقاتل، بين العامل والمتعلم، وتجسيرها تمهيدًا لانطلاقة أخرى.
في الواقع، فرغم مرارة تجربة "إبعاد مرج الزهور"، إلا أنها كانت مفصلية وتاريخية في مسار الحركة، أولًا لأنها أبرزت الحركة على المستوى الدولي وفرضتها كأمرٍ واقع لا يمكن تجاهله، ثانيًا لأنها أطلقت نوعًا جديدًا من العلاقات القائمة على المصلحة المشتركة في استمرار المقاومة ومنها العلاقة مع حزب الله، ثالثًا لأنها كانت اختبارًا فلسطينيًا ذاتيًا للمقاومة نفسها، وإمكانية فنائها أو استمرارها أو تجددها بانفصالها عن أرضها أو التصاقها فيها.
فبعد عقدٍ كاملٍ من الإبعاد ترجم المبعدون تأثيرهم سياسيًا وعسكريًا وفكريًا في كلٍ من انتفاضة الأقصى2000، والانتخابات البرلمانية والبلدية الفلسطينية 2006، وساحات المواجهة والمقاومة خارج فلسطين إبان طوفان الأقصى 2023، حين اشتعلت بجهود إعدادٍ متواصلة من مبعدين سابقين من بينهم الشهيد عزام الأقرع.
حماس بين كرسي التعذيب وكرسي السلطة
بعد عامٍ من الإبعاد اضطُرت حكومة الاحتلال لإعادة المبعدين إلى داخل حدود فلسطين، بعضهم عاد إلى الأسر وآخرون إلى بيوتهم، لكن واقعًا آخر كان قيد التشكل والتأسيس بانتظارهم جميعًا، ففي أيلول/ سبتمبر 1993 وقّعت منظمة التحرير اتفاقية أوسلو مع الاحتلال، لتُصبح السلطة الفلسطينية المشكلة من أفراد المنظمة – غالبيتهم من حركة فتح- مخولةً بحكم الفلسطينيين في المساحة الجغرافية الممنوحة من قبل الاحتلال، وهو الأمر الذي وضع السلطة الجديدة، التي جاءت بالتزامات أمنية، في مواجهة الحالة الجهادية الموجودة بفلسطين.
أطلق دخول السلطة الفلسطينية قطاع غزّة، ثم تاليًا عدد من مراكز المدن في الضفّة الغربية، بعد إعادة قوات الاحتلال انتشارها، موجة احتكاكٍ سريعة بينها وبين الحركة التي كانت تُدير ميادين المقاومة الشعبية في انتفاضة الحجارة، وتطور عبواتها وعملياتها، ليتحوّل الموقف إلى صدام، كانت أبرز ملامحه الأولى مجزرة مسجد فلسطين، حين أطلقت قوات السلطة الفلسطينية النار على متظاهرين فلسطينيين في الثامن عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 1994، وسط مدينة غزة أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيًا وجرح أكثر من 200.
وفيما سُجلت المواجهة باعتبارها أول خيطٍ للدم يرسم العلاقة بين حماس والسلطة التي تقودها فتح، اتسع المجرى بموجات اعتقالٍ طالت نشطاء ومؤيدين للحركة ومعارضين لنهج السلطة، وسلسلة ملاحقات أمنية للمقاومين والفدائيين، أسفرت بعضها عن تسليم مقاومين للاحتلال، أو عمليات اعتقالٍ وملاحقة مشتركة، أو تنفيذ عمليات تصفية بحق المقاومين لصالح الاحتلال نفسه.
فخلال الفترة الفاصلة ما بين منتصف 1994 حتى 2000، أقدمت أجهزة السلطة على اعتقال أكثر من 3 آلاف ناشط في الحركة من بينهم قادة الصف الأول مثل محمود الزهار وعبد العزيز الرنتيسي وجمال منصور وجمال سليم، وأخضعتهم لعمليات تعذيبٍ وعزلٍ انفرادي، كما أغلقت جمعيات ومؤسسات اجتماعية وإعلامية وخيرية للحركة، وفرضت على الشيخ أحمد ياسين الإقامة الجبرية، وأطلقت أحكامًا بالإعدام بحق مقاومين فلسطينيين من بينهم رائد العطار ، ومنعت أي حراكٍ جماهيري رافض لاتفاقية أوسلو وللتنسيق الأمني، وانخرطت في صدامات دموية متعددة مع المقاومين والمعارضين على حدٍ سواء.
ولم يخفف من سلوك السلطة القمعي إلا اندلاع انتفاضة الأقصى نهاية عام 2000، والتي أتت بشكلٍ مفاجئ فرض على المجتمع الفلسطيني والسلطة الفلسطينية إعادة ترتيب في المواقف والأدوار، فتراجعت حدة الملاحقة دون أن تختفي، وظهرت لجان التنسيق الفصائلي لفعاليات الانتفاضة، وفيما حاولت قيادة السلطة -ياسر عرفات حينها- استخدام أوار الانتفاضة ورقة ضغط لصالحه في مواجهة الاحتلال، وجدت فيها حماس فرصةً لإعادة ترتيب صفوفها وإطلاق عملها المقاوم على أشده من جديد.
تمثل ذلك بتفعيل جميع أدواتها التقليدية في الانتفاضة الأولى، من العمل الجماهيري والشعبي والمسيرات والمظاهرات، إلى انتهاج مختلف أساليب المقاومة، ما بين الحشد نحو نقاط الاشتباك، وتنفيذ العمليات التفجيرية، واستهداف المستوطنين في المستوطنات والطرق الالتفافية.
والتوسع نحو أدواتٍ أكثر حداثة، من خلال اقتحام المستوطنات، وتطوير صناعة الصواريخ محلية الصنع، والتفاعل مع الأذرع العسكرية لمختلف الفصائل الفلسطينية، وتقديم خطاب سياسي وفكري ومقاوم قادرٍ على ملامسة الحشود والتأثير فيها وهو ما وضع قادتها في المكتب السياسي في بؤرة الاستهداف والاغتيال الإسرائيلي تمامًا كقادة العمل العسكري المقاوم.
ترافق ذلك مع أداءٍ نوعي خلال الاجتياح الإسرائيلي للمدن الفلسطينية وخاصةً في كلٍ من جنين ونابلس، فقد برزت خلايا كتائب القسام في تصديها لقوات الاحتلال وتنفيذها عددًا من الكمائن النوعية، علاوة على المزيد من القتلى والخسائر نتيجة العمليات الاستشهادية ما بين 2001-2005.
وبالرغم من كم التضحيات الكبير الذي قدمته الحركة خلال الانتفاضة وحجم النزيف في صفوف نشطائها وقياداتها ما بين اعتقالٍ واغتيالٍ، إلا أنها أثبتت قدرة على تطويع الميدان والتعامل مع متغيراته، وفهم منحنيات السياسة والمقاومة وتجديد دمائها بسرعة.
ما أهلها للخروج من انتفاضة الأقصى بذهنية قادرةً على حصاد المكتسبات والاستفادة منها، تزامن ذلك مع قناعة الاحتلال بالحاجة للفصل لتحقيق الأمن والسيطرة، وهو متغير نادرٌ في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، فأٌقرت خطة الانسحاب من غزة عام 2005.
ومع تراجع زخم الانتفاضة العسكرية وتغير القيادة الحاكمة للسلطة الفلسطينية بوفاة ياسر عرفات وتصدر محمود عباس للمشهد، كانت الظروف السياسية قد هُيأت لتجديدٍ سياسي فلسطيني يمنح الشرعية لعباس، ويعيد تفعيل المجلس التشريعي بما يضمن إعادة الدعم والتمويل الدولي والاعتراف الإسرائيلي، فانطلقت سلسلة مباحثات فلسطينية داخلية تكللت باتفاق القاهرة 2005، الذي انطلقت في إثره عملية انتخابات شاملة، بدأت بالانتخابات الرئاسية، ثم المجالس المحلية والبلديات وأخيرًا المجلس التشريعي.
وفيما نأت حماس بنفسها عن الأولى تقدمت للثانية، ثم انغمست بالثالثة بقائمة انتخابية حملت اسم "التغيير والإصلاح" عبرت من خلالها عن استعدادها للدخول في النظام السياسي الفلسطيني وتغيير زواياه، وإصلاح إرثٍ متطاول من الفساد والاحتكار السياسي والقانوني والاقتصادي لم يحقق للفلسطينيين حُلم الدولة، ولا حُلم الاستقلال، فضمت في قائمتها أبرز العقول والمفكرين، واحتوت النساء والطوائف الدينية الأخرى، منطلقةً في محطةٍ جديدة رأت نفسها تعيد مأسسة البلديات والمجالس، وتقف في وجه التفاوض والتنازلات، وتلاحق الفاسدين والمحتكرين، وتعيد ترميم المجتمع الفلسطيني على أرضية من التعددية والتنوع.
لكن محطة حماس كانت مفصلًا يتغير المسار بعده، بتجاوز المأمول والمتوقع إثر تقدمها في المجالس المحلية والبلدية وحصولها على ربع المجالس، وبعض من كُبرى البلديات في الضفة والقطاع، ومن ثم فوزها الساحق في الانتخابات التشريعية بـ 74 مقعدًا من أصل 132 في المجلس التشريعي، وهو ما وضع السلطة الفلسطينية وقيادتها ومنظمة التحرير ومجالسها والمجتمع الدولي وديمقراطيته والأنظمة العربية، في موقف مأزوم.
فالنتائج تتجاوز إجماعهم على شكل النظام السياسي الفلسطيني؛ الذي كانوا يرجونه بحيث تحتفظ فيه حركة فتح بالسلطة والقدرة على التنسيق الأمني والتفاوض، فيما تُمارس بقية الأحزاب معارضة شكلية تقتصر على قضايا حقوق الإنسان والاقتصاد والحريات، دون قدرةٍ حقيقية على التغيير.
وعلى مدى عامٍ وخمسة أشهر من نتائج الانتخابات، انطلقت عملية ابتزازٍ سياسي واقتصادي واجتماعي متكامل للحركة، بدأت بسحبٍ سريعٍ للصلاحيات من جسم الحكومة لصالح جسم الرئاسة، وبتمردٍ داخلي من الأجهزة الأمنية والموظفين الحكوميين على الحكومة الجديدة، وبنأي فصائلي شامل عن المشاركة في حكومة حماس، ثم بالحشد المكثف عربيًا ودوليًا وفلسطينيًا لإفشال الحكومة أو إخضاع الحركة للالتزام باتفاقات منظمة التحرير واعترافها بالاحتلال ونبذها للمقاومة، بالحصار المالي والسياسي، والتهديد والاغتيالات المنظمة.
وما بين وثيقة الأسرى 2006 التي أطلقتها قيادات الأسرى الفلسطينيين لوقف الانقسام السياسي، والوساطة القطرية، واتفاق مكة بوساطة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز وما نتج عنه من تشكيل حكومة وحدة وطنية، كان الانقسام يزداد ترسخًا أمام رفض السلطة التسليم بنتائج الانتخابات ونقل السلطة، ورفض المجتمع الدولي والعربي قبول حكومة حماس إلا بالتخلي عن مقاومتها، وهو ما دفعها لتأسيس كيانات مساندة من بينها القوة التنفيذية التي أسسها وزير الداخلية سعيد صيام ردًا على رفض الأجهزة الأمنية الفلسطينية تسليم مقاليد الحكم له، ثم ترك حماس أمام مفترق طُرق في مقابل تصاعد الاغتيالات والتحريض، ما دفعها لتأكيد سيطرتها بحسم قطاع غزة لصالحها منتصف 2007.
وقد تعددت جلسات الحوار والتفاهمات التي جرت بعد هذا التاريخ بين كلٍ من فتح وحماس كما في (2009، 2010، 2011، 2014، 2017) وكثرت محاولات ومقترحات تشكيل حكومات وحدة وحكومات توافق وحكومات تكنوقراط، إلا أنّ التباين البرامجي بين الحركتين، والشرط الدولي والإقليمي منع حركة فتح والسلطة من إنجاز اتفاق حقيقي.
بدا وكأنّ حركة حماس قد اقتنعت بأن البرغماتية والحلول الوسطى لن تغير من رفض المجتمع الدولي والأنظمة العربية لها ما لم تغير مسارها وأصل وجودها، وهي بذلك تنحو نحو الفناء، وفي المقابل فإن السعي لإقناع فتح والسلطة بالتراجع عن المفاوضات وأوسلو لن يكون مجديًّا، لتمسكهما بمكتسبات النفوذ والاقتصاد لنخبتهما حتى لو كان ذلك على حساب مشروع وطنيّ جدّي.
في المحصلة، فإن ارتدادات ما بعد الانتخابات محليًا وعربيًا ودوليًا تركت أثرها عميقًا على استراتيجيات الحركة وفكرها، فقد ازداد إدراكها أن جناحها العسكري هو الأقدر على تغيير الموازين والحسابات، فأطلقت العنان لطاقات تحديثه وتطويره، وأفرزت سيطرتها على الأرض حرية في حماية السلاح وأهله، وقدرة على هيكلته بما يحوّله من مجرد خلايا إلى كتائب وألوية ووحدات متعددة المهام والخبرات.
كما تعزز إدراكها لأهمية أذرعها الاجتماعية والجماهيرية والميدانية في إسنادها وتعزيز موقعها، وأن تطوير خبرتها على المزامنة بين المحلي والدولي والسلاح والسياسي ضرورة، وأن الخبرات والكفاءات في مختلف المجالات السياسية والقانونية والإعلامية والاقتصادية والطبية حاجة مرتبطة بتفوق أدائها وخطابها وقدرتها على الاختراق والتأثير.
وبرغم الصدمة الكبيرة التي تركها رد الفعل على تصدرها الانتخابي والهجوم الواسع الذي نال من سلاحها ووجوهها وناشطيها وساحاتها، إلى أنها لم تتراجع عن أهمية وجودها ومشاركتها في الفعل السياسي الفلسطيني بكل الأوجه والأشكال، بل وأعدت نفسها مرارًا وتكرارًا لوعود الانتخابات بكل عزيمة، وذخرت قوائمها بالشباب والنسوة والفاعلين والمؤثرين دون أي انحسار.
من الميدان إلى الطوفان
مع منتصف 2007 وصل الوضع الفلسطيني الداخلي إلى حافته الأخيرة، سيطرت حماس على قطاع غزة وأدارت شؤون سُكانه، فيما سارعت السلطة الفلسطينية بتعزيز الانفصال فقطعت علاقتها بالمؤسسات والدوائر الحكومية في القطاع، واحتكرت الشرعية لنفسها، ومارست -مدعومةً بإسرائيل وأمريكا والنظام العربي والمجتمع الدولي- مختلف أنواع الحصار الاقتصادي والصحي والغذائي والسياسي بحق سُكان القطاع في محاولةٍ لدفعهم للتمرد على الحركة، وربما إنهاء وجودها.
في المقابل بدأ جيش الاحتلال في استهدافٍ متواصل لعمق القطاع ومقاومته في مناسباتٍ مختلفة، بدءًا من 2008، و2009 ولم تفلح محاولات التهدئة وإرساء هدنٍ في الحفاظ على الجبهة منطفئة، لا سيما وأن المقاومة كانت ما تزال محتفظة بالجندي الأسير جلعاد شاليط -اختطفته في 2006- في حوزتها رافضةً تسليمه إلا بصفقة تبادل.
مع 2011، كانت حماس تعود إلى الضفة الغربية من الباب الموارب، وتعيد لشعبيتها الجماهيرية سيرتها الأولى، فرغم حملات الاعتقال والهجمة الشرسة من الأجهزة الأمنية على أبنائها إثر الانتخابات وما رافقها من حسمٍ عسكري، إلا أن صفقة وفاء الأحرار التي بادلت فيها الحركة 1027 أسيرًا فلسطينيًا بشاليط، من مختلف الفصائل والتيارات الفلسطينية قد أكدت أن مفهومها للوحدة يتجاوز المحاصصة السياسية والدوائر الحكومية.
تزامن ذلك مع ثورات الربيع العربي التي دفعت السلطة للتشديد على الحركة وخنق أنشطتها في الضفة خوفًا من ثورةٍ مشابهة، وبينما كانت الحركة أول المستفيدين من الربيع والحرية، وأتيح لها بعد سقوط نظام مبارك في مصر مساحات من الحرية خففت من وطأة الحصار، وإسنادًا سياسيًا وجماهيريًا حقيقيًا من قيادة مصر الجديدة، ظهرت آثارها خلال حرب عام 2012 التي توقفت بعد ثمانية أيام، فقد أعلن الرئيس المصري محمد مرسي سحب سفير بلاده ودعا لعقد اجتماعٍ عاجل لمجلس الأمن الدولي واجتماعٍ آخر لجامعة الدول العربية، وأرسل الوفود الرسمية والطبية لتخفيف آثار العدوان.
لكن الإسناد لم يطل والمكاسب لم تدم، بل على العكس فمع موجة الثورات المضادة دفعت الحركة أثمانًا باهظة، تمثلت بانحسارٍ لوجودها السياسي، وتجريمٍ لأي تعاطفٍ أو علاقة معها، وتدهورٍ في علاقاتها بعددٍ من الدول العربية مثل مصر والسودان وليبيا وسوريا، بينما جاهرت أنظمة أخرى بعدائها للحركة ولاحقت ناشطيها مثل الإمارات والأردن والمملكة العربية السعودية.
وهو ما ظهرت نتائجه في حرب عام 2014، التي ظهرت حلقةٍ في سلسلة الثورات المضادة، فدامت لخمسين يومًا، وأوقعت أكثر من ألفي شهيد و10 آلاف جريح، وعبرت عن موقفٍ فلسطيني وعربي شديد البرودة، محدود الحراك، وخاليًا من التعاطف، فقد حافظت الأجهزة الأمنية الفلسطينية على قبضة حقيقية تمنع الضفة من التصعيد والانغماس في التضامن والاحتجاج الشعبي، وتجاهلت حكومة الوفاق -حديثة التكوين حينها- إلحاح الحاجة الطبية والمعيشية لسُكان القطاع، فلم يتوجه أي من وزرائها إلى غزة، ولم تُعلن حالة الطوارئ إلا بعد ثلاثة أيام، ولم تُقدم على صرف أي من الرواتب المتأخرة.
أما عربيًا، فقد برزت الحرب فرصةٍ سهلة أتاحت للأنظمة العربية الانتقام من العلاقة الوثيقة بين حماس والإخوان المسلمين، فساد الصمت العربي والتجاهل وقمع حركات التضامن الشعبية، وأما على المستوى الرسمي فاكتُفي باجتماعٍ للوزراء العرب في باريس، دون أن يُسفر عن تحركٍ حقيقي.
البون الواسع في التفاعل والتضامن رسميًا وشعبيًا، عربيًا وفلسطينيًا بين حرب 2012 و2014، دفع حماس لإعادة النظر في مسار علاقاتها الإقليمية، بدأ من النأي بنفسها عن التغيرات الداخلية في المنطقة (سوريا ومصر والأردن..)، ثم بإصدار وثيقة سياسية جديدة لم تنصّ على علاقة الحركة بالإخوان المسلمين، علاوة على صعود قيادة جديدة أفرزتها انتخاباتها الداخلية محملةً بسعي كبير لقطع خطوات هائلة على طريق المصالحة مع فتح سمحت من خلالها لوزارات السلطة في الضفة الغربية باستئناف العمل من قطاع غزة بعد عقدٍ من الانقسام.
مثّلت تلك المرحلة مفصلًا آخر في العقل السياسي لحماس وقدرة متوازنة على تفكيك العلاقة مع مكونات النظام العربي بالفصل بين الأنظمة في خضم علاقاتها مع "إسرائيل" وارتباطها بالقضية الفلسطينية، وهو ما عنى أيضًا إعادة صياغة علاقتها مع مصر بوصفها الجانب الآخر من الحدود أولًا، والوسيط الدائم ثانيًا، والحليف لـ "إسرائيل" في ضوء كامب ديفيد ثالثًا.
هذه الخطوات لاقت صدىً في القاهرة حيث فُتح المجال المصري أمام زيارة قادة في المكتب السياسي والعسكري لحماس إلى القاهرة، لكن سعي حماس إلى تجديد علاقاتها بكلٍ من السعودية والأردن والإمارات باء بالفشل بالتزامن مع استمرار حملة المقاطعة على قطر وشيطنة إيران وحلفائها، ووصول ترامب إلى سدة حكم الولايات المتحدة مع حزمةٍ من اتفاقيات التطبيع الإبراهيمي، وفي ظل وجود بديلٍ فلسطيني أقرب إلى الأنظمة العربية هو السلطة الفلسطينية.
داخليًا لم تغير البرغماتية بكثيرها أو قليلها من موقع الحركة، بل بقي الحصار الإسرائيلي قائمًا، وتعمق الانقسام بسياسات السلطة وأجهزتها الأمنية وملاحقتهم المقاومين وتسليمهم، وغدت الحركة في المنتصف بين أكثر من مليوني فلسطيني يخنقهم الحصار وابتزاز السلطة والاحتلال لهم، وإمعان الأنظمة العربية في التضييق عليهم، وبين مشاريع التوسع والاستيطان والضم في الضفة الغربية، وتهويد المدينة المقدسة وتقسيم الحرم المقدسي والاعتداء على المرابطات، وتهجير الفلسطينيين من القدس، والكثير من الانتهاكات الإسرائيلية التي وقفت السلطة أمامها متفرجة متراجعةً حتى عن استخدام المقاومة الشعبية أو القانونية أو السياسية للوقوف في وجهها.
وبالتزامن مع اندلاع انتفاضة السكاكين عام 2015، كانت الحركة قد انخرطت في التفاعل مع قضايا الضفة من خلال سلاحها ومقاومتها، فأسندت الانتفاضة بصواريخها، وردت على الهجمات الجوية الإسرائيلية بالمثل، ومع 2018 أدخلت سلاح مسيرات العودة والبلالين الحارقة في أجندتها، وبرغم أعداد الشهداء والجرحى إلا أنها استطاعت هدم الأسوار النفسية بين المحتل والإنسان الغزّي وأعادت المواجهة بينهما إلى ساحتها الفاصلة، كما تمكنت من الضغط على الاحتلال لتخفيف المعاناة المعيشية لسكان غزة، وأعادت حق العودة إلى واجهة الاهتمام العالمي والعربي.
مع 2021 استعادت الحركة مكتسباتها قبل الانقسام، وقدمت إثباتًا جديدًا على مسارها ونهجها ووحدتها، مثبتةً أنها "سيفٌ" مسلط على رقبة الاحتلال، ومؤسسة لقواعد جديدة تربط بها بين القدس وغزة وتوحد الشعب الفلسطيني في ساحة واحدة أمام المحتل، ملبية نداء مرابطات وحرائر القدس، فانخرطت في معركة "سيف القدس" بالتزامن مع ثورة اللد وحراك القدس في مواجهة صاروخية مع المحتل، محددة موعد المواجهة، وهدفها وساعة انطلاقها، ومنذرةً بالمزيد لوقف الاقتحامات والاعتداءات على حي الشيخ جراح في القدس، ومنسجمةً مع كيانية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948 والشتات.
ورغم أن المعركة لم تدم أكثر من 10 أيام، إلا أنها كانت ركيزةً لما بعدها، وتجربةً أولية لمعارك أكبر تخوضها الحركة مواجهةً مساعي اجتثاثها وإبادتها، كما كشفت تنسيقًا متطورًا بين أذرع الحركة السياسية والعسكرية، وقدرةً على التفاعل مع الحدث وتصديره دوليًا والاستفادة منه في تحقيق اختراقات على الحصار المتواصل.
في الواقع، فإن التأمل في السنوات الست الأخيرة، حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يلحظ بأن الخطوات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية التي اتخذتها الحركة، والحروب التي خاضتها وتلك التي تأخرت عنها، والساحات التي اخترقتها وتلك التي تجاهلتها، كانت جميعها تصب في لحظةٍ واحدة، هي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وطوفان الأقصى.
فمسيرات العودة التي انطلقت ما بين 2018 حتى نهاية 2019 كانت بمثابة اختبارات متواصلة للحدود والتحصينات والحاضنة الاجتماعية والعمق النفسي، ونتائجها أسهمت في مزيد من التركيز على التطوير العسكري والتخفف من حمل الإدارة الخدماتية، ومعركة سيف القدس كانت "بروفا" جوية لطوفان الأقصى، وللقدرات الصاروخية، وحقيقةً راسخة لوحدة الساحات لا يمكن إغفالها، والحراك الجماهيري في الشتات كان تعبيرًا عن إرادة الفلسطينيين وروح الحركة.
حتى أتى الطوفان، صباح يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر2023 معلنًا عن واقع جديدٍ لحماس، وخلاصةً لأكثر من ثلاثة عقودٍ في الفكر والحشد والتعبئة، في السجون والأنفاق والشتات، مذيبًا الحدود والحواجز بين الفلسطيني وأرضه وموحدًا الفلسطينيين خلف المقاومة وإنجازاتها، حين اجتاز مقاتلو النخبة عبر السيارات رباعية الدفع والدراجات النارية والطائرات الشراعية الجدار الالكتروني الفاصل وألغامه، تحت مظلة أكثر من 5 آلاف صاروخٍ صوب مختلف المستوطنات الإسرائيلية في الجنوب والشمال والشرق.
في الطوفان حررت المقاومة الأرض في دقائق، وسيطرت على المواقع العسكرية لأكثر من يومين، وأسرت أكثر من 200 مستوطن، وغنمت الآليات والمركبات، وأصبح بإمكان الفلسطينيين تخيل حريتهم ومقاومتهم وصمودهم.
حماس المستقبل
لا يمكن اختصار الطوفان بالكلمات، لا يتعلق الأمر بلحظة العودة ولا بما تلاها من لحظات الإبادة التي لم تنتهِ بعد أكثر من 14 شهرًا، والتي طبعت الحرب الإسرائيلية المعززة أمريكيًّا على غزّة، ولا بأوجاع التواطؤ العربي والتآمر الفلسطيني والخذلان الدولي والأممي، تمامًا كما لا يمكن صياغة توصيف لبهجة الطوفان فلم يعد ممكنًا بعد أكثر من 44 ألف شهيدٍ فلسطيني في قطاع غزة وحده بعد عامٍ من الطوفان توصيف أي شيء.
في اللحظات الأولى من الطوفان خرج محمد الضيف داعيًا الفلسطينيين والعرب لانخراطٍ واسع في الطوفان، طرح الضيف الأسباب والأهداف؛ تهويد القدس والاستيطان والأسرى والضم والكثير من جرائم الاحتلال، وخاطب جماهير الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم، توجه إلى الشباب في الضفة والقدس والداخل داعيًا إياهم لتصحيح المسيرة والعودة لمشروع التحرير والعودة وإنهاء التنسيق الأمني وهدم الجدران العازلة.
وعلى مدى عامٍ كامل خرج الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام مخاطبًا "أبناء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم"، لكن استمرار الإبادة الجماعية بكل أشكالها الصحية والتعليمية والزراعية والثقافية بحق الفلسطينيين حتى اليوم يُثبت أن الاستجابة للمقاومة لم تكن كما يليق بتضحياتها.
بل تداعى العالم لإدانة حرية الفلسطيني وفعله المقاوم وتقديم فروض الولاء والامتنان لقاتله، وتسيير الجسور العسكرية والاقتصادية لإنقاذه ودعمه وإسناد وحشيته، وأطلق التحالفات لخنق الساحات المناصرة في لبنان وسوريا والعراق واليمن، وتجاهل الأسلحة المحرمة دوليًا والإجرام والترويع واستهداف الأطفال.
اليوم تقف حماس في ذكرى انطلاقتها الـ37 متجاوزة سؤال البقاء والفناء الذي كان حاضرًا بقوة في عامها الـ36، فرغم التضحيات الكبيرة والخسارة لقادتها ومقاوميها في معركة طوفان الأقصى إلا أنها لم تُسلم ولم تتراجع ولم تتوقف خلاياها في القطاع والضفة الغربية عن مواصلة المقاومة، ولم تُسلم الأسرى، وما زال خطابها واحدًا "نصرٌ أو استشهاد" وما زالت خلاياها تُهدي عمليات المقاومة لمن سبقها من المقاومين والشهداء.
في الحقيقة، فإن حماس أثبتت أن الطوفان ضرورة واجبة وأنه تطورٌ آخر لانتفاضات الشعب الفلسطيني وجزء من مسيرة الحرية، وما لم ينته الطوفان بالحرية فإن طوفانًا آخر سيأتي، وأثبتت أيضًا أن نقطة ضعفها هي أوجاع شعبها وخساراته وأن الخذلان العربي والفلسطيني هو المقتل.
في المقابل أثبت الطوفان أن حماس ليست مؤسسةً يمكن هدمها، ولا حزبًا يمكن حله، بل إن مقاومتها عقيدةٌ راسخة في قلوب الفلسطينيين يجري التعبير عنها بأشكالٍ مختلفة طالما تصب جميعها في سياق الحرية والمقاومة، والحال كذلك فلا الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل بإمكانه تطويع حماس أو تدجينها.
ومهما تضاءلت القدرات العسكرية وارتقى من قادة ومقاومين، ومهما حرثت صواريخ الاحتلال أرض فلسطين وروح شعبها، أو انكفأت الأنظمة العربية والإقليمية عن حماس وقادتها، فالسكين موجود، والبلطة موجودة، وما تيسر من غضبٍ يكفي لبدايةٍ جديدة حتى الحرية.
