في البحث عن القتال الفلسطيني: الرؤية المؤسِّسة وتكتيكات الميدان

على سبيل التقديم..
تأتي هذه المادة مباشرة عقب معركة (3 تموز) في مخيم جنين، لتلقي نظرة على التاريخ الكفاحي للفلسطينيين، والعقبات الموضوعية التي واجهت مساعي الفلسطينيين لتأسيس حرب عصابات من داخل الأرض المحتلّة، تتمدّد على طريق التحرير الشامل. تنظر المادة في فكرة اتخاذ المخيم نقطة ارتكاز أو ملاذًا آمنًا، فما العقبات التي واجهت هذه الفكرة؟ وما العقبات التي تواجه الأفكار الأخرى التي فضّلتها قوى أخرى؟ وما السبيل إزاء هذه العقبات الثابتة في السياق الفلسطيني الطويل؟
التحرير
في فلسطين، وبقدر ما يمكننا الحديث عن البدء من الصفر في استعادة حالة المقاومة، فليس بمقدورنا في الوقت نفسه الحديث بكلّ هذه الصرامة عن بداية من الصفر. ليس الأمر أحجيةً، وإنما هذه، في المجمل من طبائع المقاومة التي لا تملك نقاط ارتكاز ولا جغرافيا منفصلةً عن قدرة العدوّ المباشرة، وإذا كانت هذه هي طبيعة المقاومة في ظروف كهذه، فإنّ هذه الطبيعة في فلسطين آكد، وإذا أمكن للمقاومة في قطاع غزّة تجاوز هذه الطبيعة، لأسباب سياسية وتاريخية، فإنّ الأمر ليس كذلك في الضفّة الغربية.
تطلّع الفلسطينيون دائمًا إلى مقاومة شعبية راسخة في مدنهم وقراهم وجبالهم وأوديتهم، وقبل الحديث عن تأثّرهم في ستينيات القرن الماضي بنظريات "حرب الشعب"، أو "حرب التحرير الشعبية"، فقد كانت لهم تجربتهم الخاصّة في الثورة الفلسطينية الكبرى، إبّان الانتداب البريطاني (1936 – 1939)، وهي الثورة التي بنت، في جانب منها، على محاولة الشيخ عزّ الدين القسام، التي انتهت سريعًا في أحراش يعبد في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1935.
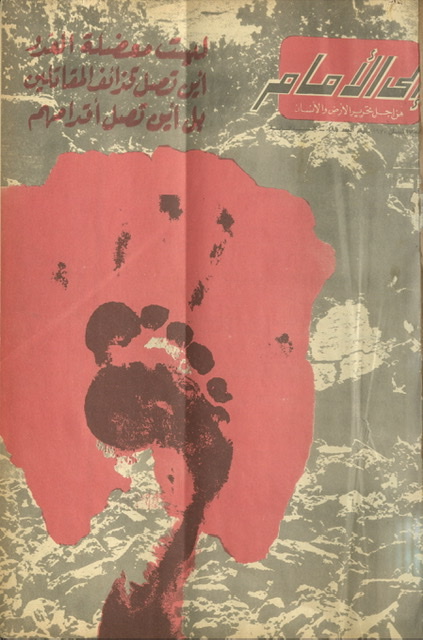
صورة لغلاف عدد من مجلة "إلى الأمام" التي كانت تصدرها الجبهة الشعبية- القيادة العامة
عن لحظة الثورة الكبرى
كانت الثورة الفلسطينية الكبرى بدايةً جديدةً بالكامل، لكنها متصلة تمام الاتصال بما سبقها من نضالات الفلسطينيين، وبتجربة الشيخ القسام على وجه التحديد، لا ينبغي أن يفوتنا، والحالة هذه، أنّ حركة حماس حينما أطلقت اسم الشيخ القسام على جناحها العسكري كانت تستأنف، هي الأخرى، بدايةً جديدةً بالكامل، ولكنها متصلة تمام الاتصال، لا بكلّ ما سبقها من قريب فحسب، بل حتى بذلك التاريخ العريق في النضال.
المفارقة واضحة في تمثّلات الوعي، بين تجربة الشيخ القسام التي انتهت في أحراش يعبد، وبين استئناف الثورة التي ساهم في إطلاقها وفي مدّها أكثر للأمام بعض رفاق الشيخ القسّام، كالشيخ فرحان السعدي، وعطية أحمد عوض، ومحمود سالم المخزومي، ومحمد صالح الحمد، وأبو إبراهيم الكبير، وغيرهم الكثير، فالذين استشهدوا في يعبد خمسة منهم القسام، من بين 200 منظَّم في مجموعته يدعمهم 800 نصير، هذا الاستشهاد السريع للشيخ القسام، صاحب الفكرة وقائد التنظيم، لم يقيّد الوعي بإمكان استئناف الثورة، التي خدمتها ظروف زمانية لم تتكرّر فيما بعد، من قبيل أعداد الفلسطينيين السكان الأصليين، والتي تقلّصت لاحقًا بعد النكبة، والانتداب البريطاني المختلف في جوهره وأغراضه عن الاستعمار الصهيوني، ووحدة الأرض والشعب التي تمزّقت تاليًا بعد النكبة، ومحدودية التقنية من أدوات قتل وضبط وسيطرة عمّا صارت إليه اليوم، ومع ذلك كان عمر تلك الثورة ثلاث سنوات متقطّعات.
صحيح أنّ قوى الثورة الفلسطينية من بعد النكبة، تأثّرت بالتجارب الثورية العالمية والعربية، كالماوية والفيتنامية والجزائرية، لكنّ الثورة الفلسطينية الكبرى ظلّت حاضرةً في الوعي، ولاسيما من بعد هزيمة العام 1967، حينما بدأ التفكير بالتأسيس لنقاط ارتكاز داخل الأرض المحتلة للتوّ.
في البحث عن نقطة ارتكاز
بعد هزيمة العام 1967، عمل وجيه المدني قائد جيش التحرير الفلسطيني، وأحمد الشقيري رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على إنشاء مراكز سرّية للمقاومة داخل الضفّة الغربية وقطاع غزّة، تتولّى التجنيد والتدريب وتخزين الأسلحة والمؤونة إلى حين توفّر الفرصة المناسبة لإطلاق ثورة مسلحة، وهي المحاولة التي فكّكها سريعًا الاحتلال الإسرائيلي الناشئ حديثًا في هذه المناطق، تلا ذلك محاولات حركة فتح في العام 1968 لتأسيس نقاط ارتكاز لها في الضفّة الغربية المحتلّة بالكامل من الاحتلال الإسرائيلي، إلى درجة أن الحركة في مطالع ذلك العام قالت إنّها انتهت من نقل جميع قواعدها العسكرية إلى داخل الوطن المحتلّ، كان ذلك في كانون الثاني/ يناير، لكن ما أن بلغت المواجهة منتصف آذار/ مارس، حتى كان الاحتلال، قد فكّك جميع تلك البنى العسكرية، باعتقال 200 عنصر من الحركة، من الضفّة الغربية وقطاع غزّة، ولم تكن هذه هي التجربة الأولى لفتح، التي كانت في آب/ أغسطس 1967 قد أعلنت عن بدء عملياتها القتالية في فلسطين، متأثّرةً بتجربة الثورة الفلسطينية الكبرى (1936 – 1939)، ومعتقدةً إمكان التأسيس لتمرّد عام يبدأ بتشكيل شبكات سرّية تمتدّ بتحرير تدريجيّ للمناطق، لكن لم يكن قد مضى شهر واحد حتّى فكّك الاحتلال تلك الشبكات.
كانت هذه التجربة تدفع نحو البحث عن ملاذات آمنة خارج قدرة العدوّ على التحكّم المباشر، الأمر الذي انتهى بالفكر الثوري الفلسطيني بحشد الجسد الرئيس للثورة الفلسطينية في الأردن، بحثًا عن "هانوي" الفلسطينية، في ضرب من المحاكاة للثورة الفيتنامية. وبالرغم من ذلك، ظلّت العودة إلى الأرض المحتلّة ضروريةً، سواء لأسباب سياسية متعلّقة بالتطوّرات في الإقليم أو بالتدافع الداخلي بين القوى الفلسطينية، أو لما يتوفّر من ظروف مشجّعة على التفكير بإمكان الدفع نحو حرب عصابات من الداخل، كما في تجربة الجبهة الشعبية مع محمد الأسود (جيفارا غزّة) في غزّة (1971 – 1973)، أو محاولات فتح في السبعينيات لإحياء مشروع (الدوريات المطاردة) والتي تعني بها مجموعات عسكرية ترتكز في الجبال، وتقوم بمهمات الدعاية الثورية بين الجماهير.
بغض النظّر عن التباينات المفاهيمية، في المفاهيم نفسها، كحرب الشعب، وحرب التحرير الشعبية، وحروب الغوار، أو التباينات بين قوى الثورة الفلسطينية في تصوّر تلك المفاهيم في ذلك الوقت، فإنّ مشروع التحرير، بداهةً، كان يقضي بأنّ تتحوّل مجموعات الغوار في حرب العصابات إلى قوىً شعبيةٍ متعاظمة قادرة على التمدّد والتطهير التدريجي للعدوّ، وهو ما يعني بالضرورة، أنّ أهم الشروط الأولى في حروب الغوار أن تحافظ المجموعات على نفسها، وتحول دون إبادتها، لأنّ الغوار مجرّد مرحلة في مسار التحوّل نحو جيش التحرير.
ظلّت النظريات الثورية قاصرةً عن الوضع الفلسطيني، من حيث الجغرافيا وعدد السكان الأصليين المحدود بالنسبة للعدوّ، وتفوق العدوّ الكاسح، وممانعة الظروف الطبيعية، فلا الجبال ولا الغابات متوفّرات على النحو المطلوب، وهو الأمر الذي بقي محل سجال طويل في التاريخ الكفاحي الفلسطيني.

أحد أعداد نشرة العاصفة التي كانت تصدرها حركة فتح (1967)
في البحث عن الرؤية .. ماذا نريد من قتالنا؟
كان ينبغي أن يَطرح هذا الأمرُ تحديدًا التكيّفَ المناسب لحرب عصابات في فلسطين، لاسيما بعدما صارت الأرض المحتلّة هي الميدان الوحيد للالتحام بالعدوّ بعد خروج قوات الثورة الفلسطينية من لبنان، إلا أنّ البحث في التكييف المناسب للفعل الثوريّ نفسه غير ممكن دون التقعيد لمعنى القتال ووظيفته في سياق مشروع التحرير، فإنْ قلنا إنّ هدفنا هو تحرير فلسطين، فهل يمكن ذلك بقتال عصابات من الداخل؟ أي هل يمكن لنا توفير الشرط الأساس أصلاً وهو الحفاظ على الجسد الأساسي للمغاوير في الطريق إلى تعظيم هذا الجسد؟ ثمّ هل سيتمتع هذا الجسد بالقدرة على الصيالة، والضرب على طريقة "عض واهرب"، والتمون الدائم، ومن ثمّ القيام بالدعاية السياسية اللازمة بين جماهير الشعب؟! وإن لم يكن هذا ممكنًا ما هو موقع قتال العصابات من داخل فلسطين في رؤية تحرير جادّة؟ أي إلى ماذا ينبغي أن يفضي هذا القتال؟!
بكلمة أخرى، لا بدّ من مشروع سياسي تتأطّر فيه حرب العصابات، فلقد أطلق الفلسطينيون منذ النكبة، مجموعةً من المقولات الكلّية للتعبير عن رؤيتهم، فمن التحرير، إلى حرب الشعب، أو حرب التحرير الشعبية، إلى نظرية التوريط (أي جرّ الدول العربية إلى حرب مع العدوّ بفعل المقاومة الفلسطينية)، إلى تأسيس السلطة المقاتلة وعدّها نواةً للتحرير الشامل، إلى القتال بهدف جرّ العدوّ إلى التسوية السياسية، إلى القتال بهدف الحفاظ على القضية بانتظار التحوّل السياسي في المنطقة والعالم الموفّر لظرف التحرير. يمكن القول إنّ هذه أهمّ الأطر السياسية المختلفة للمقاومة الفلسطينية من بعد النكبة إلى اليوم.
بالرغم من ذلك ظلّ الحلم بتأسيس نقاط ارتكاز في الداخل حاضرًا دائمًا، على تفاوت في الأطر الرؤيوية السياسية التي تقف خلفه. مثلاً في النصف الثاني في تسعينيات القرن الماضي، سعت حركة حماس، مع قائدها العسكري عادل عوض الله، إلى تأسيس أكبر عدد ممكن من الخلايا المسلّحة في الضفّة الغربية لشنّ هجوم في وقت واحد على العدوّ الصهيوني ممّا من شأنه أن يغيّر البيئة السياسية (كانت السلطة الفلسطينية في ذروة قوتها وقتها) نحو ظروف أفضل للتأسيس لمشروع فلسطيني تحرّري، بيد أنّ هذه المحاولة جرى تفكيكها بعد عامين تقريبًا، في وضع كانت فيه حماس تعاني الاستهداف المزدوج حينها من الاحتلال ومن السلطة المحلّية.
في الانتفاضة الفلسطينية الثانية، طرحت أوساط فلسطينية إمكانية تحرير الأراضي المحتلّة عام 1967، بفعل المقاومة الذاتية، وكانت مناطق (أ) في المرحلة الأولى توفّر نقاط ارتكاز أو مناطق آمنةً، وهو الوضع الذي أنهاه الاحتلال في عملية "السور الواقي"، إلا أنّ هذه العملية كشفت عن أنّ حجم المقاومة، من حيث العدد والخطط والعتاد، أقلّ مما يمكن أن يعيق العدوّ، ومن ثمّ كانت عقبة العدوّ الوحيدة وقتها في مخيم جنين، وقد تمكن من تسويتها بقدر أكبر من القصف والتدمير.
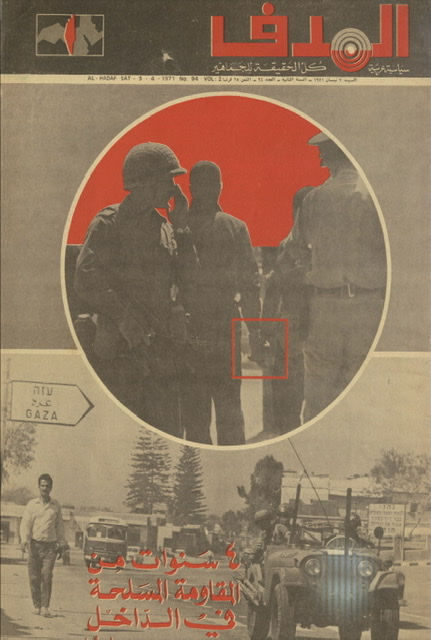
صورة غلاف أحد أعداد مجلة الهدف التي تصدرها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (1971)
غزة .. القدرة ونقيضها
فقط، المقاومة في قطاع غزّة هي التي استطاعت تطوير بناها نحو تشكيلات واسعة أقرب للجيوش النظامية، وذلك بالاستفادة من انتفاضة الأقصى ثم انسحاب العدوّ من قطاع غزّة عام 2005، ثمّ من أحداث العام 2007، حيث استفردت حركة مقاومة كبرى، هي حماس، بإدارة قطاع غزّة، إلا أنّ المعضلة التي واجهت المقاومة من قطاع غزّة، وفضلاً عن الظروف الطبيعية والجغرافيا السياسية، من ضيق المساحة وانبساطها وانكشافها وانعدام الظهير (فالقطاع محاصر حتى من جهة مصر)، هي استحالة الالتحام المباشر بالعدوّ بالقدر اللازم من المناورة والمرونة والاستمرارية، كانت هذه الاستحالة ناجمةً عن الفصل الكامل بين كيان العدوّ وقطاع غزّة.
امتلكت المقاومة في غزّة جملةً من العناصر الضرورية في حرب العصابات، أهمّها توفير الظروف المناسبة للحفاظ على الذات، المقاتل والبنى العسكرية التي يتأطّر فيها، فالمبدأ الموجِّه لأيّ مواجهة عسكرية هو الحفاظ على الذات قدر الإمكان، وإبادة قوات العدوّ قدر الإمكان، وكون المواجهة في فلسطين طويلة الأمد، فإنّ من أهمّ القضايا التالية على النجاح في التأسيس لنقاط الارتكاز، هي القدرة على الدفاع الإستراتيجي العسكري والتعبوي، إلا أن شروط المبادرة والمرونة والصيالة بما يساعد على عمليات استنزاف مستمرّ للعدوّ تبدو معدومةً تمامًا، لحالة الانفصال التام الممانعةِ لقدرة المقاومة على ضرب العدوّ باستمرار، ولقوة النيران الهائلة التي يواجِهُ فيها العدوّ المقاومة، مما يحوّل بيئة الاحتماء، أيّ الاحتماء بالجماهير، إلى عبء على المقاومة نفسها، وهو أمر تساعده حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني، كما يؤدّي إلى سجالات بين قوى المقاومة نفسها حول استراتيجية المقاومة لهذا الظرف الراهن، هل هي المراكمة كما ترى حماس، أم هي المشاغلة كما ترى الجهاد الإسلامي؟ ثمّ المراكمة إلى متى طالما كانت أيّ مواجهة قادمة مع العدوّ تحتكم للشروط الراهنة نفسها؟ ثمّ ما المشاغلة طالما كان العدوّ قادرًا على تحويلها إلى استنزاف معاكس حين النظر كذلك إلى الشروط القائمة؟ يضاف إلى ذلك صعوبة التكامل النضالي بين واقع المقاومة في غزّة، ووقائع المقاومة التي تنشأ في الضفّة.

صورة من مجلة فلسطين المسلمة التي كانت تصدرها حماس (1991)
الضفة .. القتال في شرطٍ مستحيل
لم تتوفّر هذه الظروف للضفّة الغربية، وعلى الضدّ من سياسة الاحتلال بالانسحاب من قطاع غزّة عام 2005، فقد اجتاح الاحتلال مناطق (أ) في الضفة الغربية. وتاريخيًّا كان ينجح الاحتلال في نهاية الأمر في تفكيك الخلايا السرّيّة في الضفّة الغربية، وحتّى في غزّة إلى حين تأسيس السلطة الفلسطينية.
أدّى تأسيس السلطة الفلسطينية إلى واقع مختلف تمامًا، قطع مع الانتفاضة الأولى، المحطّة النضالية الأكبر في توفير وسائل النضال الشامل المستنزف للاحتلال، وصار ثمّة سلطة محلّية محمّلة بالتزامات مضادّة لقضية المقاومة، لينتفي الإجماع نهائيًّا على أدوات النضال، فضلاً عن الافتراق السياسي الأصلي، ولتصير قضية الحفاظ على الخلايا السرية وإمكانية المراكمة عليها مستحيلةً.
بالرغم من ذلك وقبل نهاية الانتفاضة الثانية، أمكن الاحتفاظ ببعض الخلايا إلى أمد معقول، بما يتيح أثناءه الاستثمار في استنزاف العدوّ، وكذلك قبل الانتفاضة الثانية في ذيول الأولى والنصف الأول من تسعينيات القرن الماضي. مثلاً خلية صوريف التابعة لحركة حماس عملت بالسرّ لسنوات لولا انكشافها بسبب خطأ فنّي، وقبل ذلك وبعده، عمّرت كوادر قيادية لفترات طويلة، من أشهرهم اليوم قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف والذي سبق وتنقل بين الضفّة الغربية وقطاع غزّة، إلا أنّ هذه الإمكانيات انعدمت من بعد نهاية انتفاضة الأقصى.
إذا كان التخفّي وسط السكّان، والاستفادة من الهندسة المعمارية للمخيم، هو التعويض الوحيد الممكن عن الظروف الأخرى المنعدمة (كالجبال والغابات)، فإنّ صغر المساحة للضفة الغربية، وأدوات الضبط والسيطرة المطوَّرة (الجدار، والحواجز متعددة المهمات والأنواع، والطرق الالتفافية، والمستوطنات، والمعسكرات، ونقاط المراقبة)، وما ينبني عليها من وسائل مراقبة، مثل الكاميرات فائقة التقنية، بالإضافة لكل ما جدّ من قدرات استخباراتية، بات يصعّب من إمكانيات الاحتفاظ بالخلايا السرّية أطول فترة ممكنة، أو من تحويل المخيم إلى نقطة ارتكاز.
تكشف العمليات النوعية التي نفّذت في السنوات الأخيرة، سواء كانت ذاتية الدافع، أم تنظيمية الدافع، القدرة الفائقة للعدوّ على كشف المنفّذ، واغتياله أو اعتقاله على الفور، أو بعد وقت قصير للغاية، كما أنّ السعي لتكوين خلايا سرّية متصلة تنظيميًّا كان ينتهي إلى الانكشاف السريع، كما في اغتيال العدوّ للشهيد أحمد زهران من بلدة بدّو في شماليّ غرب القدس وانكشاف التنظيم العسكري التابع لحركة حماس المتصل به والممتدّ في الضفّة الغربية كلّها، والعمليات الأخيرة التي نفّذها مقاتلون من كتائب القسّام ذراع حماس العسكري، كعملية مستوطنة "عيلي" التي نفّذها الشهيدان مهند شحادة وخالد صباح، وعملية مستوطنة "كدوميم" التي نفذها الشهيد أحمد ياسين غيظان، استشهد فيها المقاتلون أثناء تنفيذ العملية، بينما في عمليات أخرى للحركة نفسها مثل عملية الشهيدين حسن قطناني ومعاذ المصري في الأغوار، وبالرغم من تمكّن المقاتلين من العودة للاحتماء، فقد انكشفت هوياتهم وقت تنفيد العملية مما جعلهم مطاردين على الفور، ثمّ أصبح وصول العدوّ إليهما مسألة وقت في بيئة أمنية مساعدة للعدوّ بالكامل، وكذلك من قَبل عملية الشهيد عبد الفتاح خروشة في حوارة، والذي ينتمي كذلك لحماس، فقد تحوّل إلى مطارد على الفور، واستشهد بعد وقت قصير.
الاحتماء بالمخيم، ومحاولة تحويله إلى نقطة ارتكاز ليس جديدًا بالنسبة للتاريخ الكفاحي الفلسطيني قريب العهد، بما قد يتصل بذلك من علنيّة العمل العسكري، فقد اشتهر بذلك المستظلّون بعنوان كتائب شهداء الأقصى في الانتفاضة الثانية، وهو عنوان جامع لمسلّحي حركة فتح في تلك الانتفاضة دون أن يكون تنظيمًا مركزيًّا، ودون أن يعبّر عن إجماع داخل حركة فتح على هذا الخطّ من النضال، وامتدّ هذا النمط من العمل حينها في أكثر مناطق الضفّة، لا في شماليّها فحسب، وما تزال له تمثّلات إلى اليوم، من حيث علنية حمل السلاح، بغض النظّر عن موقع ذلك من ممارسة فعليّة لقتال العدوّ، بيد أنّ مخيّم جنين كان الحالة الأبرز حينها في نجاعة هذا العمل بالنسبة لعدد من الفصائل الفلسطينية، مما يمكّن من القول إنّ الظاهرة الراهنة له، والتي يعود الفضل الأكبر في تأسيسها لحركة الجهاد الإسلامي، غير منفكّة عن الذاكرة النضالية لأبناء المخيم، حتّى لو لم يشهد عناصرها بأنفسهم الانتفاضة الثانية. تنامي هذه الظاهرة في مخيم جنين شجّع على محاولة استنساخها في مواقع أخرى، كالبلدة القديمة في مدينة نابلس، وإن لم يكتب لها الاستمرارية بالقدر نفسه لأسباب اجتماعية وسياسية.
المخيم .. نقطة ارتكاز ممكنة؟
ساهمت الظاهرة الأخيرة بعلنيّتها، بالرغم من كلّ النقد الذي وجّه لطابعها الاستعراضي، في بلورة ظروف أفضل لثقافة المقاومة ونشرها في الأجيال الجديدة، وفي التغيير في مجريات الوقائع السياسية الجارية، وموازين القوى القائمة، كما كشفت عملية العدوّ الأخيرة على المخيم (3 تموز/ يوليو)، عن إرادة للمقاتلين لتحويل الحالة إلى أنماط أكثر نجاعةً وخفاءً وقدرةً على المناورة. إلا أنّ هذا الخيار من العمل المقاوم تواجهه جملة من العقبات الكبيرة.
يتمتع المقاتل داخل مخيم جنين، بالمعرفة الدقيقة بالمكان، ومسارب الحركة فيه، تقدّمًا وانكفاءً، وما يقدّمه ذلك من ظروف مناسبة للاختفاء ومرونة الحركة في الوضع الدفاعي، وهو ما يساعد المقاتل على تحقيق الشرط الابتدائي بالحفاظ على نفسه، ومن ثمّ على رأس المال البشري للمقاومة، وهو ما تمكّنت منه المقاومة في مخيم جنين في معركة (3 تموز)، إلا أنّ تحدّياتٍ تأسيسيةً تواجه الظاهرة، من جهة الفاعلية الهجومية للمتمركزين في المخيم، ومن جهة سلوك العدوّ.
إنّ الهدف الأوّل للمعتصمين في نقاط ارتكازهم، بعد اطمئنانهم إلى إنجازهم شروط الاحتماء، هو المبادءة بضرب العدوّ، وشنّ عمليات الاستنزاف المستمرّة عليه، (فلنتذكر ما قلناه سابقًا عن معضلات المقاومة في غزّة)، إلا أنّ الهندسة الاستعمارية المفروضة على الضفة، وأدوات الضبط والسيطرة المجترحة في أرضها، تجعل من هذه المهمّة صعبةً، وبقدر ما أنّ هذا تحليل ظاهري للواقع، فإنّ محدودية الهجمات الخارجية المنبثقة مباشرة عن التشكيل المسلّح في المخيّم، تعطي تأكيدًا فعليًّا على ذلك، وإن كان الاحتمال واردًا عن قصور في الرؤية بضرورة التحوّل نحو الاستثمار في رأس المال البشري للجسد المقاوم هذا في فعل أكثر نجاعة، فإنّ معيقات الهندسة الاستعمارية فاعلة كذلك بقدر مؤكّد.
أمّا من جهة سلوك العدوّ، فقد راهن على محدودية الحالة، وانعدام الإجماع الفلسطيني، ومن ثمّ المعيقات الذاتيّة لمدّها إلى الأمام، وعلى امتلاكه الوقت، وتفوّقه بالسلاح والتقنية والاستخبارات، فمضى في الإجراءات الموضعية (اقتحامات محدودة واغتيالات واعتقالات)، إلى أن تبيّن له أنّ الوقت لم يعد في صالحه، فشنّ حملته الأخيرة، على تردّد، فلا يظهر أنّه توفّر على رؤى متطابقة بخصوص الحملة في مستوياته كلّها الأمنية والعسكرية والسياسية، كما لم تكن يده مطلقة من رعاته الدوليين (الولايات المتحدة) في الوقت ومستوى القتل والتدمير، كما أنّ امتداد الحملة أكثر؛ من شأنه أن يخلخل البيئة السياسية والاجتماعية، وبالتحديد موقع السلطة الفلسطينية، في ظرف هشّ للغاية، ومن ثمّ فالمخاوف السياسية لخصوم المقاومة خدمت المقاومة في المخيم.
إلا أنّ الظرف السياسي قابل للتغيير، هنا يمكن أن نراجع كيف حسمت الجيوش النظامية حروب العصابات لصالحها، وذلك بغض النظر عن الأطراف المتقاتلة في تلك الحروب، فقد سوّى الأمريكان إبان حربهم في العراق مدينة الفلوجة بالأرض، وكذلك فعلوا تاليًا إلى جانب كلّ من قاتل تحت ظل طائراتهم ضدّ "تنظيم الدولة الإسلامية" في الموصل وغيرها من مدن العراق، ومن قبل حسمت روسيا حربها في الشيشان بتدمير غروزني، ولم تكن الأحداث في سوريا بعيدة عن هذه الصورة. ومن ثمّ فمحاولة التعويض بالمخيم وكثافته السكانية عن الجبال والغابات والمساحات الواسعة، تنطوي على عيوبها الذاتية من إمكانية تحويل البيئة نفسها إلى عبء على ذاتها وعلى المقاتلين، وقد دفع ذلك العدوّ من قبل لتطوير نظريات متعلّقة بهذه الحيثية، مثل "عقيدة الضاحية" في لبنان، و"كيّ الوعي" في الضفّة الغربية في الانتفاضة الثانية، و"تعزيز الردع" في قطاع غزّة. وعلى أيّة حال، فإنّ تدمير البيئة الحامية، حتى في الغابات، واحدة من إستراتيجيات الجيوش النظامية، كما حاولت بريطانيا في الريف الماليزي بواسطة المبيدات العشبية ومواد نزع ورق الشجر بهدف تدمير موارد الغذاء والأغطية الخضراء للجيش الوطني الماليزي، وكذلك فعلت الولايات المتحدة في الحرب الفتينامية، بالإضافة إلى استخدامها النابالم لحرق الثوار الفيتناميين في الغابات. بكلمة أخرى لن يقف العدوّ متفرّجًا إزاء أغطية المقاتلين، سواء كنت طبيعية أم عمرانية وبشرية.
في الحالة الجارية، ينضمّ إلى ما سبق تحدّيات أخرى، أهمها الظرف الفلسطيني الداخلي، المتسم بالانقسام متعدّد المستويات، وهو ما يسري بالسلب على أيّة حالة مقاومة، وما قد يأتي عليها بالنقض. وهو ما ينبغي أن يفتح المجال نحو أطروحات أكثر عمقًا وجدّيّةً تجاه حالة المقاومة، لاسيما من رعاتها المركزيين والمعنيين بها بالدرجة الأولى.

عناصر من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس في مخيم جنين
مقدّمة في البحث عن برنامج مقاوم
تكاثرت في السنوات الأخيرة المبادرات للخروج من الانسداد الفلسطيني الراهن، وصيغت تلك المبادرات في كتب ومقالات وأوراق وأبحاث، وأُعلنت في ندوات ومؤتمرات وورشات العمل، وأُسست لأجل ذلك تجمّعات متعدّدة، وهذا فضلاً عن لقاءات المصالحة، لكن ورقةً واحدةً، تقريبًا، لم تكتب لصياغة برنامج ممكن للمقاومة يلاحظ المعيقات القائمة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وذلك لأنّ التفكير الفلسطيني ظلّ منحشرًا في الواقعة السياسية التي لا تعيق العمل الثوري في الواقع فحسب، ولكنها تقيّد العقل الثوري كذلك، أي واقعة السياسة الفلسطينية الداخلية، من سلطة وانقسام، ولأنّ هذه الواقعة هي العقبة الثورية الأكبر، ولأنّ مشروع التسوية انتهى لا إلى فشل محتّم فحسب، بل إلى كارثة كبرى، فإنّه لا مناص من المقاومة بالرغم من كلّ ما سبق ذكره من عقبات منتصبة باستمرار في وجه أيّ خيار مقاوم في فلسطين.
لا ينبغي الانتظار بطبيعة الحال إلى حين توفّر الظروف المناسبة، فثمة تداخل بين نضج الظروف وبين المساهمة في إنضاجها، كما أنّ المشهد الفلسطيني يصير بالغ الخطورة لصالح العدوّ كلّما اتسم بالهدوء أو انطبع بالسياسات الاقتصادية للعدوّ الرامية إلي إعادة هندسة المجتمع وتسهيل التمدّد الاستعماري في الأرض وإلى الإقليم والعالم. إلا أنّه وبقدر أنّ الأمر لا يحتمل الانتظار فإنّه في الوقت نفسه لا يحتمل أن ترسم الوقائع نفسها المسارات للمقاومين.
لا يمكن تحديد الأهداف العملياتية، دون ذلك التأطير السياسي سابق الذكر، أي بتحديد وظيفة المقاومة في سياق مشروع التحرير، طالما أنّه يصعب في الأفق المنظور تحوّلها من ذاتها إلى حرب تحرير، وعلى ضوء ذلك تتضح مهماتها وأشكالها ومستوياتها، وهذا الأمر لا يمكن أن يُنجز إلا بتفاهم إستراتيجي بين قوى المقاومة الأساسية، وبالتعالي على الحسابات الضيقة كلّها، والتي كان لها (أي الحسابات الضيقة) تاريخيًّا دور فاعل في التدمير الداخلي لنضالات الفلسطينيين.
إنّ التأطير السياسي ينبغي أن تُأَسّس عليه سياسات التعاطي مع الظرف الداخلي الفلسطيني الراهن، بما يقلّص من مفاعيله السلبية قدر الإمكان، ثمّ ملاحظة نقاط الضعف الذاتية التي تخدم العدوّ في تفكيك مقاومة الفلسطينيين، فإذا كان الاحتماء بالمخيمات والمدن لا يعوِّض عن الظروف المطلوبة لحروب العصابات، فإنّ السعة البشرية للمقاومة هي التعويض الأهمّ، وهو ما لم يتوفّر داخل الأرض المحتلّة إلا في الانتفاضة الأولى، التي انتهت باتفاقية أوسلو، لا بقدرة العدوّ العسكرية والأمنية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعتها الشعبية في ضوء شروطها الموضوعية في حينه.
إنّ الوصول إلى السعة البشرية الكافية طريقه طويل، وأمامه عقبات اجتماعية واقتصادية وأمنية هائلة، كما أنّ السعي للوصول إليها لا يعني الاقتصار على ذلك، فالطريق إليها يحتاج تعبئةً معنويةً من الفعل المقاوم نفسه، كما يحتاج بنىً صلبةً قادرةً على التكيّف مع تفوّق العدوّ والتحايل على الظروف المناوئة، وهذا كلّه يحتاج قبل ذلك الرؤية والإرادة.
